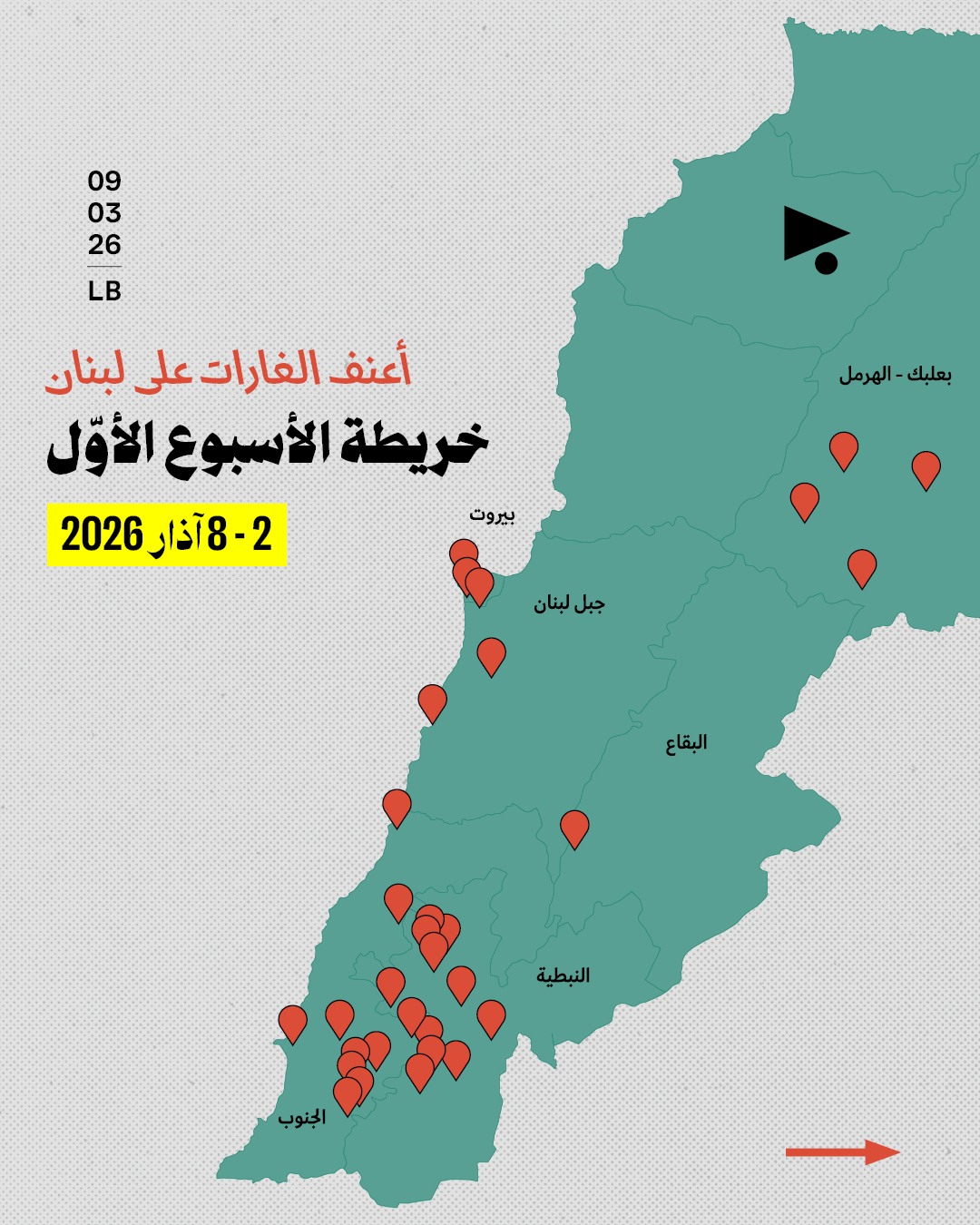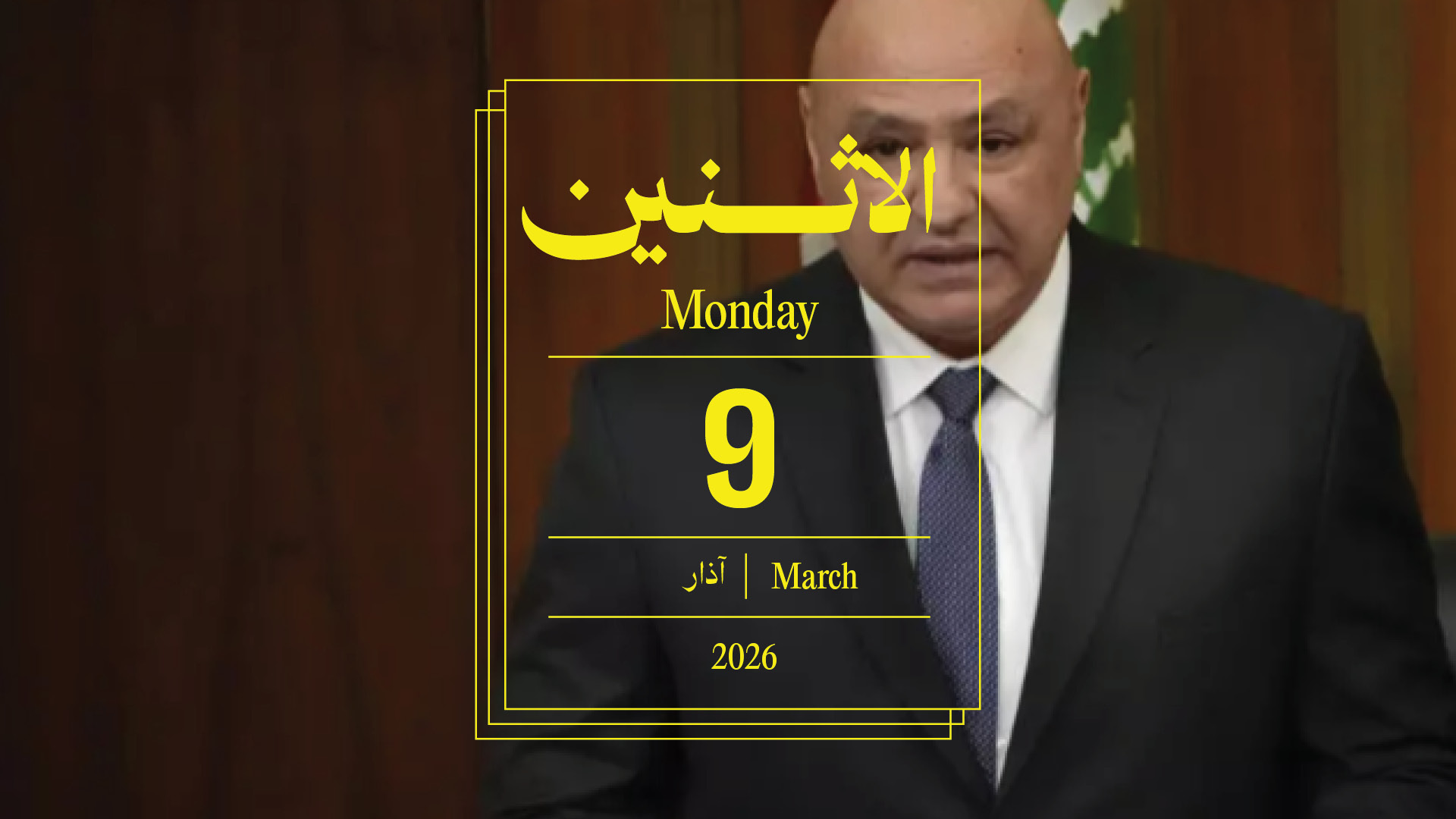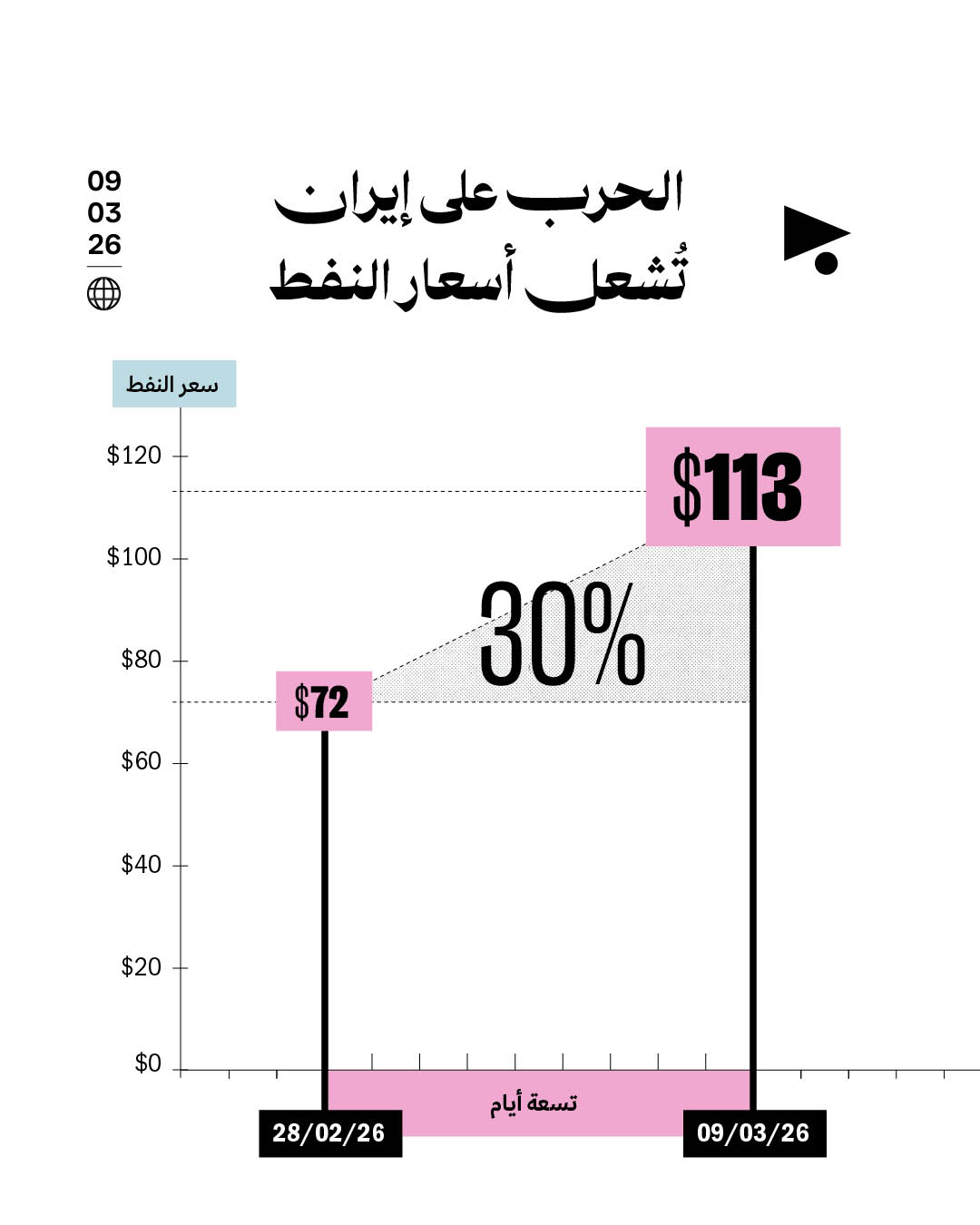التوسّع الترامبي
منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية أواخر العام 2024، رغم ما جرى بعد خسارته انتخابات العام 2020 التالية لولايته الأولى ورفضه النتائج واقتحام أنصاره مقر الكونغرس في كانون الثاني 2021، يهجس دونالد ترامب بالتوسّع الجغرافي وبما يسمّيه الاستحواذ على أراضٍ خارج أميركا.
سبق لترامب أن قال عن غزّة المُبادة إنه سيُخرج سكّانها لتتملّكها واشنطن وتعيد بناءها كريفييرا على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسّط. أمّا فنزويلا، فكرّر قبل خطف رئيسها وبعده أنه سيستولي على نفطها بحجّة أنها «سَرقت» في السنوات الماضية نفطاً أميركياً. كذلك ذكر أنّ إسقاط نظام كوبا سيجعلها «صديقة حميمة» لأميركا، وسيُعيد لحُكمها أميركيين من أصل كوبي، بعضهم ناشط في قاعدته الانتخابية في فلوريدا حيث قصره وإقامته، وبعضهم مقرّب شخصياً منه مثل وزير خارجيته ماركو روبيو. أضف إلى ذلك كندا التي ادّعى أن الفضل لوجودها يعود الى الولايات المتحدة التي من حقّها بالتالي أن تضمّها فتصبح الولاية الواحدة والخمسين، ناهيك بجزيرة غرينلاند العملاقة التي يريد «شراءها». في كلّ ذلك، عبّر ترامب في عام واحد عن عزمه على السطو على بلاد وعلى ثروات في بلادٍ أخرى على نحو مباشر وصريح وغير مسبوق في العلاقات الدولية منذ عقود طويلة.
وليس من باب الجهل الجغرافي فقط أنه استخدم «إيسلندا» بدل «غرينلاند» أربع مرّات في خطابه الأخير يوم الأربعاء الفائت في منتدى دافوس في سويسرا، ذلك أن أحد المقرّبين إليه بيلي لونغ سبق وأعلن أن إيسلندا ينبغي أن تكون الولاية الأميركية الثانية والخمسين (من دون أن يذكر من سيسبقها ضمّاً في هذه الحال، كندا أو غرينلاند). الأنكى أن ترامب عيّن مؤخّراً لونغ نفسه سفيراً إلى إيسلندا.
عقارات وموارد
على أنّ هذا الهجس بالتوسّع على حساب القانون الدولي وثقافة الدبلوماسية، وبمعزل عن المعاهدات التي وقّعت عليها أميركا خلال القرن الماضي، يُظهر في ما يتخطّى «ميغالومانية» الرئيس الأميركي أمرين أساسيين سنعيش معهما في السنوات الثلاث المقبلة، أي حتى نهاية ولايته.
الأمر الأول هو النزعة «العقارية» في السياسة. أي نزعة رجال العقارات الذي يطبّقون دفاتر شروطهم ومضارباتهم العقارية على علاقات الدول والكيانات السياسية. فترامب وافد إلى السياسة من العقارات، ومثله مستشاره ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره وموفده إلى روسيا وإسرائيل جاريد كوشنر، ومثله أيضاً صديقه وموفده الى تركيا وسوريا ولبنان توم براك. هؤلاء وغيرهم يقرأون العالم من منظار عقاري يرى في وضع اليد على الثروات لتمويل شراء العقارات وبناء الأبراج والمجمّعات والموانئ التجارية والمرافق السياحية ما يكفي لحلّ نزاعاتٍ وتبديل حدودٍ وبسط سطوة للأغنى والأقوى، ما يتيح للأضعف والأفقر فرص عمل ونجاة (لدى أسياده الجدد) في أحسن الأحوال...
أما الأمر الثاني، شديد الارتباط بكندا وإيسلندا وطبعاً بغرينلاند، فهو اكتشاف ترامب لما يوفّره القطب الشمالي والتمركز حوله من فرص حصول على موارد نفطية ومعدنية ضخمة وتموضع في المستقبل غير البعيد على طرق تجارة جديدة ونقلٍ للمواد الثمينة. فذوبان الثلوج في أطراف القطب الشمالي نتيجة الاحتباس الحراري والتبدّل المناخي سيُتيح قريباً البحث عما في أعماقه. وعبوره التجاري سيصير ممكناً، فتتزايد الاتفاقات والمعاهدات المتّصلة بمجاله الحيوي بين الدول المطلّة مباشرة عليه: روسيا وفنلندا والسويد والنروج وإيسلندا والدنمارك (عبر غرينلاند) وكندا والولايات المتحدة الأميركية (عبر ألاسكا). وروسيا وقّعت مؤخراً اتفاقات مع الصين تمكّن بكين من الاستفادة من ممرّ باتجاهه. وينبغي القول هنا إن حجم المساحة المطلّة على القطب يمنح أصحابها المزيد من «الحقوق» والنفوذ في التعامل معه. وهذا تحديداً ما يُريده ترامب الذي لا تعجبه محدودية التماس الألاسكي مقارنة بسعة التماس الروسي أو الكندي مع منطقة حيوية واعدة.
العودة إلى كولونيالية من دون قناع
لهذه الأسباب، يصرّ ترامب على السطو على غرينلاند، وتهديد كندا وإيسلندا، مكرّراً أنها جميعها أراض شاسعة مع أعداد سكان ضئيلة، وأنه جاهز لشراء غرينلاند، وما على سكانها وعلى الدنمارك (التي سبق أن سطت عليها العام 1721، وضمّتها الى المملكة العام 1814، ثم منحتها حكماً ذاتياً العام 1979 ووسّعت الحكم المذكور العام 2009) سوى الإذعان لذلك.
يعود ترامب بهذا المعنى الى الأخلاق الكولونيالية على نحو سافر، من دون تمويه أو بحث عن الهيمنة الاقتصادية والسياسية كما يجري في عالم «ما بعد الكولونيالية»، ويعود إلى القرن الثامن عشر مستغرباً عدم الموافقة اليوم، في العام 2026، على ما كان مسموحاً ومتاحاً وسائداً على مدى قرون، وحتى منتصف القرن الماضي.
والأرجح أننا لن نشهد في الفترة المقبلة تراجعاً ترامبياً، إلا في الشكل والتوقيت ربما، عن المقاربة هذه. ولن نشهد كذلك تراجعاً روسياً عن مقاربة مماثلة ولو مغلّفة بشعارات سياسية كتلك المستخدمة في أوكرانيا، والتي استُخدمت في السابق في جورجيا (من دون أن ننسى منطقة القوقاز، في ملابسات مختلفة). ولا شيء يمنع الصين غداً من ترجمة التلويح بالمقاربة إياها تجاه تايوان إلى أفعال، في عالم تحوّلت فيه جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة (أي الجريمة الأفظع في القانون الدولي، التي يندر ارتكابها) إلى حدث شبه تفصيلي في أوساط معظم النخب السياسية الحاكمة في «الغرب» و«الشرق» على حدّ سواء.