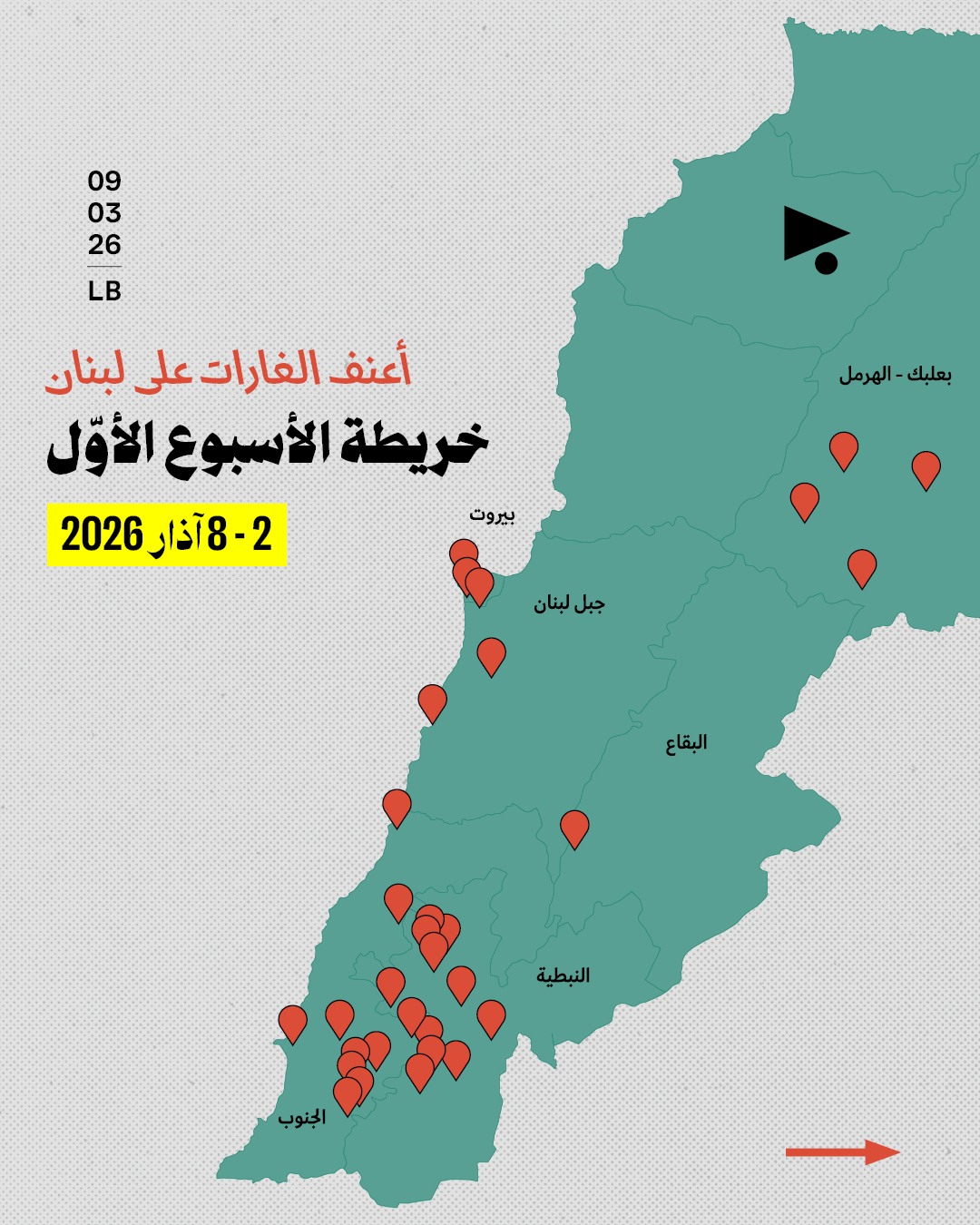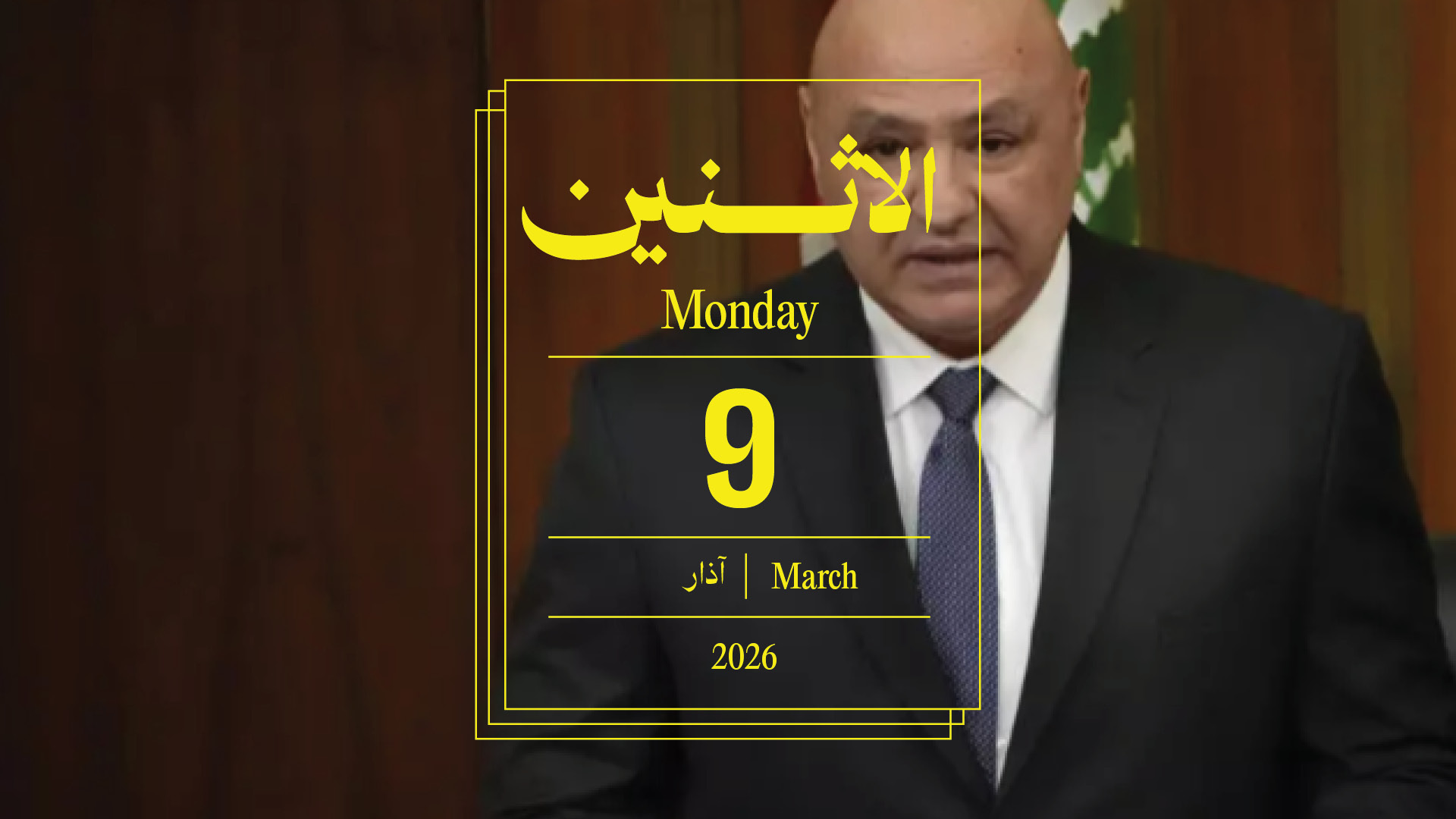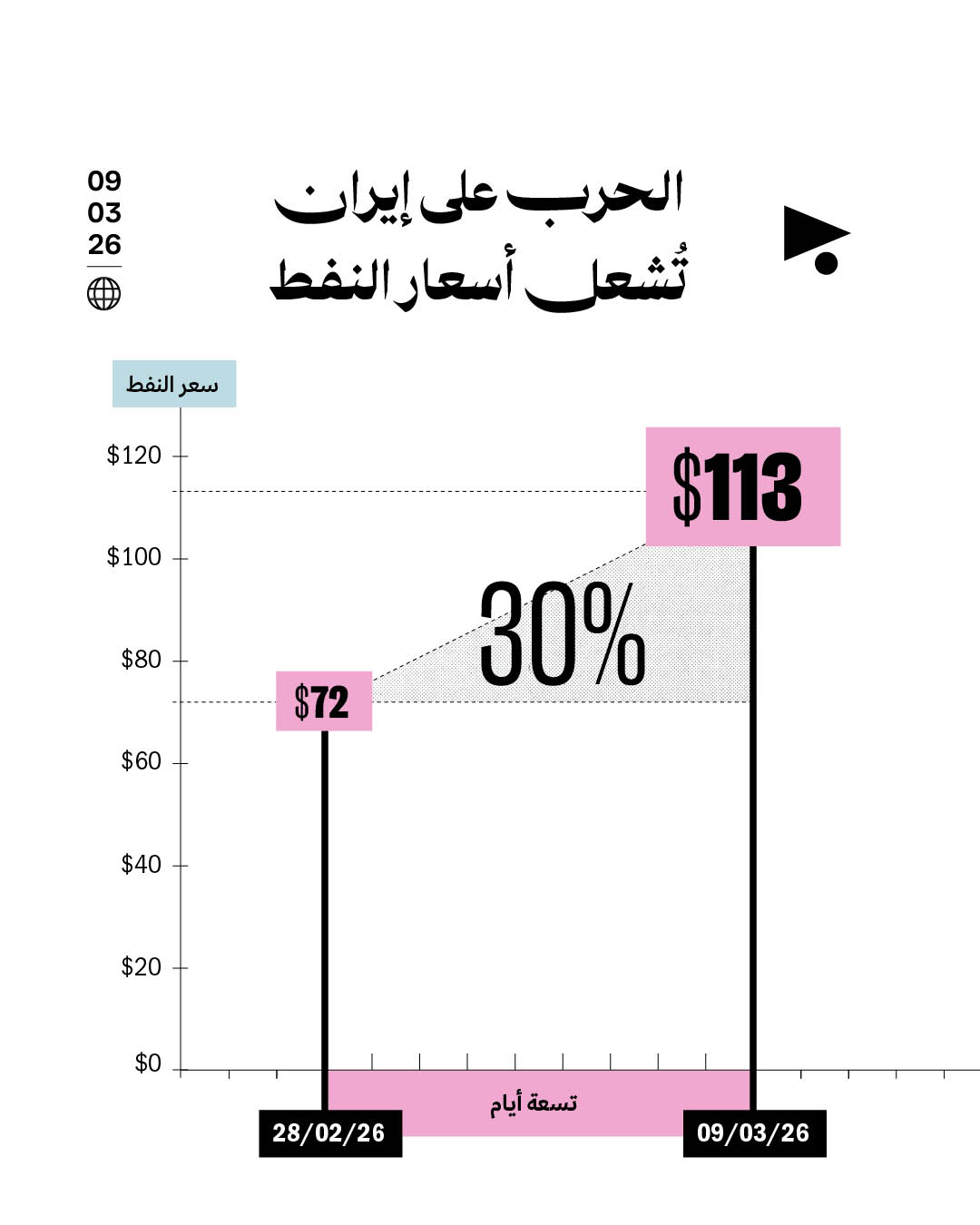الحكي
لا أودّ الحديث عن المواضيع العديدة التي تظهر عادةً في اللحظات الأولى بعد وفاة فنان مثل زياد الرحباني، وهو الذي ترك أثراً عميقاً في أجيال من اللبنانيين/ات. لا أودّ الحديث، بل أرغب في الاستماع إلى ما يقوله الناس ويعبّرون عنه، عن علاقتهم به وبموسيقاه ومسرحياته. وذلك لأن زياد عُرف وعاش من خلال أفواه الناس، سواء في الغناء أو في الحكي، أي في السمع.
نحن المستمعين/ات والمُصغين/ات، لطالما أدركنا أن زياد جمعنا بطرق شتّى على هذا المستوى. وما يتدفّق في وداعه الصعب هذا، وبأشكال عفوية ومؤثّرة، هو تقاطع ذكرياتنا كأطفال ومراهقين/ات وراشدين/ات للحظات الأولى– والمتكرّرة– حين سمعنا صوته وموسيقاه، تلك التي رسمت جغرافيا مرئية وسمعية لبلدٍ حدّد وكسر حدوده في آنٍ واحد. ففي ألبوماته، هناك تسجيلات عديدة ترتكز على الكلام المحكي والتعليق والضحك، كأنها تُذكّرنا دائماً بالحياة، أو تُكمل «مسرحية» ما بين المقاطع الموسيقية. كان يحكي فوق الحكي. وهكذا بدأ حضوره يتكوّن في ذهني: في المحكي الموسيقي.
حكي الآخرين
الصمت الحالي لبعض من أحبّوه يعبّر بدوره عن الكثير. فالاستماع إليه بات موجعاً.
لم يكن هذا الصمت موجوداً حين كنتُ مراهقة، حيث كان الناس (معظمهم رجال) يتسابقون في استعراض معرفتهم بموسيقاه ونواياه ومواقفه السياسية. الكلّ كان «خبيراً»، ولا أحد خبير. وكان حبّنا له أنانياً، كأنه حفر خطاً مباشراً مع كلّ من استمع إليه، مسبِّباً غصّة أو هتفة في القلب، ورسّخ وعياً سياسياً واجتماعياً.
علاقتي بموسيقاه طويلة، كعلاقتي بـ«الوطن»، أو كعلاقة صداقته بوالدي. لم نسترجع، أنا وعائلتي، موسيقاه عندما وجدنا أنفسنا، كلّ في بلد مختلف، عاجزين عن وداعه «كما يجب». كنّا على اتصال دام ساعات، نبكي ونضحك على ذكريات والديّ معه في سهراتهم ونشاطاتهم خلال الثمانينيات والتسعينيات.
في تلك الفترات، بدأت أستمع إلى صوته وأصوات الضيوف العالية خلف الأبواب المغلقة، وبدأت القصص والطُرف تتوالى، متقاطعةً مع اهتماماتي السياسية والاجتماعية الناشئة، مساهِمةً في تكوين شخصيّته خارج الذهن الجماعي.
وتعرّفتُ إلى أغانيه أولاً من خلال فم فيروز، من بوابة «كيفك إنتَ»، حيث غنّت كلمات زياد وألحانه بلعبتها المعهودة، في مقطوعة «بروفا (كيفك إنتَ)»، مردّدةً في الأغنية ما قالته له امرأة أخرى، أي حبّ آخر. وربّما كنتُ أعرف أغاني فيروز المشهورة، لكن لم يكن تأثيرها على خيالي الموسيقي كمثل «زياد من فم فيروز».
الصوت المباشر
لاحقاً، بات يحقّ لي أن أشارك في تلك السهرات، في أوائل الألفينيات، حين أصبحت قادرة على شرب الفودكا والسهر حتى الفجر. من الصوت الخفيّ إلى الصوت المباشر: صوت وصورة. خلف الضحك و«المَنْيكة» المعتادة، وجدتُ رجلاً رقيقاً، رغم وهج حضوره وعمري الصغير وخجلي. لا يزال هذا الانطباع راسخاً في ذاكرتي، ويزداد رسوخاً كلّما استمعتُ إلى موسيقاه. أسمع الحنان في نبرة صوته، مختبئاً خلف كلمات تهكمية أو قضايا اجتماعية. أليست موسيقاه مزيجاً من الشقاوة والرقّة؟
هناك الكثير ممّا أودّ قوله (وربما نقده)، لكن الآن، في هذه اللحظات، أرغب فقط في تذكّر حبّه لما سمّاه «الغابة»: سلطة من الزعتر والزيتون والبصل والسماق، أعدّتها له أمّي، والجبل الصغير من الملح في صحنه. أرغب في تذكّر لحظة استماعنا وغنائنا لـ«كيفك إنتَ» في السيارة في طريقنا إلى الشوف، متأمّلين مناظر ما بعد الحرب، وزيارتي كواليس مسرحية «لولا فسحة الأمل» في البيكاديللي وأنا في العاشرة، حين لم أفهم الكثير، لكن أذنيّ كانتا مرحّبتين ومتشرّبتين.
أجيال
رغم تلك اللقاءات القليلة، لا أعتقد أنني عرفته. بل شاركت بطريقة ما في قصة والديّ معه. أردت أن أصبح إناءً يحتوي ويُسكب منه قصص من ذلك الجيل. أسمع من كل الجهات، لكن لا أسيطر على أي شيء أو معلومة. تتحرّك القصص في ذهني: من أفواه والديّ، وأصدقائهم، والإعلام، والمعجبين/ات. قلتُ لنفسي إنني لن أنسى أي قصة تخصّه، لكنّ أسى السنين الأخيرة طغى على ما سبق. يجدر بي أن أتذكّر مع غيري، مع أمي وأبي وأصدقائهم، لإحياء بعضٍ منها.
خلال العام الماضي، أمضيت وقتاً طويلاً مع صديق نتحدث عن أهمية ألبوم «كيفك إنتَ»، ليس فقط لجيلنا، بل لوعينا الموسيقي. ومع صديق آخر (كلاهما موسيقيّ)، استمعنا إلى ألبوم «بما إنّو» بكامله، وناقشنا مدى تأثيره على مزاج التسعينيات. ربما تسلّلت تلك الأحاديث إلى هاتفي، فبدأت الخوارزميات تعرض لي مقتطفات من حفلاته في الأشهر التي تلت الحرب الأخيرة، أسمع فيها تضاريس حياتي وحياة من سبقني.
أظن أن لا أحد ينسى ذلك الوجع في القلب الذي تُسبّبه موسيقاه. لا أريد لذلك الوجع أن يهدأ، ولا أريد الراحة منه. وربما مع رحيله جاءت طبقة جديدة من الألم. خلف كل أغنية، سرديات فردية وجماعية مرسّخة في هذا البلد، ونسخ عديدة من نفسك لم يمت أيٌّ منها لأسباب طبيعية.
زياد ينتمي لمن أحبّه، ربما «متل ما حدا حبّ» شخصية لبنانية أخرى.