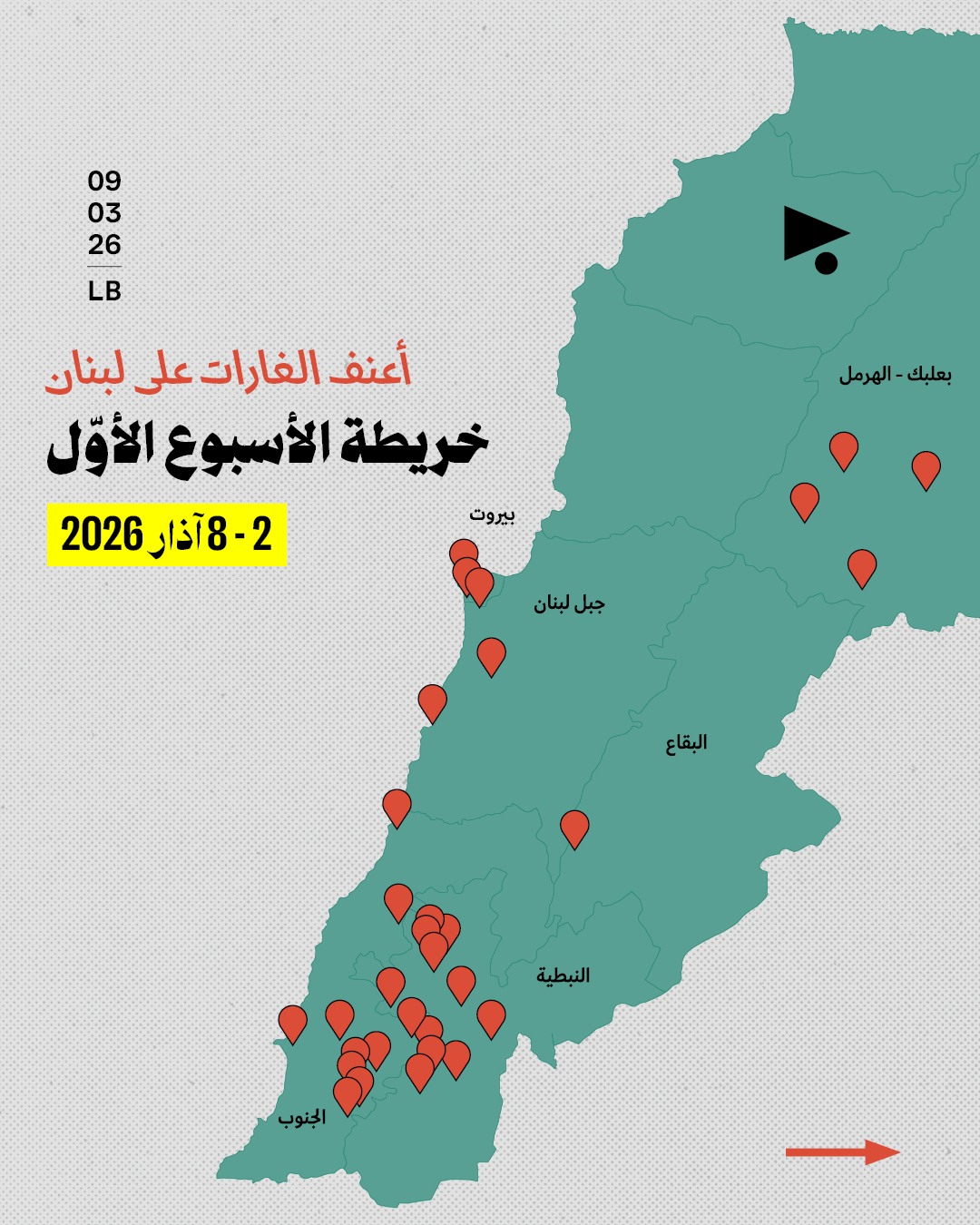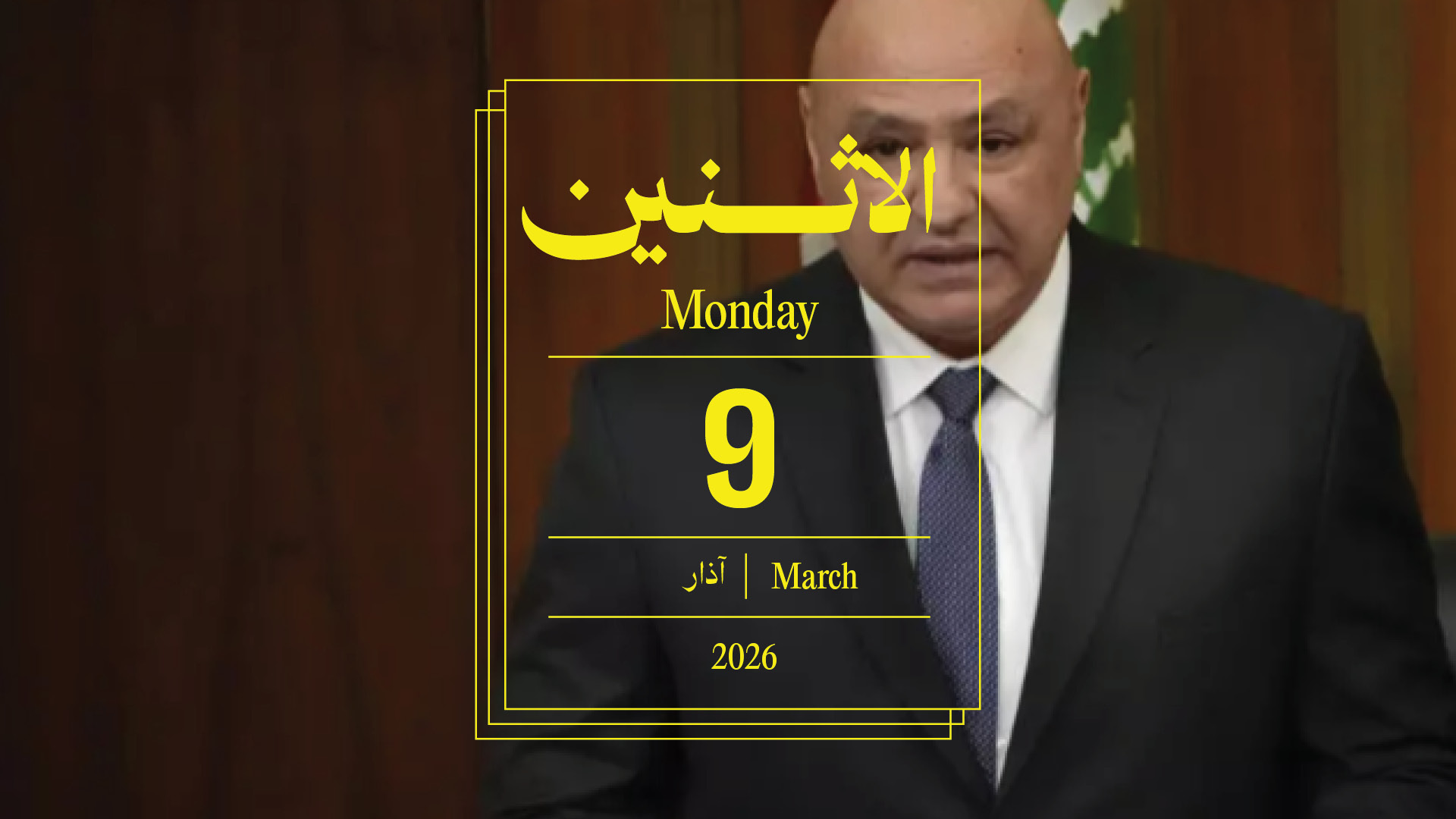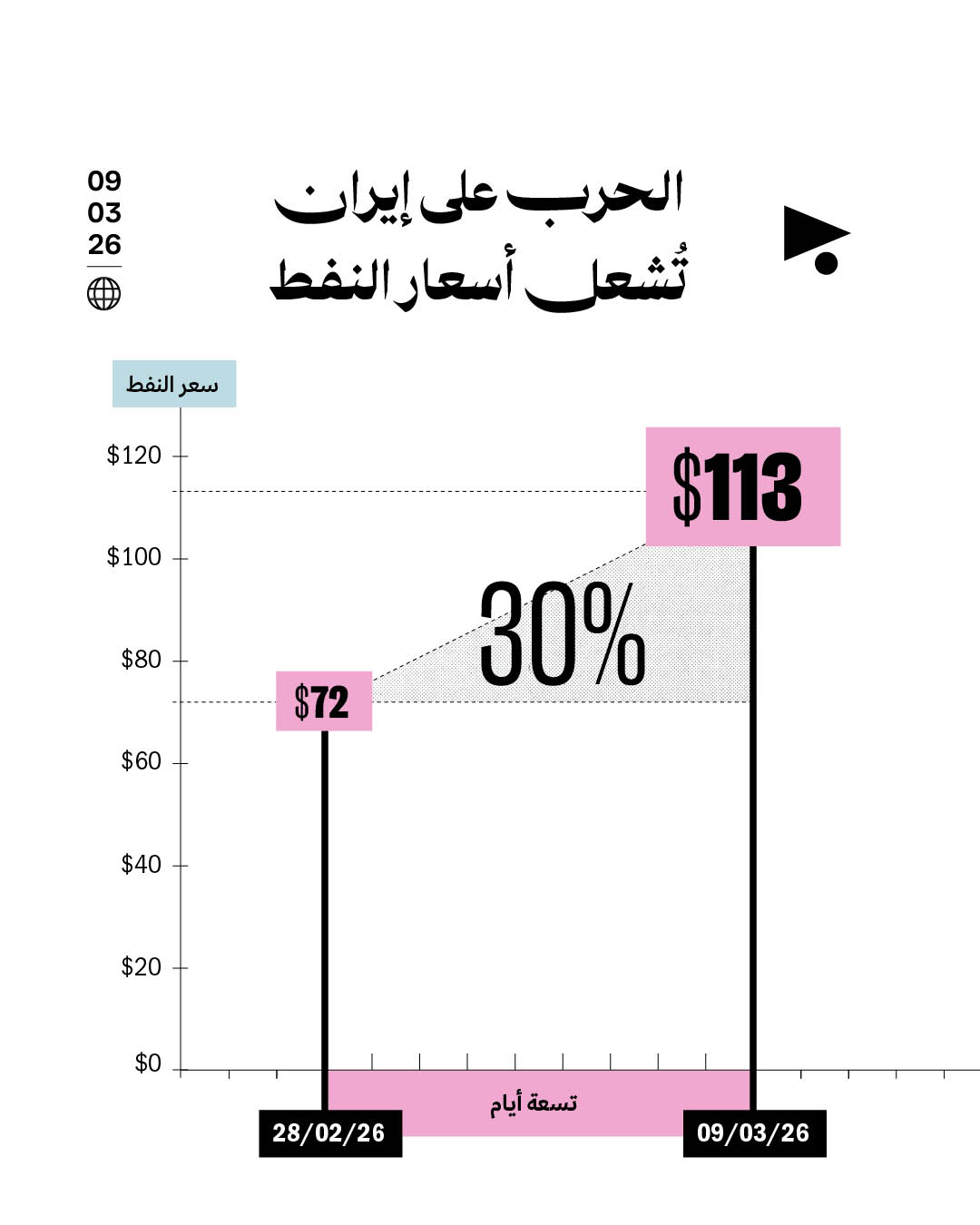مشى هذا الرجل في عقولنا لسنوات. لم نكن نتمنّى له سوى أن يمشي في طرقة منزله أو يجري في صالتها يحضن أمّه كما شاهدناه، وأن يتمشى في الشوارع مستحقاً للشمس والهواء، وأن يخرج من حصار الرمزية إلى براح التجربة. لم ندرك بعد كلّ بواطن آلامه مهما تصوّرناها، لم يشاركنا رحلتنا، هو الهالك، ونحن نظرياً الناجين، هو المعاقَب بحلمنا الجماعي وطيشنا وهوانا وهو العبرة التي أرادوها لنا، فصار شبحاً كما أراد هو.
لكنه، فجأة، ومع ظهور بعض رفاقنا القدامى، بدا لي كتقشّرات طبقات كثيرة. فرفعتُ الأغطية والوسائد وفتحتُ الشبابيك على ضجيج الشارع، لنعود معاً إلى مرحلة علاء ابن سيف وليلى قبل أن يصبح علاء عبد الفتاح الذين تشاهدونه الآن. علاء الذي نسمع صوته خافتاً في مظاهراتنا وقت تأسيس حركة «كفاية» ضد مبارك، الذي لا يهتف كثيراً، ولا يشاغب المخبرين، المشغول بالتبشير، يحمل ورقة، مطبوعة بالعرض، تضمّ عدداً من عناوين المدوّنات، يوزّعها على المتظاهرين، منهمكاً في الحوارات الفردية عن ضرورة الصحافة الجديدة.
تصوّرتُ لأسباب عبثية تماماً أنّ ما يجري أمامنا في صالة بيت ليلى هو قصّة مغايرة لما عشناه كلّ هذه السنوات. تجرّدت المعاني حتى صارت الوقائع أكثر وضوحاً، والقصّة التي رأيتها في هذه اللحظة، تشبه قصة داود المصري في رواية نجيب محفوظ «حديث الصباح والمساء»: وأمّا داود فقد اعتقله رجل الشرطة وساقوه إلى المجهول. وتحدث الناس بما رأوا، وعرفوا أن الوالي محمد علي يحمل أبناء الناس إلى ما وراء الأسوار ليُلقَّنوا علومًا جديدة، إنه يحبسُهم تحت الحراسة حتى لا يفرُّوا من التعليم.
إذن، خطف الوحش هذا الطفلَ من بيت أمّه بينما كان صغيراً، وعاد إليها وحده وهو كبير، لكنّ المفارقة أنه لم يجد أحداً في البيت يفتح له أو يستقبله، ذلك أنّ الأسرة كلها خارج المنزل، فاضطر للجلوس على السلم في انتظارهم، حتى ظهر أحد الأقارب وأبلغ الجميع. حضرت العائلة والجيران والمعارف لمشاهدة المعجزة الفريدة، لقد عاد كبيراً إلى أمّه التي لم تفقد الأمل يوماً بأنّه سيعود رغم يقين الجميع أنّه مفقود. نحن جيلٌ من المفقودين، والعائدون منّا قلّة تحتاج إلى معجزة مثل التي حدثت أمامنا طوال عشرة أشهر ماضية.
لقد عاد علاء كبيراً. لم يكن وحده بالطبع، رأيتُ شبابنا الأول، في ملابسه القديمة التي نعرفها ولم يستطع تغييرها منذ عقد من الزمن. لقد توقف الزمن في دولاب علاء لأكثر من عقد، وها هو يرتدي نظارةً لم يختَرْها غالباً، لكنها تشبه نظارة أبيه في السبعينات، ويتسابق مع نفسه ليحكي قصته قبل أن تنطفئ في عقله. كعادته، يحكي قصصاً مروّعة بسخرية لاذعة وضحكات متقطعة بين فصول القصة، مثل ليلى التي تتعثر في استكمال أيّ قصة ساخرة، لعدم قدرتها على وقف الضحك. يعود إلينا بحكايات متنوّعة تنتمي للكوميديا السوداء، عن زملائه في رحلة السجون التي لم تعد موجودة، لكنها السجون التي سبق أن أودِع والده أحمد سيف فيها في الثمانينات، هي نفسها التي عاش فيها علاء أسوأ فتراته في مجمع سجون طرة. كنت أريد أن أقطع قصّته لأُبلغه أنّ منطقة سجون طرّة التي كانت تطلّ على النيل، تمّ محوُها نهائياً، وصارت ركاماً وأرضَ فضاء، بعد أكثر من مائة عام على أقدم سجون العاصمة، كأنها لم تكن. عاد المطوِّر العقاريّ النافذ وشريك السلطة المقرَّب، ليردّ الجميل للسجن الذي قضى فيه عقوبته بتهمة قتل مطربة شهيرة، ويحوّله كمباوند سكنياً ومناطق ترفيهية، وهو الحاصل على عفو رئاسي صحي، مثل علاء.
وكما عاد داود المصري، في الليل، عاد علاء. لا يريد الوالي أن تراه عيون الناس وهو عائد، لأنّهم بالضرورة سيتذكرون عملية الخطف التي استمرت سنوات، ويتعجبون من تعاقب الزمن على الشاب، والظلمات التي خاضها ليصل إلى بيت أمه. بل أصرّ رجال الوالي على أن يرتدي ملابس لا تشبهه، ربما من أفخم الأنواع، حتى بدا لنا علاء متنكِّراً لدرجة أننا، وللوهلة الأولى، لم نعرفه، وهذا هو المطلوب، حتى دخل بيته وأخرج من دولابه هذا التيشرت الأصفر الباهت الجميل الذي نعرفه جيداً.
رفض رجال الوالي أن تستقبل الأمّ العنيدة ولدها، كأنها الرسالة الأخيرة. ولكنّ ما جرى بالفعل كان العكس، وكان رائعاً وعادلاً أن يستقبل الابنُ أمَّه في المنزل مع الأهل والأحبّاء بعد رحلتها المريرة من أجله. جلست بجوار السجن مع فردَيْن من العائلة، بينما تجمّعنا نحن أصدقاءه ورفاقه وعدداً كبيراً من الصحافيين المحليين والدوليين، في بنزينة على بعد كيلومترات من مقرّ السجن الكائن في منتصف طريق القاهرة- اسكندرية الصحراوي، وعلى بعد 100 كيلو من العاصمة. ووفقاً لخطة الإنهاك المعروفة، تأخّر خروج علاء رغم الإعلان المبكر عن قرار العفو الرئاسي. رحل الصحافيّون وصمدت الأمّ وشقيقته والأحبّاء والأصدقاء لمنتصف الليل، قبل أن يخبرنا اتصال هاتفي من بيت العائلة أنّ علاء وصل المنزل واستقبله الجيران بحفاوةٍ ودهشة، وقد تجاوز الوقت منتصف الليل، ولم يجد من يفتح له باب بيته. عدنا جميعا على الطريق الصحراوي الخاوي، نحاول الوصول له غيرَ مصدّقين، نضحك من عبثية طريقة الخروج، وإخراج المشهد بهذه الرداءة.
تتابعت سياراتنا وصولاً لبيت ليلى، وفزنا بلقائه في أجواء هادئة. استطاع أن يعلق لكل فرد على حاله، ويحتضن الأصدقاء والصديقات لفترة من الوقت، بينما كانت السيارة التي تضمّ ليلى سويف هي السيارة الأخيرة التي وصلت البيت. وكلما دق الباب، توقّع علاء أن تكون أمّه، حتى سألنا مراراً وهو يضحك: ودّيتوا أمّي فين يا عيال؟
تأخّرت ليلى، وكانت الصحافة والمصوّرون يسابقون الزمن في الوصول إلى البيت، والكلّ يسأل: هل حدث اللقاء بينه وبين ليلى؟ ثمّ امتلأ البيت بالكاميرات والأصدقاء، حتى طرقت ليلى الباب وكان علاء في انتظارها مع شقيقته سناء والأصدقاء والرفاق، لتبدو اللحظة سعيدة وعادلة وموحية، رغم إصرارهم أن لا تكون كذلك. كان علاء وكنّا نحن جميعاً في استقبال السيدة التي دفعت الثمن مقدّماً، للفوز بهذه اللحظة التي بدت مستحيلة.