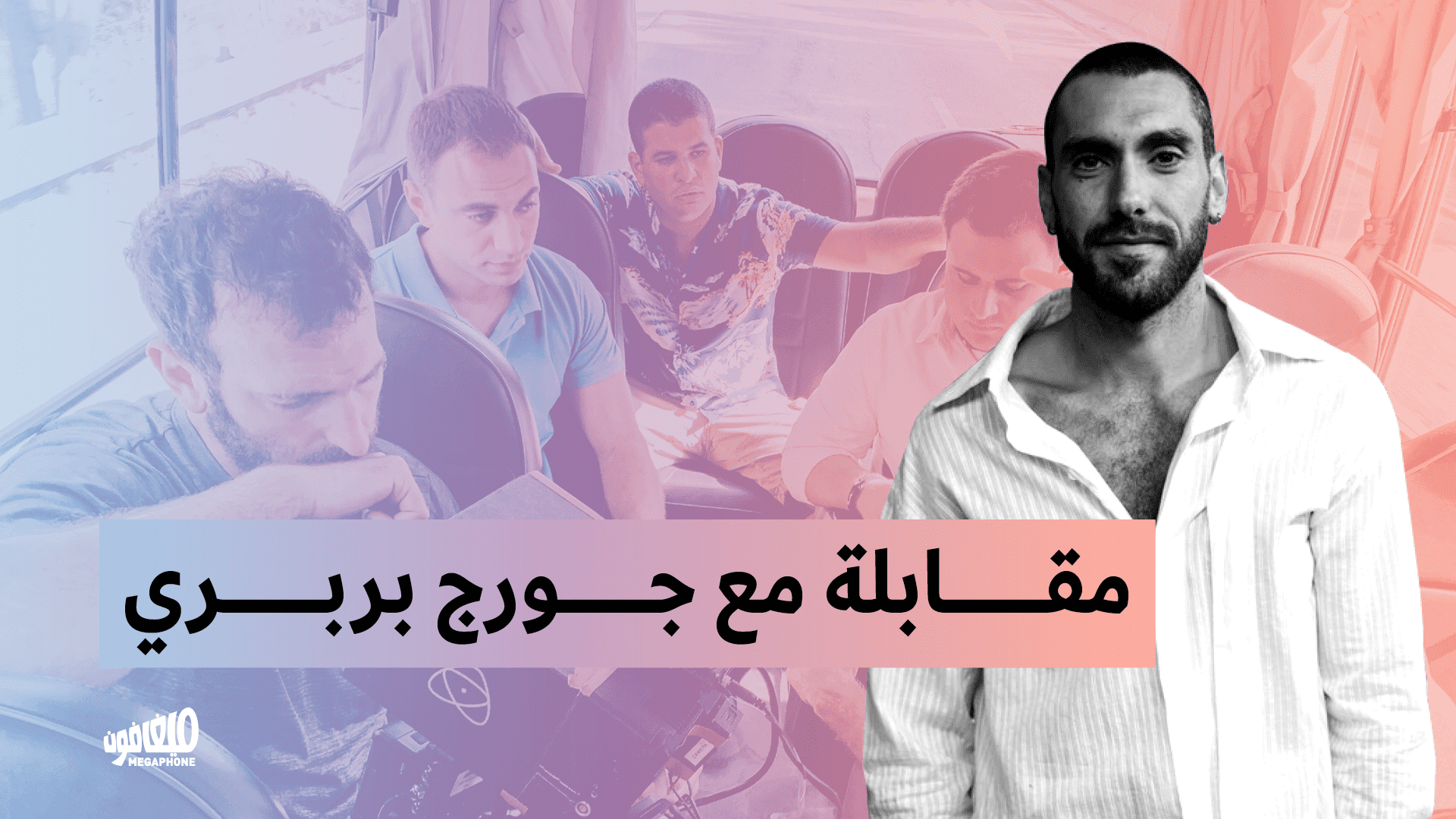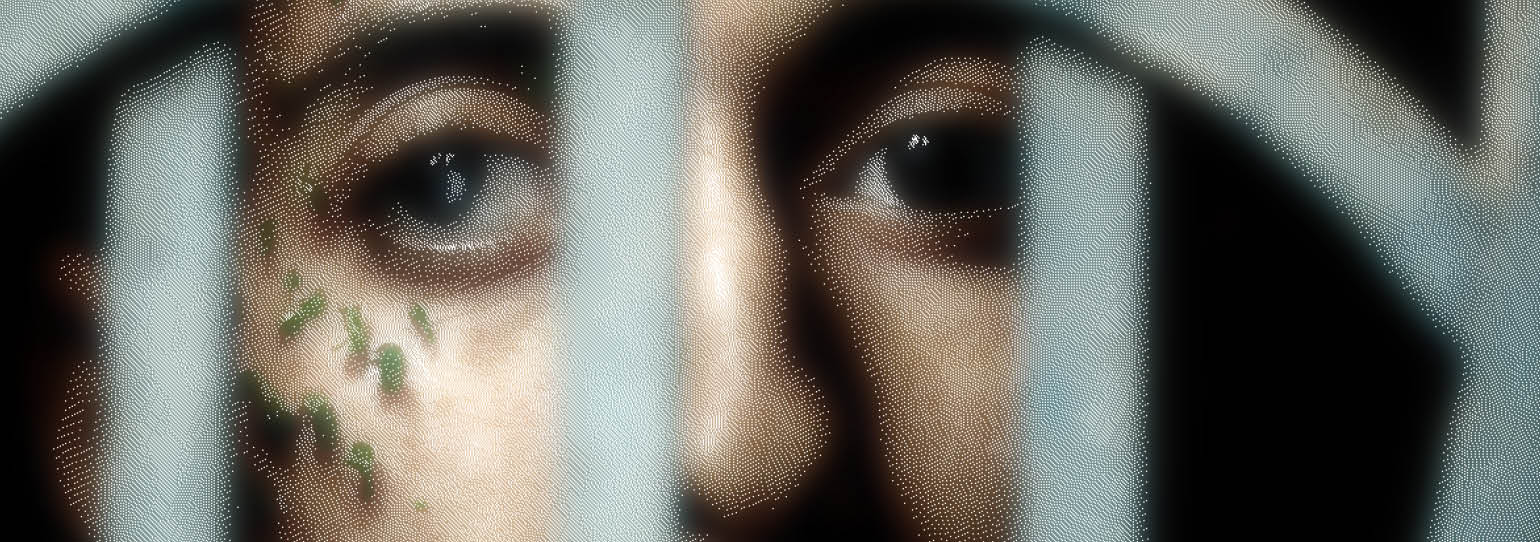
إنّها مدينةٌ شبه مهجورة، ولكن مَن بقيَ فيها عرضة للملاحقة من قبل «شرطة الظلال»، والذكريات. «معطّراً بالنعناع»، فيلمٌ للمخرج المصري محمد حمدي؛ وقد خطر لسمير سكيني أن يكتب هذا النص، ليس من باب «مراجعة» الفيلم، بل بمحاولةٍ لالتقاط شعور راوده خلال المشاهدة.
جاءَ طوفانُ نوحْ
ها همُ الجُبناءُ يفرّون نحو السَّفينهْ.
بينما كُنتُ…
وكانَ شبابُ المدينةْ
يلجمونَ جوادَ المياه الجَمُوحْ
تأكلُني في الآونة الأخيرة فكرةٌ مفادها أنّيَ الآن لا أحيا حياتي بذاتها، بل ذكرى ما انقضى منها. وبالتالي، كأنّيَ الآن لا أعيش، بل أنشغل بصناعة الذكرى التي سوف أعود إليها بعد حين. أجدُني فجأةً أتذكّر ما كنتُ عليه، من دون أن أتمكّن بالفعل من التقاط ما أنا عليه الآن وهنا.
وإنّي أحسد من يستطيع أن يحيا حياته بمعزلٍ عن هذه الفكرة— علماً ألّا عيبَ فيها. بل العكس، فيها ما يلفت النظر وما يُغري. فالتأرجح بين اللحظتَين (أي، أن تحيا الذكرى في لحظةٍ ما ثمّ تنتبه في لحظةٍ أخرى إلى أنّك «تصنع» ذكرى أخرى سوف تعود لتحياها ثم تنتبه إلى أنّك… الخ)— التأرجح بين هاتين اللحظتَين، يخلق «فجوةً» ما، تستحقّ أن تُستَكشَف بذاتها بمعزلٍ عن اللحظتَين المذكورتَين. وقد التفتُّ إلى هذه الفجوة– أو بالأحرى استطعتُ أن أجد شكلاً لها– عند مشاهدة فيلم «معطَّراً بالنعناع» للمخرج المصري محمد حمدي.
يقول تعريف الفيلم إنّ «بهاء طبيب حزين يحاول مع صديقه مهدي التخلّص من أشباح الماضي. يهربان من منزلٍ مهجور إلى آخر، لكنّ ظلالاً تلاحقهما من دون كلل». ينبتُ النعناع في أجساد القلّة التي بقيَت هنا، ما يبعثُ برائحةٍ تكشف مكانهم. وبذلك تستطيع الظلال أن تعثر عليهم. للتحايل على الموضوع، ينبغي ألّا يتوقّف المعنيّون عن تدخين الحشيش، فيَطردون عطر النعناع تسهيلاً لعمليّة التخفّي: النعناع بيهداش إلّا بالحشيش.

جاء طوفانُ نوحْ
المدينةُ تغْرقُ شيئاً…
فشيئاً
مشهد الفيلم الافتتاحي: حقولُ نعناعٍ تُحرَق. ثم يُلحَق بشكوى افتتاحية تحدّد مزاج الفيلم: ابني مش راضي يموت؛ والآن يَسحب الدكتور الحزين رسالةً مبلولةً، ويخبرنا أنّها ستبقى مبلولة إلى الأبد؛ ثم يظهر صديقه وقد «نَبَّت»… لا نفهم حقّاً ماذا يدور هنا. من الدقائق الأولى نشعر أنّنا أمام أحاجٍ، وسرعان ما نكتشف أنَّ عالمَ الفيلم مُثقَلٌ بالرموز— ربّما إلى درجةٍ رتيبة. وهذا هو النقد البديهي للفيلم.
أن أكتب الآن عن هذه الرموز، سيضع القارئ الذي لم يشاهد الفيلم أمام حيرةٍ مُضاعَفة. من جهة أخرى، سيكون من الصعب الكلام عن الفيلم من دون التوقّف عند رموزه وشرحها، وستصبح مهمّة الناقد إذًا توضيح أنَّ النعناعَ يرمز إلى كذا، والرسالة المبلولة هي كذا، وأنّ حمدي من جيل كذا، الخ…
وعليه، أودّ تجاوز كل ذلك لأقترح القراءة التالية: إن كان المخرج قد اعتمد على الرموز إلى هذا الحدّ، فهذا لا يعني أنّه يطلب منّا تفكيكها؛ بل إنّه يدعونا إلى دخولِ عالمٍ جديد، حيث لا تُحيل الرموز إلى عناصر مستوحاة من عالمنا الحاليّ، بل تُكَوّن عناصرَ قائمةً بذاتها ضمن فضاءٍ آخر وأودّ أن أعتبره «فضاءً مضادّاً». من باب التفلسف: فيلم «معطّراً بالنعناع» فضاء مضادّ بالمعنى الفوكويّ: «هيتيروتوبيا». راجع: Des espaces autres: Hétérotopies— Foucault, Michel (1967). نفرّ إلَيه.
ها همُ «الحكماءُ» يفرّونَ نحوَ السَّفينهْ
المغَنّونَ / سائس خيل الأمير / المرابونَ / قاضي القضاةِ
حاملُ السيف / راقصةُ المعبدِ
جباةُ الضرائب / مستوردو شَحناتِ السّلاحِ
السيّدة التي دفنت ابنها، ثم دفنته من جديد، ثم دفنته مرّةً ثالثة / جابي الكهرباء الذي ينتظر اسمه في قرعة الشركة حتّى يربح شقّةً فيتزوّج / راكبُ الباص الذي يحمل صورًا لابنه ويوزّعها على الركّاب / حسين المقاوم المنسيّ الذي ينتظر ظهور «الحاج» / شقيقة «علي-عديم-الوجه» التي تُكرّر زياراتها إلى مؤسّسات الدولة أملاً بتعويضٍ عادل…
هؤلاء هم سكّان عالم حمدي. ومن السهل ملاحظة أنّ لكلٍّ منهم قصّةً تدور بحسب منطقٍ سيزيفيّ؛ حتّى أنّ الفيلم بمجمله يدور وفق هذا المنطق. فالشخصيَّتَان الرئيسيَّتان، بهاء ومهدي، يصرفان وقتهما بالبحث عن حشيشٍ جديد لإخفاء رائحة النعناع بينما يدخّنان آخر ما عثرا عليه من حشيش، بما يشبه دوّامةً بلا نهاية، ما يُحيل إلى سيزيف وصخرته— أو بالأحرى سيزيف وطحبوشه (سوى أنّه يصعب علينا هذه المرّة أن نتخيّله سعيداً).
هؤلاء هم سكّان عالم حمدي، عالم الصعاليك. عالمٌ مهجورٌ ليس فيه بشر. المهمّشون فقط. البُسطاء. المُراوحون في العتمة (وهذا ما تبرزه بصريّات الفيلم). هناك تدور الحياة بالنسبة للمخرج. في العالم السفلي. بين العمارات المتداعية والأنقاض. الغرف القذرة، الأثاث الرثّ، الباص الذي لن يمشي، الأزقّة المُطبَقة،
الحوانيت، مَبْنى البريدِ، البنوك
التماثيل، المعابد،
أجْوِلة القَمْح، مستشفيات الولادة
بوابة السِّجنِ، دار الولاية
أروِقة الثّكناتِ الحَصينهْ
هكذا يمضي حمدي في بناء مدينته الموازية.
ومع اعتبار أنّ تلك الرموز لا تدلّ على شيءٍ من عالمنا، بل تقوم بذاتها، تكون هذه المدينة (الموازية) مدينةً قائمةً بذاتها. ولهذا السبب يبدو الفيلم متّسقاً للغاية، رغم أنّ كلَّ عنصرٍ من عناصره– إن أُخذَ على حدة– غير متّسق بتاتاً. لهذه المدينة عمرانها الخاص ومنطقها الخاص، لها وقتها وفضاؤها، لها نورها وظلّها… حتّى أنَّ لها ناسها الذين ليسوا نحن رغم الشبه الكبير. ففي لحظةٍ من التوتّر المحموم بين «البطلَين»، يستدير بهاء باتّجاه مهدي ويعاتبه: اهدا علَيَّ يا مهدي، أحسن ما تكون فاكرنا بني آدمين؟
وهنا تكمن براعة حمدي. أعتقد أنّ مهارة الكاتب أو المخرج أو المنتج الفنّي… تتجلّى تحديداً في اللحظة التي يغدو فيها معمارياً— أو بالأحرى، منظِّماً مُدنياً: عندما يُنتج مدينته. (أُغامر بأن أكرّر نفسي، ولكن) لا يمكن غضّ النظر عن مرجعٍ مؤسّسٍ في هذا النمط من الفكشن: كتاب «المدن اللامرئية» للكاتب الإيطالي إيتالو كالفينو. التماثلُ فاقعٌ بين مدينة «معطّراً بالنعناع»، ومدن كالفينو.
خلفيّة الكتاب بسيطة: يُروى أنّ الإمبراطور قوبلاي خان قد وسّع مملكة المغول إلى درجةٍ عجز فيها عن أن يرى بنفسه كل الأراضي التي صار يحكمها. فما كان منه إلّا أن بعث بالرحّالة ماركو بولو لاستكشاف هذه الأراضي، على أن يعود مع تقريرٍ عن مشاهداته. في العام 1972، صنع كالفينو من هذا التقرير رواية.
تفرُّ العصافيرُ،
والماءُ يعلو.
على دَرَجاتِ البيوتِ
… ويطفو الإوزّ على الماء
المثير للاهتمام أنّ الرحّالة جلس يسرد قصصاً عن مدنٍ لا يعلم الملك إن كانت حقيقيّةً أو من نسج الخيال، كما لا يعلم الرحّالة إن كان الملك يصدّقه حقّاً أو أنّه مستمتعٌ بالسرد فحسب. وهذا هو الشعور الذي خالجني أمام الفيلم. للحظةٍ شكّكتُ بنفسي: هل ما أراه على الشاشة قد حصل بالفعل في مدينةٍ ما، ذهب حمدي واستكشفها وعاد إلينا بقصّةٍ عنها؟ لن أعرف أبداً، ولكنّي مستمتعٌ بالسرد.
للمفارقة، يرتّب كالفينو مدنه وفق عددٍ من الثيمات أوّلها وأبرزها: «المدن والذاكرة»، ثم «المدن والرغبات»، و«المدن والرموز»… أمام هذا التقاطع بين العملَين، تهيَّأ لي أنّ حمدي على صلةٍ بماركو بولو في نهاية المطاف، أليس السينمائي نوعاً من الرحّالة؟ ، وقد رافقه في إحدى الزيارات إلى مضافة قوبلاي خان، حيث قصّ عليه وقائع مدينته، وقدّم له نعناعاً قطفه من هناك، وراح الملك يمضغ ذكرياتٍ ليست له.
صاحَ بي سيدُ الفُلكِ قبل حُلولِ
السَّكينهْ:
«انجِ من بلدٍ... لمْ تعدْ فيهِ روحْ!»
في مشهدٍ بديعٍ، ليلاً، يجلس بهاء ومهدي على ناصية طريقٍ للاستراحة. يمرّ عليهما رجلٌ مسنّ ليستريح بجانبهما. يفتح حديثاً مع مهدي، ويعرض عليه «ذكرياته». يقطف الرجل ورقةَ نعناع من رقبته ويقدّمها لمهدي الذي يلوكها، قبل أن يشرد ويُجيب: نعم… ذكرياتك… فيقطف بدوره ورقةَ نعناعٍ من نفسه: طب ذكرياتي… ويقدّمها للرجل الذي يلوكها ثم يشرد. وتتكرّر عملية «تبادل الذكريات» ليُبدي الرجلان، بعد كلِّ تبادلٍ، حسرةً على الذكرى التي مضغاها للتو: طب فاكر دي؟
- ممم… بس انت نسيت دي
- … وأنا أقدَر؟

بعد حين، يعرض المسنُّ ورقةَ نعناعٍ أخيرة على مهدي، محذّراً: خد بالك من دي. يتردّد مهدي. لا يلبث أن يضع الورقة في فمه حتّى يبصقها: صعبة دي…
- تَعَّبتني أوي يا مهدي
- الله يعوّض عليك يا سيدنا…
وفي تلك اللحظة بالذات صدّت حنجرتي غصّةٌ لئيمة. انتبهتُ إلى ورقة النعناع العالقة في زلعومي، وأدركتُ حاجتي إلى أن أبصقها الآن. لقد تطلّب الأمرُ مشهداً على هذا القدر من الخفّة، كي أفهم ثقل الذكريات. كانت المقاعد مزدحمة والكلّ ينظر باتّجاه الشاشة وأنا أبحث عن مكانٍ مناسبٍ لأبصق النعناع من فمي. وسرعان ما اكتشفتُ أنّ النعناع أخذَ ينبت من جسدي أيضاً. من شعري. بلا انتباهي. رحتُ أبحث عن شرطة الظلال في القاعة التي أخذَت تضيق شيئاً فشيئاً. حاولتُ أن أختبئ أسفل المقعد. وحاولت أن أقتلع من الأوراق ما استطعت، من دون إثارة ريبة الآخرين. وكان الدكتور أمامي. شارداً في البعيد. وكانت في جيبه الرسالة المبلولة إيّاها. وتذكّرتُ، علاوةً على كلّ شيء، أنّني لم أبلّل نفسي طيلة السنتَين الأخيرتَين. وأنّ الدمعَ، إن حُبسَ كثيراً، أصبَح وردةً من عَطَن.
كان قلبي الذي نَسجتْه الجروحْ
كان قَلبي الذي لَعنتْه الشُّروحْ
يرقدُ الآن فوقَ بقايا المدينه
… هادئاً
بعد أن قالَ «لا» للسفينهْ
في الآونة الأخيرة، بتُّ أُلاحظ فشلي المتزايد في ترتيب الأحداث وفق خطّها الزمني. كأنّ الذكريات في جمجمتي قد خرجت عن ترتيبها الأوّل، وكأنّي أتأرجح ما بينها. ربّما بسبب كثرة الأحداث. ربّما الملل. ربّما عطلٌ تقنيّ لا أكثر. ربّما هذا هو العاديّ بين الأمور. ثم… ماذا يفعل المرءُ بعد أن يمضي حياته في التأرجح على ذكرى؟
للحظة، كدتُ أنسى أنّ الذاكرة ليست، في نهاية المطاف، سوى مخيّلة كسولة. الذاكرة مخيّلة كسولة. وإنَّ كلّ ما نحتاج إليه هو تحريكها بين الحين والآخر. هنا تكمن «الفجوة» التي تستحقّ أن تُستكشَف.
إنّه فيلمٌ مثقلٌ بالرموز التي تُحيل، في عالمنا، إلى الذاكرة. ولكن دعونا نتجاوز ذلك: إن كانت رموز الفيلم تُحيل إلى سؤال الذاكرة بالنسبة لعالمنا، فإنّها بالحقيقة، وبالنسبة لعالم حمدي، تفتح سؤال المخيّلة. وبكلماته: «الخيال الخام». حسناً… ربّما كان الفيلم من عالم الفكشن، لكنّه جعلني أقرب إلى الواقع.

في مشهدٍ سيزيفيٍّ آخر، يقف بهاء ومهدي أمام «علي-عديم-الوجه»، حزينَين على مصيره. ولكنّه مع ذلك، يحاول أن يبثّ فيهما شيئاً من الأمل. يحثّهما على مصارحة الذاكرة رغم كلّ شيء. يا راجل؟ نسيت؟! ويُعيدهما إلى مقابلةٍ خاصّة أجروها مع ابن نوح:
جاء طوفانُ نوحْ!
المدينةُ تغْرقُ شيئاً.. فشيئاً
تفرُّ العصافيرُ،
والماءُ يعلو.
على دَرَجاتِ البيوتِ
الحوانيتِ
مَبْنى البريدِ
البنوكِ
التماثيل (أجدادِنا الخالدين)
المعابد
أجْوِلةِ القَمْح
مستشفياتِ الولادةِ
بوابةِ السِّجنِ
دارِ الولايةِ
أروقةِ الثّكناتِ الحَصينهْ.
العصافيرُ تجلو..
رويداً..
رويدا..
ويطفو الإوز على الماء،
يطفو الأثاثُ..
ولُعبةُ طفل..
وشَهقةُ أمٍّ حَزينه
الصَّبايا يُلوّحن فوقَ السُطوحْ!
جاءَ طوفانُ نوحْ.
هاهمُ «الحكماءُ» يفرّونَ نحوَ السَّفينهْ
المغنونَ، سائس خيل الأمير، المرابونَ، قاضي القضاةِ
(.. ومملوكُهُ!)
حاملُ السيف، راقصةُ المعبدِ
(ابتهجَت عندما انتشلتْ شعرَها المُسْتعارْ)
جباةُ الضرائبِ، مستوردو شَحناتِ السّلاحِ
عشيقُ الأميرةِ في سمْتِه الأنثوي الصَّبوحْ!
جاءَ طوفان نوحْ.
ها همُ الجُبناءُ يفرّون نحو السَّفينهْ.
بينما كُنتُ..
كانَ شبابُ المدينةْ
يلجمونَ جوادَ المياه الجَمُوحْ
ينقلونَ المِياهَ على الكَتفين.
ويستبقونَ الزمنْ
يبتنونَ سُدود الحجارةِ
عَلَّهم يُنقذونَ مِهادَ الصِّبا والحضاره
علَّهم يُنقذونَ.. الوطنْ
.. صاحَ بي سيدُ الفُلكِ قبل حُلولِ
السَّكينهْ:
«انجِ من بلدٍ.. لمْ تعدْ فيهِ روحْ!»
قلتُ:
طوبى لمن طعِموا خُبزه..
في الزمانِ الحسنْ
وأداروا له الظَّهرَ
يوم المِحَن!
ولنا المجدُ نحنُ الذينَ وقَفْنا
(وقد طَمسَ اللهُ أسماءنا!)
نتحدّى الدَّمارَ..
ونأوي إلى جبلٍِ لا يموت
(يسمونَه الشَّعب!)
نأبى الفرارَ..
ونأبى النُزوحْ!كان قلبي الذي نَسجتْه الجروحْ
كان قَلبي الذي لَعنتْه الشُّروحْ
يرقدُ الآن فوقَ بقايا المدينه
وردةً من عَطنْ
هادئاً..
بعد أن قالَ «لا» للسفينهْ
.. وأحب الوطن!
(أمل دنقل)