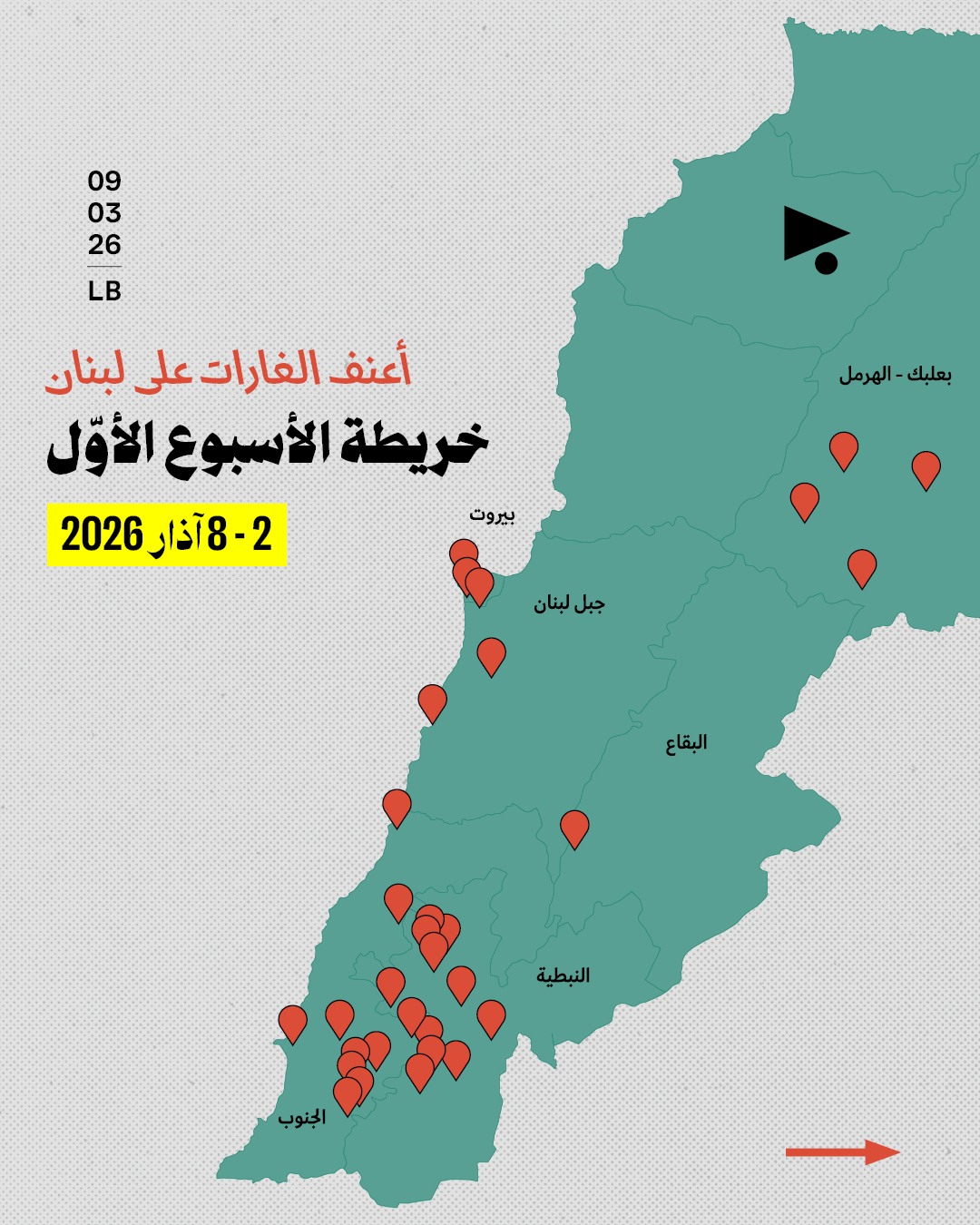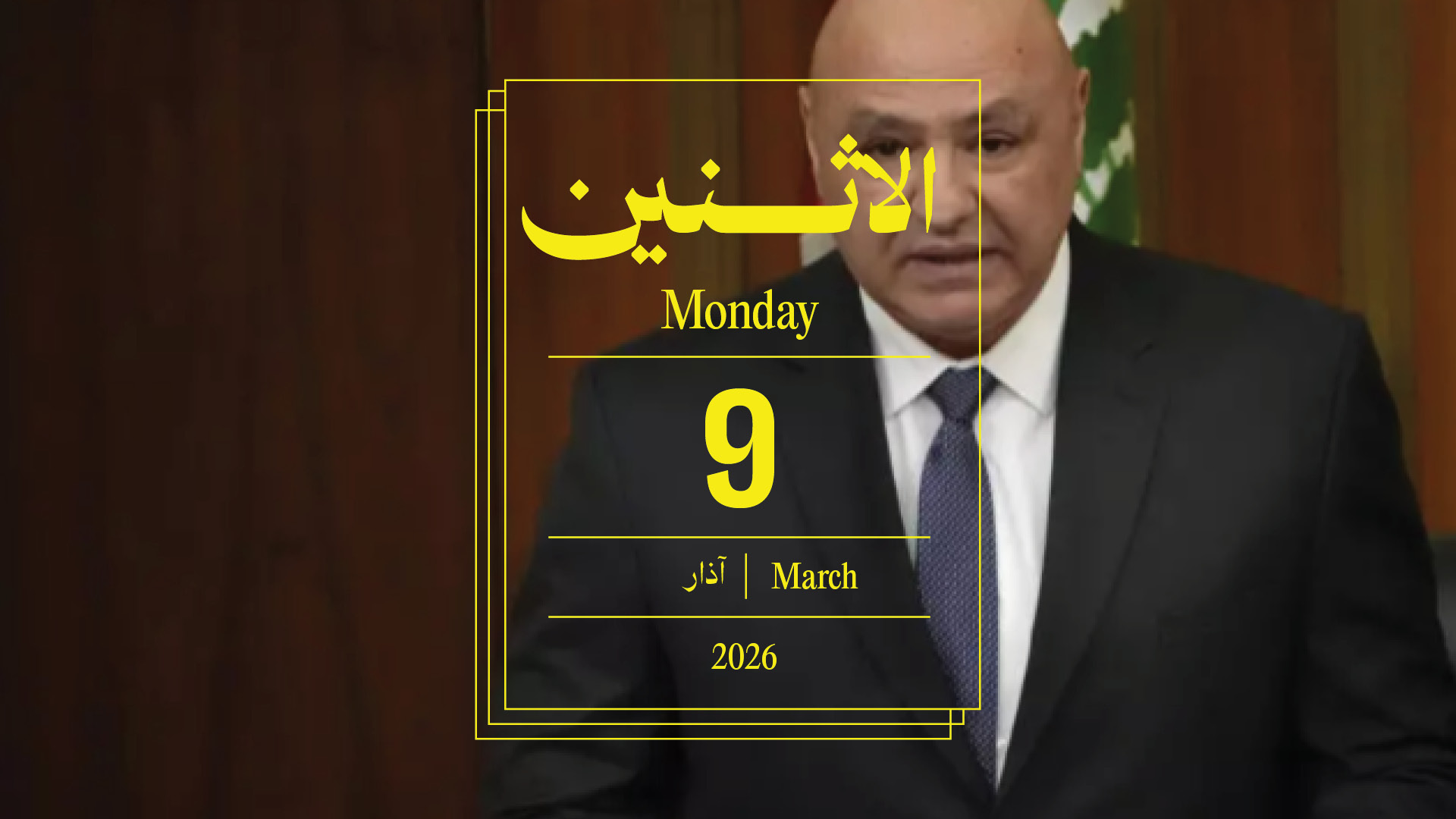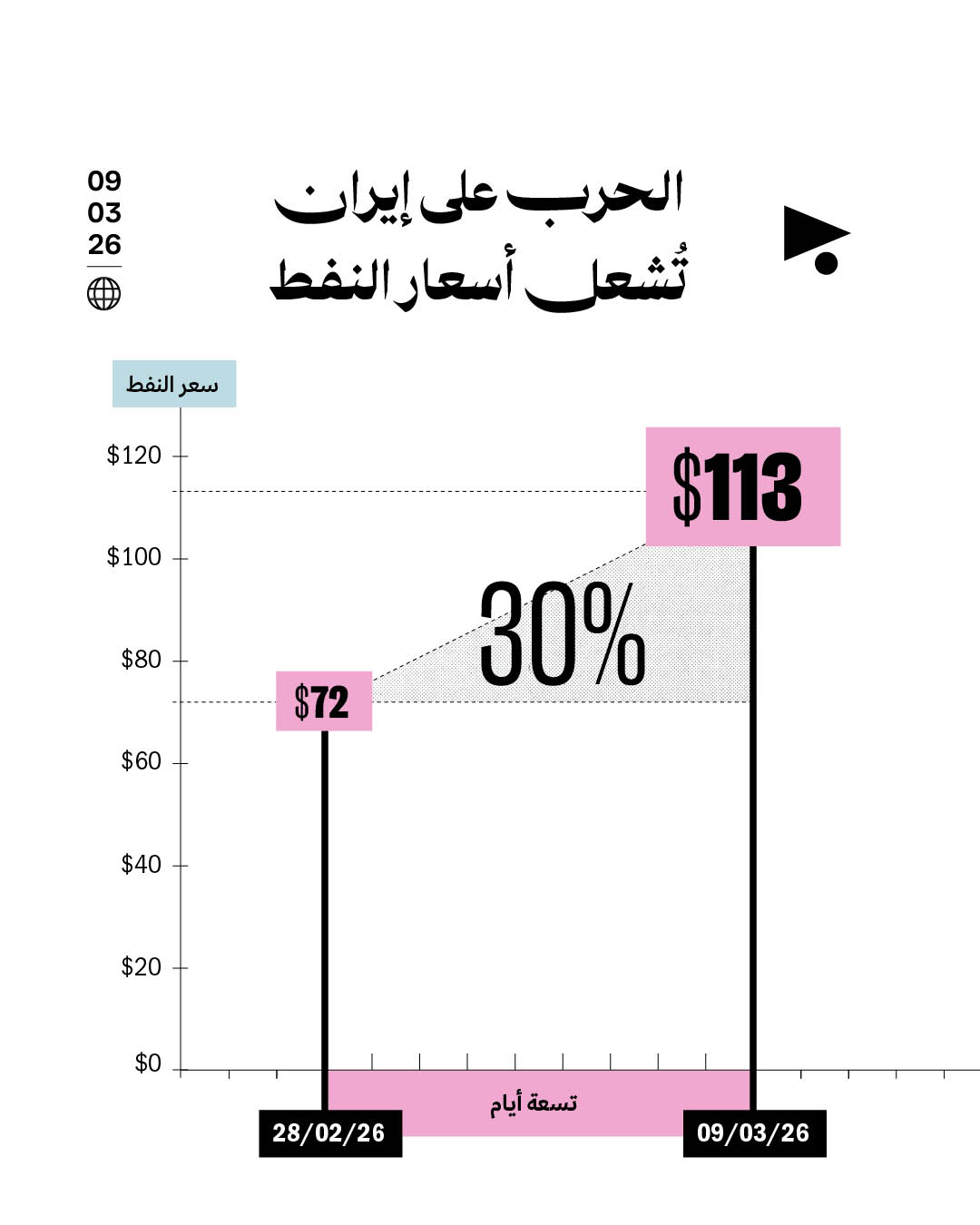منذ أن بدأتُ أقرأ عن كيفية اشتغال النماذج اللغوية الكبرى المشغِّلة لتشات جي. بي. تي وأخواته، وأنا لا أنفكّ أستعيد هذه الذكرى: كنا في الصف الأول ثانوي وأستاذ الأدب العربي يقرأ على مسامعنا أبياتاً من الشعر العربي القديم. توقّف برهة قبل الكلمة الأخيرة من البيت، فوجدتُها وأكملته. سألني: هل تعرفين القصيدة؟ أجبتُ بالنفي، فقال إنّ ما قمتُ به يسمّى رصداً. وصار هذا التمرين- اللُّعبة جزءاً من حصصنا الممتعة مع هذا الأستاذ. كنا نشعر أننا لا نتعلّم تذوّق الشعر وفهمه وحسب، بل نكتشف أيضاً النظام الخفيّ وراء اللغة التي تنتجه.
لم أجد لاحقاً أثراً لمصطلح «رصد» في مثل هذه الحالات، وقد يكون أستاذي استعمله من تلقاء نفسه لوصف ما جرى. لكنّ أهميّته تكمن في أنه لا يصف العملية (أي توقّع الكلمة الأخيرة من البيت الشعري) بوصفها عملية حدسية ووجدانية، بل عملية عقلية حسابية منطقية تقوم على تضييق الاحتمالات واختيار الكلمة الأرجح استناداً إلى السياق والمعنى والقافية والوزن الشعري للقصيدة والقصائد الأخرى المشابهة. وهذا تحديداً ما تقوم به النماذج اللغوية الكبرى اليوم، ولكن على نطاق أوسع بكثير. فهي تعتمد على معادلات إحصائية وتعالج بطريقة رياضية ملايين الجمل ومليارات الاحتمالات لرصد الكلمة التالية والتنبّؤ بها على مبدأ «الكلمة تجرّ الكلمة». وبالاستناد إلى الأنماط المتكرّرة التي تستخرجها من كمّ هائل من النصوص التي غُذّيَت بها، تُنتج بدورها نصوصاً تبدو في الكثير من الأحيان مُقنِعة ومتماسكة إلى درجة باتت تثير الهلع في عالم المشتغلين باللغة والكتابة.
في بداية ظهورها، لم يكن الخوف منها في جوهره خوفاً من التكنولوجيا بحدّ ذاتها، بل من الالتباس الذي تُحدثه عندما نسمعها «تحكي مثلنا»، إذ تتكلّم بلغة تبدو مألوفة إلى درجة مقلقة، فلا يعود واضحاً أين يبدأ الذكاء وأين تنتهي المحاكاة (وفي إطلاق تسمية «ذكاء» على هذه النماذج اللغوية دور كبير في خلق هذا الالتباس). لكنها اليوم، وبعد أن باتت أكثر انتشاراً وبدأت تتبدّى إمكانياتها وحدودها بشكل أوضح، يبدو أنها تصيب فينا جرحاً نرجسياً متعدّد الأبعاد: فالكلام لم يعد كافياً لتمييز الإنسان عمّا يصنعه، والإبداع لم يعد ملكة العقل البشري دون سواه، وموت الكاتب الذي أعلن عنه رولان بارت في الستينيات لم يعد منهجاً خاصاً بالبنيوية، بل بات أمراً محققاً يهدّد حتى الكتابة الإبداعية نفسها.
لكن هل ما تنتجه هذه النماذج اللغوية الكبرى هو كتابة حقاً؟ وما هي الكتابة أصلاً؟ والكتابة الإبداعية تحديداً؟ وهل هذا الخوف والريبة هو خوف على الكتابة الإبداعية حقاً أم خوف من المسّ بمفهوم المؤلّف الذي- رغم كل ما يُقال عن موته- لا ينفكّ يعود تحت مسمّيات مختلفة؟
في الواقع، الكتابة حديثة نسبياً في عمر الحضارة البشرية، ولم يكن لها في أي مرحلة من تاريخها شكل أو وظيفة أو تصوّر ثابت ونهائي، بل هي ممارسة ظلّت تتغيّر على مدى العصور بتغيُّر أدواتها ووظائفها ودورها الاجتماعي. منذ الانتقال من الشفهي إلى المكتوب، ومن المخطوط إلى المطبعة، ومن القلم إلى الشاشة ولوحة المفاتيح، ترافق كل تحوّل تقني مع نبوءات بنهاية الكتابة وزوال الأدب. إلا أن ما تغيّر في كل مرّة كان فهمنا وتصوّرنا للكتابة وللأدب ولدور الكاتب.
في عالم النماذج اللّغوية، باتت النصوص تُنتَج بسرعة وكثافة أكبر حتى لَنجد أنفسنا مدفوعين للسؤال: من كتب؟ الإنسان؟ النموذج اللُّغوي؟ الإثنان معاً؟ بأيّ قدر؟ هذا البحث المحموم عن «المؤلّف» يُضمر في العمق خوفاً ممّا يسمّيه ميشال فوكو «الانتشار السرطاني للمعاني». في محاضرته بعنوان «ما المؤلّف؟» التي يحلّل فيها وظيفة المؤلّف داخل الخطاب، يعتبر أن مجتمعاتنا تخاف من انفلات المعاني بلا وازع، لذا يجيء مفهوم المؤلّف ليضبط المعنى ويقيّد المكتوب وينظّم آليات انتقائه ويحدّ من التأويلات الممكنة. بالنسبة لفوكو، فإن خلف صورة العبقري الخلاق للكاتب، ثمة دور إيديولوجي ووظيفة تاريخية هي تقييد حركة الخطابات ومعانيها.
يعطينا فوكو أدوات لنفكّر بزمننا الحالي الذي يعيد مرة أخرى طرح سؤال المؤلف. ينطلق في محاضرته من اقتباس لصاموئيل بيكيت: لا يهمّ من يتكلّم، فقد قال أحدهم: لا يهمّ من يتكلّم. برأيه، تلخّص هذه العبارة أحد المبادئ الأخلاقية الأساسية في الكتابة المعاصرة والقاعدة الداخلية التي تحكم ممارسة الكتابة الحديثة: أن يختفي صوت الكاتب أو تتقلّص أهميته لصالح النصّ نفسه. فالكتابة الحديثة لم تعد تُفهَم بوصفها «تعبيراً عن الذات الداخلية»، بل باتت تشير إلى نفسها فقط، إلى فعل الكتابة كعملية خارجية، لا إلى دواخل الكاتب نفسه. لكن، بالرغم من ذلك، يعتبر أننا حتى بعد الإعلان عن موت المؤلّف، ما زلنا نتعامل مع النصوص وكأنّ «الكاتب» هو الوحدة الأساسية فيها، حتى إنّنا ابتكرنا بدائل شكلية له، مثل مفهوم «العمل الأدبي» أو «الكتابة» التي تُعيد إنتاج امتياز المؤلف ولكن بعد تحويلها إلى مستوى متعالٍ. فلا خطاب بلا نظام وقيود، وإن اختفى المؤلف فسيُستبدل بآلية أخرى تنظّم الخطابات وتقيّدها. لذا، فإن الأسئلة التي يجب أن توجّهنا هي: أيّ نوع من الخطابات هو هذا النص؟ بأيّ أنظمة يشتغل؟ وأيّ ذات يسمح بظهورها؟
النصوص المولَّدة بالذكاء الاصطناعي ليس لها من الكتابة إلا شكلها، ومن الخطاب إلا وهمه. ومهما بدت متقنة ومتماسكة، فهي لا تملك وعياً ذاتياً بالقول. تكرّرُ ما هو موجود، تعيد تركيبه وإنتاج انتظاماته الداخلية. في حين أن الكتابة الإبداعية الحقيقية ليست مجرد إنتاج للجمل، بل فعل تفكير في اللغة نفسها ومواجهة للمعنى.
«تكتب» هذه النماذج اللغوية الكبرى باتّباع أنساق وأنماط موجودة أصلاً. ولهذا، فالنصوص المولّدة من خلالها، حتى عندما تنجح في تقليد الأسلوب، تظل تفتقد إلى ما يسميه جاك دريدا الـ«إيديوم»، أي ذلك الاستعمال الشخصي والفريد للّغة الذي يحمل بصمة المتكلّم أو الكاتب، والذي يبقى عصياً على الترجمة. إنه ليس الأسلوب فقط، بل هذا الاختلاف الداخلي، الذي لا يكرّر ما سبق ولا يمكن تكراره.
من هنا، لا يبدو خطر الذكاء الاصطناعي، إذا أردنا أن نتحدّث عن خطر، كامناً في قدرته على استبدال الإبداع البشري والحلول مكانه، بل في تعميمه ما يسميه رولان بارت الطابع «الفاشي» للّغة. ففي جوهرها، تفرض اللغة علينا أن نتكلّم وفق نظامٍ مسبق، أن نختار من داخل معجمٍ مُعدّ سلفاً، وأن نُعبِّر وفق تراكيب لا مهرب منها. لا أحد ينجو تماماً من هذه السلطة. لكنّ ما يثير القلق اليوم هو أنّ النماذج اللغوية الضخمة التي يتغذّى منها الذكاء الاصطناعي، لا تكتفي بتكرار هذه الفاشيّة الأصلية، بل تعمّمها وتُبرمجها. فهي تُعيد إنتاج ما هو سائد في اللغة، وتُكرِّس ما هو متكرّر ومقبول ومفهوم، وتُقصي ما هو شاذّ ومُلتبس أو مقاوم للمعنى السائد. وهنا يكمن الوجه الأكثر تشاؤماً في علاقتنا بهذه التكنولوجيا: إنّها تُعيد إلينا اللّغة في صيغتها الأكثر انضباطاً، أي في صورتها الأكثر فاشيّةً.
غير أنّ الخلاص، كما كان يرى بارت نفسه، لا يكون إلا في الأدب والشعر اللذين يفتحان اللغة على مُمكناتها المضمرة، ويعيدانها إلى طابعها الجسدي والمجازي، إلى «اللّذة» التي تنشأ حين تتعطّل القواعد وينفلت المعنى. في الشعر والكتابة الإبداعية عموماً، محاولة دائمة للانفلات من قيد اللغة، باستعمالها ضدّ نفسها وتفجير نظامها من الداخل. والنماذج اللغوية، مهما بلغت من تعقيد، ستظلّ تسعى إلى الكمال والوضوح والانتظام، وهذا تحديداً عكس الشعر وعكس الأدب الذي سيظلّ المساحة التي تنجو فيها اللغة من فاشيتها، والملاذ الأخير لما هو إنساني في القول.