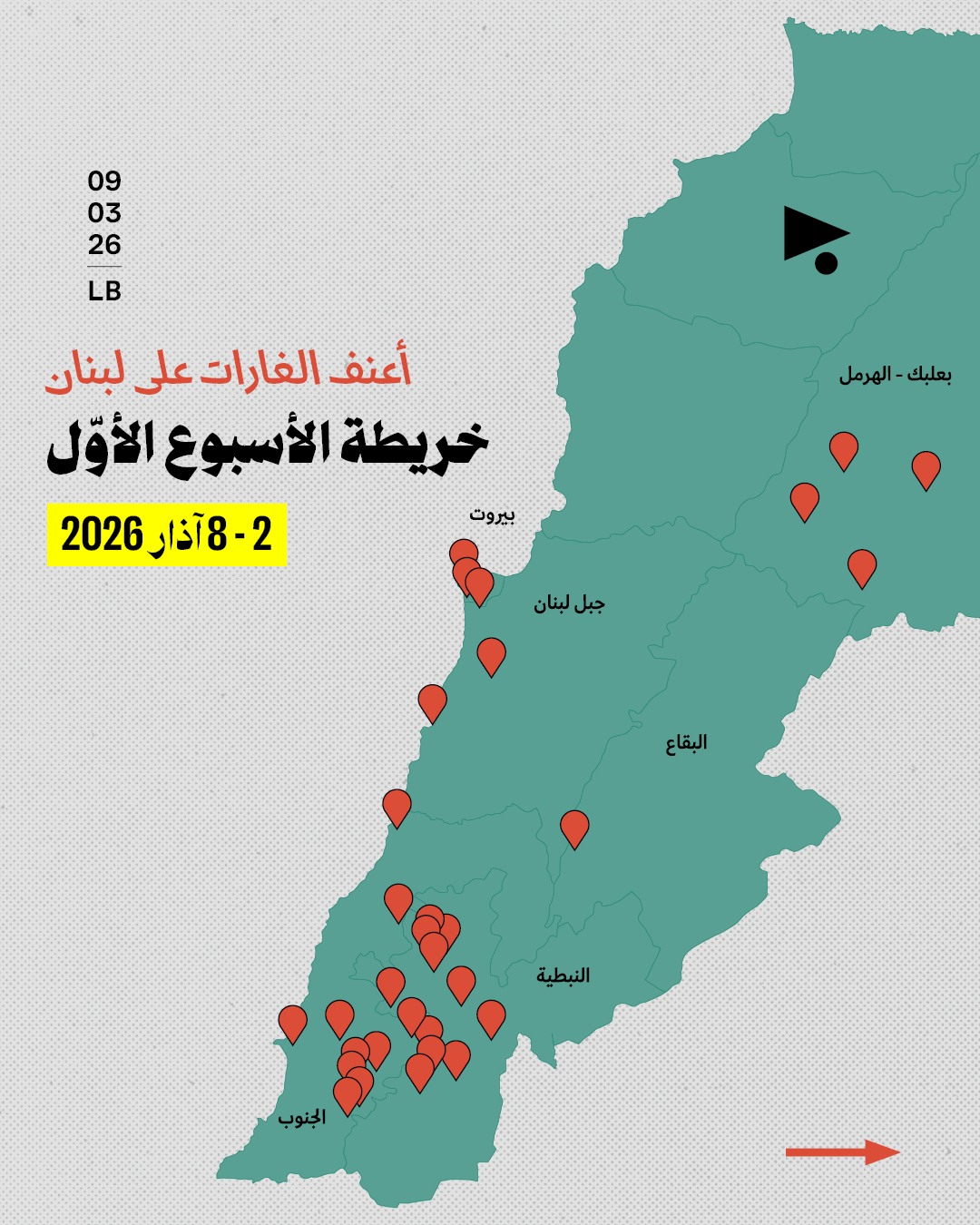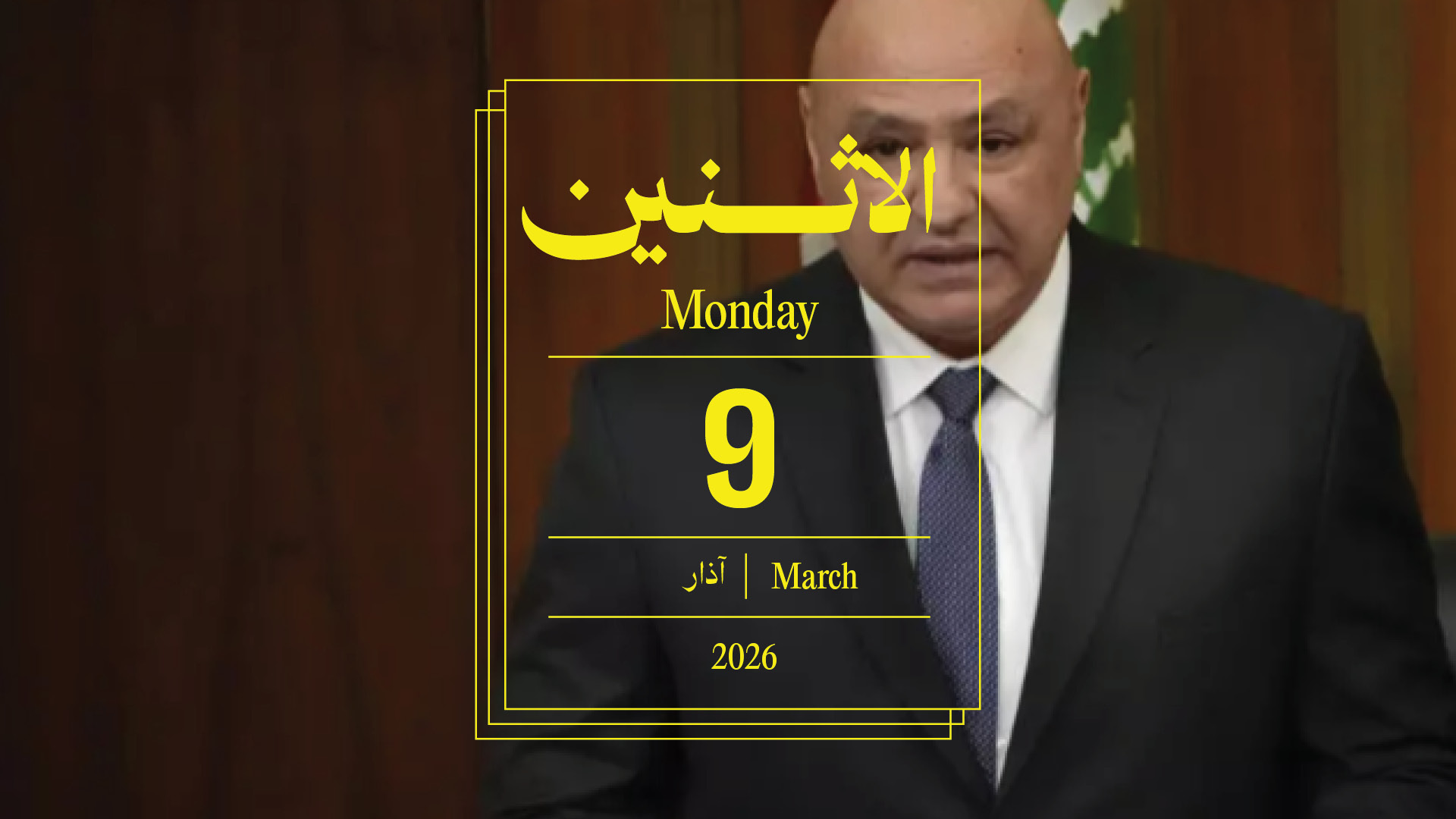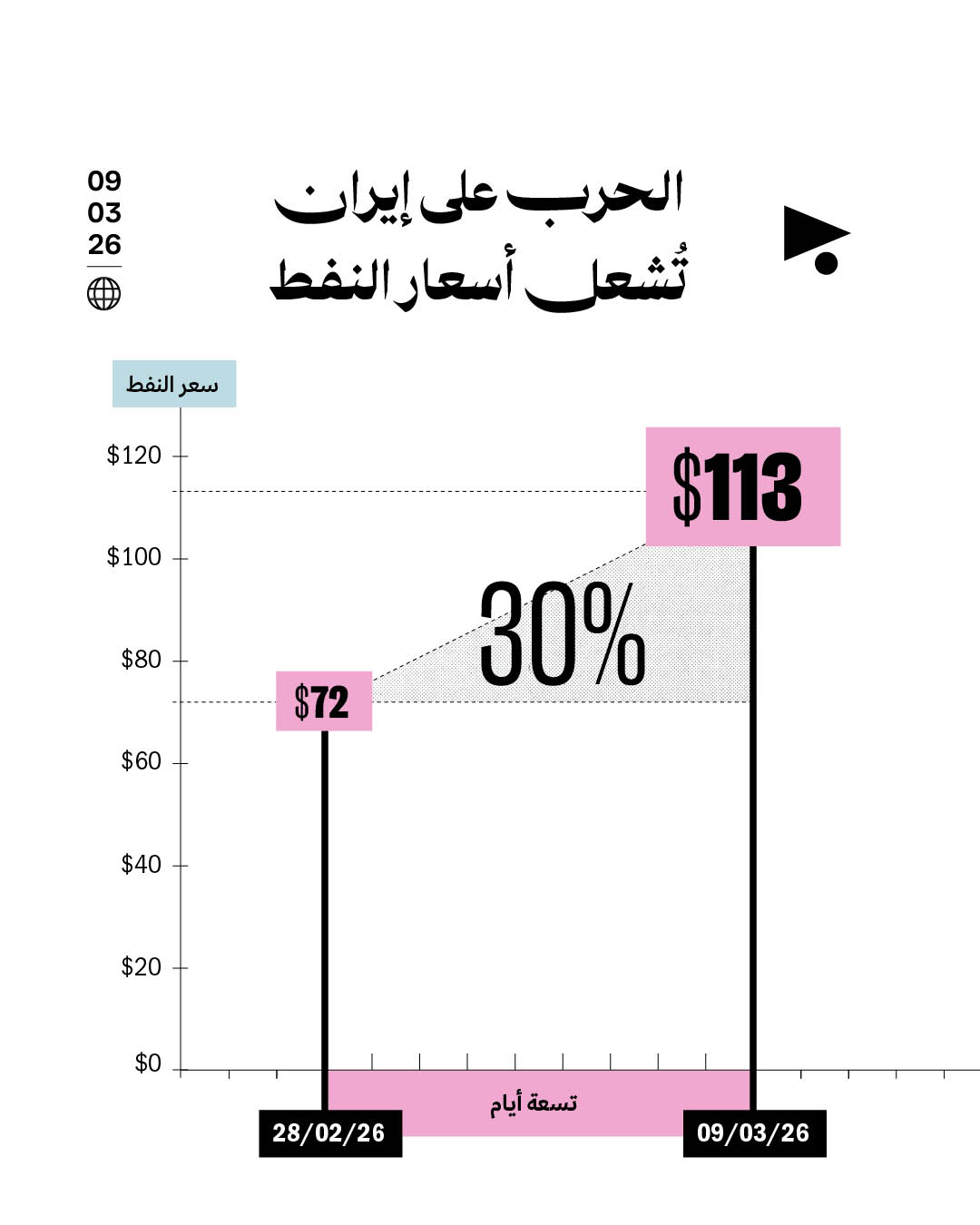قلت إنّنا سنمنع قيام دولة فلسطينية، وها نحن نفعل ذلك.
بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي
يعترف عددٌ من الدول الأوروبية، اليوم، ولنقل «أوروبا» من باب التسهيل، بالدولة الفلسطينيّة، في الجمعية العمومية رقم 80 للأمم المتّحدة، انطلاقاً من مبادرةٍ سمسرتها السعودية مع فرنسا، وذلك عطفاً على التأكيد على أنّ حلّ الدولتين هو الطريق لسلامٍ شاملٍ في الشرق الأوسط.
هذا القرار— مُجتزأً ومعزولاً عن سياقه— يشكّل خطوةً تاريخيةً وانتصاراً للقضية الفلسطينية؛ إنّما، عند ردّه إلى السياق الأوسع، يتّضح أنّه أقل من ذلك بقليل. في ما يلي عدد من الإشارات ليس إلّا، لقراءة هذا القرار على ضوئها.
تجدر الإشارة بدايةً إلى أنّ هذا الإقبال الأوروبيّ يأتي وسط تنديدٍ إسرائيلي وأميركي. هذه الأقطاب الثلاثة كانت في أمسٍ قريبٍ قطباً واحداً (إلى حدٍّ ما). خطوة الاعتراف الأوروبي تأتي في سياقٍ أوسع من محاولة «التمايز» الأوروبيّ عن الولايات المتّحدة، بل منافستها، وخلق قطبٍ له طابع «أكثر إنسانيةً» ودبلوماسيّةً. [الأمثلة في هذا الهامش]. تمظهرت هذه الثنائية مع موقف ترامب حول الحرب الأوكرانية- الروسية: ترامب يُهين زيلينسكي فتدعمه أوروبا حتّى ينقطع نفسها. ترامب يتقرّب من بوتين فتنعته أوروبا بهتلر عصرنا. ترامب يروّج لريفييرا غزّة، بالتزامن مع زيارة ماكرون إلى معبر رفح، فيؤكّد الأخير أنّ مخطّط التهجير مرفوض. ترامب (من خلال مورغان أورتاغوس بالتحديد) يرى أنّ «حزب الله سرطان يجب استئصاله» فيما تشدّد فرنسا على أنّ نزع السلاح لا يمكن أن يتم بالقوّة. ثم يستيقظ ترامب ويقرّر أن يشنّ حرباً تجارية على الاتّحاد الأوروبي. أو تقرّر إسرائيل إذلال خارجية عدد من الدول، عبر منع محامي هذه الدول من مقابلة ناشطي أسطول الصمود المحتجزين في الزنازين الإسرائيلية. إنّه تمايز يزداد اتّساعاً بين هذه الأقطاب إذاً، وضمن هذا التمايز، على المستوى الدولي، تقع خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ الأسابيع السابقة على هذه الخطوة شهدت تطوّراً ملحوظاً في سؤال «الإبادة» على الساحة القانونية الدولية [الأمثلة في هذا الهامش]. نشرت المقرّرة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي تقريراً يسمّي الدول والشركات المتواطئة مباشرةً بما أسمته «اقتصاد الإبادة / اقتصاد الاحتلال»، الأمر الذي كشف ثغرات تسمح بمقاضاة أطراف تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن الموضوع. بعد أسابيع نشرت منظّمة العفو الدولية تقريراً مشابهاً يسمّي نفس الشركات. كما أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلّة أنّ «دولة إسرائيل تتحمّل مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية». ضاقت الخيارات على الزعماء الأوروبيّين، وبات واجباً عليهم تليين موقفهم الإباديّ قليلاً، كما اتّسعت احتمالات القبض على شركاء غير إسرائيليين متورّطين بالإبادة. خطوة الاعتراف تأتي في سياقٍ أوسع من محاولة المتورّطين تقديم صكّ براءة، بما معناه: «لا يمكنني أن أكون متورّطاً بإبادة شعبٍ قد منحتُه دولةً للتو!». أو: «لطالما كنّا ضدّ «العنف المفرط» الذي ترتكبه إسرائيل، انظروا، نحن دعاة سلام».
تجدر الإشارة، انطلاقاً من هذه النقطة، إلى أنّ مَن أقدموا على خطوة اليوم، هم عينهم مَن سهّلوا ارتكاب الإبادة وهيّأوا شروطها ومنحوها غطاءً سياسياً دبلوماسياً عسكرياً؛ وللمفارقة، ما زالوا يساهمون بها (كان ينقص أن تعترف ألمانيا والولايات المتّحدة بالدولة الفلسطينية اليوم) [الأمثلة في هذا الهامش]. معظم الدول الموقّعة اليوم استهلكت عبارة «حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وهي تعلم أنّ هذه العبارة تعني حقّ إسرائيل بفتح حربٍ بلا تمييز على غزّة. ثمّة بين الدول الموقّعة اليوم، دولٌ فتحت مجالها الجويّ لطائرة نتنياهو الخاصّة عوض التزامها بمخرجات المحكمة الجنائية الدولية. فيما كان كير ستارمر يعترف بالدولة الفلسطينية، كانت طائرات الاستطلاع البريطانية تُقلع من قبرص وتحوم فوق غزّة وتقدّم معلوماتها الاستخباراتية للجيش الإسرائيلي. أمّا فرنسا، فقد زوّدت إسرائيل، بعد السابع من أكتوبر، بأكثر من 15 مليون قطعة حربية قيمتها أكثر من 8 مليون دولار. عدا عن المساهمة الإعلامية في الترويج للبروباغندا الصهيونيّة، بدءاً من علك كذبة الأطفال مقطوعي الرأس.
تجدر الإشارة، عطفاً على الموضوع نفسه، إلى أنّ مناهضة الإبادة ومناصرة الفلسطينيّين ليستا حقّاً من سِمات الحكومات المؤيّدة لقرار اليوم، بل الأدقّ: إنّه قرار شعوب هذه الحكومات وشبابها وطلابها وعمّالها وأحزابها التقدّمية ومؤسّساتها ولوبياتها المناصرة لفلسطين، والتي ضغطت على هذه الحكومات [أمثلة في هذا الهامش]. نوّاب اليسار في فرنسا حضروا جلساتهم البرلمانية وهم يرتدون الأعلام الفلسطينية ويرفعون بوجه إدارة ماكرون صور الأطفال الشهداء؛ لم تخلُ بلجيكا من التحرّكات الأسبوعية المناصرة لفلسطين؛ تراجعت شعبية حزب العمّال البريطاني بسبب الموقف المتقاعس تجاه فلسطين، فيما حظيَ اقتراح جيمي كوربين بتأييد واسع، حين قرّر تأسيس حزبٍ يساريٍّ جديد يدعم فلسطين من دون مواربة، مع منشقّين عن حزب العمّال… بالإضافة عموماً إلى حراك الجامعات، والرأي العام الشاب الأكثر ميلاً لفلسطين، وتأثيره على أي محطّة انتخابية أو سواها في البلد المعنيّ. أي إنّها، للأسف، «الورقة الانتخابيّة».
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الاعتراف مجّاني: لا عقوبات تُذكَر على إسرائيل، حسناً، بعد سنتَين، وبعد أكثر من دورة، تمكّن الاتّحاد الأوروبي، وأخيراً، من تعليق اتّفاقية التجارة مع إسرائيل — جزئياً. ولا أي قطيعة مع مُمكّنات الإبادة، تُعدّ على أصابع اليد الدول التي علّقت التجارة العسكرية مع إسرائيل. دولٌ أخرى حاولت أن تتحذلق، مثل إعلان ألمانيا وقف تزويد إسرائيل «بالسلاح المستخدم في قطاع غزّة»، فيما استمرّت بتزويدها بالقطع الحربية المستخدمة خارج غزّة، وكأن ما من إبادة تُرتكب في الضفّة الغربية، أو كأنّ، بحدّ تعبير ألبانيزي، ثمّة «إسرائيل الشريرة» التي تشنّ الإبادة وتستوطن بشكلٍ غير شرعي، و«إسرائيل الجيّدة» الموجودة بمعزل من هذه التجاوزات. الأسبوع الماضي، وبعد كيلٍ من التهديدات التي وجّهها الرئيس ماكرون إلى إسرائيل، ربطاً باجتياح مدينة غزّة، أنهى الرئيس مداخلته بإبداء الرغبة «في العمل» مع نتنياهو.
ولا أي إدانة جدّية لإسرائيل– لا بل الأسوأ، تَنسب هذه الدول كل الشرور إلى «الحكومة الإسرائيلية» أو حتّى «المتطرّفين داخل الحكومة»، من دون أي التفات إلى الطبيعة الاستعمارية الإبادية لإسرائيل بذاتها. وبالتوازي، ما من «بادرات حسن نية» تجاه أي شيء يمتّ بفلسطين التي سيُعتَرَف بدولتها. أبسط الأمثلة أنّ التحرّكات المناصرة لفلسطين ما زالت تُقمع في هذه البلاد. فيما كان كير ستارمر يعترف بالدولة الفلسطينية، كانت بلاده قد اعتقلت ما يُقارب مجموعه ألف شخص تضامنوا مع «بالستاين أكشن»، بتهم «الإرهاب».
من هنا، تجدر الإشارة، كما يجدر التشديد، على أنّ هذا الاعتراف هو اعتراف مشروط. لم يتم الاعتراف بأي دولة فلسطينية فعلية اليوم. هي ليست دولة كما هي فرنسا دولة، ولا كما هو لبنان دولة، ولا حتّى كما ينظر موقّعو الاعتراف إلى إسرائيل كدولة. اعتراف اليوم هو اعتراف بدولة ممسوخة تشبه كل شيء إلّا… الدولة [الأمثلة في هذا الهامش]. ستكون دولة منزوعة السلاح (!). وهذا شرط وافق عليه الرئيس المفترض لهذه الدولة. وسوف يتسنّى للدول الأجنبية المعترفة بهذه الدولة، أن تستبعد فصائل فلسطينية عن ممارسة السياسة في هذه الدولة. بل أنّه لن يُطبّق الاعتراف بهذه الدولة إلّا بعد أن يحلّ فصيل فلسطيني نفسه. ستكون دولة على حدودٍ ما عادت موجودة. أمّا الأراضي المتبقّية لهذه الدولة، فهي أشبه بالجزر، يصعب على رئيس البلاد أن يزورها من دون المرور عبر أراضي «دولةٍ» أخرى.
تجدر الإشارة في الختام إلى أنّنا لا نودّ، في هذا المقال، التطرّق إلى حسابات السلطة الفلسطينية الضيّقة، وأنيابها التي تنتظر الانقضاض على غزّة عند الاعتراف بدولةٍ ذات سيادة على حدود الـ1967 (عدا عن أنّ هذه الحدود قد تبخّرت).
ثم تجدر الإشارة إلى أنّ الدولة الفلسطينية ليست سوى درجة من درجات سلّم التطبيع السعودي، أي أنّ السعودية – اللاعب العربي الأبرز، والتي كانت على وشك التطبيع قبل السابع من أكتوبر، ارتدعت قليلاً نظراً لفداحة المشهد، وها هي تعود اليوم وقد حلّت معضلتها الأخلاقيّة: التطبيع مع إسرائيل من باب حلّ الدولتين، فلا يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية في هذا السياق سوى هامشٍ على متن الصورة العربية.
وتجدر الإشارة، من باب الـbonus، إلى أنّ رئيس الحكومة البريطانية، في خطاب اعترافه بالدولة الفلسطينية، لم يأتِ على ذكر وعد بلفور.
بناءً على ما تقدّم، وبعد وضع خطوة اليوم في سياقها، يكون اليوم هو يوم تلوين الدم. طبعاً، قد يأتي مَن هو أقلّ تشاؤماً منّي ويعرض وجهة نظر مغايرة، حيث نرى منافع ما حصل اليوم، و«تاريخيّته»، والانتصارات التي حقّقتها «القضية» حتّى اليوم، والبيانات، والمجتمع الدولي، والشرعيّة، وعزل إسرائيل… وقد يأتي مَن يحاول أن يكون أكثر تقدّميةً والتصاقاً بالفلسطينيّين، فيُقرّش «ثمن الدم»، ويقول، ولو بنيّةٍ حسنة، أنّ الفضل ليس لهذه الدول، بل لدماء 60 ألف فلسطيني. حاولت، عن قصد، أن أتفادى قدر الإمكان ذكر أي شيء يمتّ لمعاناة الفلسطينيّين وخاصّة الغزّاويين، في سياق هذا المقال. خطوة اليوم، بالطريقة التي وردت بها، تشوبها ما يكفي من الشوائب حتّى تتعرّض للنقد. والشروط المعطوفة على خطوة الاعتراف، تكفي للمطالبة بدولة «أكثر لياقةً» تجاه الفلسطينيين. هذا كلّه رديء حتّى في سياقٍ عادي للأمور، حتّى لو لم تنفجر الإبادة من المقام الأوّل. إذاً لا حاجة إلى التطرّق لوقائع الإبادة في غزّة واستخدامها كورقة في المحاججة هنا.
لكن هل تستحقّ هذه الدولة كل هذه الدماء؟ وأقصد: كل هذه الدماء التي سُفكَت منذ العام 1948؟ وبعد كل ما حصل، وكل دورات العنف التي تحكم السياسة في هذه المنطقة، هل ما زال نموذج «الدولة» نموذجاً فعّالاً لإدارة الشؤون في هذه المنطقة الجغرافية، ولا سيّما مع تكريس وجود «دولة» إبادية؟
قبل شهرٍ بالتمام، صادقت إسرائيل رسمياً ونهائياً على خطّة البناء الاستيطاني E1 شرقي القدس، حيث تُفسَخ الضفّة الغربية إلى شطرَين، وحيث تُعزَل القدس عن محيطها، وهي نفس القدس التي يُفترض أن تكون عاصمة الدولة المُعترَف بها اليوم. الوزير (الذي يحب الغرب تصنيفه «متطرّفاً») بتسلئيل سموتريتش، علّق قائلاً: الدولة الفلسطينية مُحيت… بالأفعال وليس بالشعارات.
يمكن الإقرار إذاً بأنّ العراضات الخطابية قد تأتي بنتائج عكسية على أرض الواقع، إن لم تترافق مع قوّةٍ مادّية ملموسة مهمّتها تطبيق هذا الخطاب. وهكذا، كلّما اعترفت أوروبا– كلامياً– بالدولة الفلسطينية، حرصت إسرائيل– فعلياً– على جعل هذه الدولة مستحيلة.
هل أنّ الجملة الأخيرة تزيح المسؤولية من إسرائيل إلى أوروبا؟ كلا (مع أنّ في هذه الإزاحة ما هو صائب).
هل أنّها تقول ضمنياً أنّ خطوة اليوم أعطت إسرائيل عذراً لتتمادى باستعمارها؟ كلا.
هل أنّها تقول إنّه من الأفضل لو لم تكن خطوة اليوم؟ كلا.
هل لا أريد أن يعترف العالم بدولةٍ فلسطينية؟ بالطبع أريد.
ربّما لو حصلت خطوة اليوم في سياق آخر، لما كانت لتستدعي كل هذا النقد؛ أو ربّما لو لم تُستخدَم «الدولة الفلسطينية» كورقة لابتزاز الفلسطينيين أنفسهم وترويضهم، لما كنّا قد وصلنا إلى سياق اليوم. ولكن يعلم المرء أنّ مثل خطوة اليوم لم تكن لتحصل إلّا في هذا السياق. وإنّ تقاطع هذه الخطوة مع هذا السياق، يعزّز فكرة العوالم الموازية، فكرة وجود غزّة و«العالم خارج غزّة»، أو وجود الواقع هنا والواقع كما يُرى من هناك، وكأنّه، مجرّد مشهد.
المقصود، ببساطة، هو أنّ كل ما تقدّم يظهر كيف يتعامل معنا «الغرب»، عموماً، على أنّنا مسألة لغوية ليس إلّا، وكأن لا وجود لنا في عالم الواقع — بينما تتعامل معنا إسرائيل بالتحديد بحسب واقعنا ووجودنا الملموس، بصرف النظر عن خطابنا. مشكلتها ليست مع الخطاب الذي يحمله الفلسطينيون، بل مع وجود الفلسطينيين بذاته. هكذا، تحوّل خطوة اليوم الدمَ إلى مجرّد مجاز، وفيما ينشغل العالم بالخطاب، تهتمّ إسرائيل بالفعل.