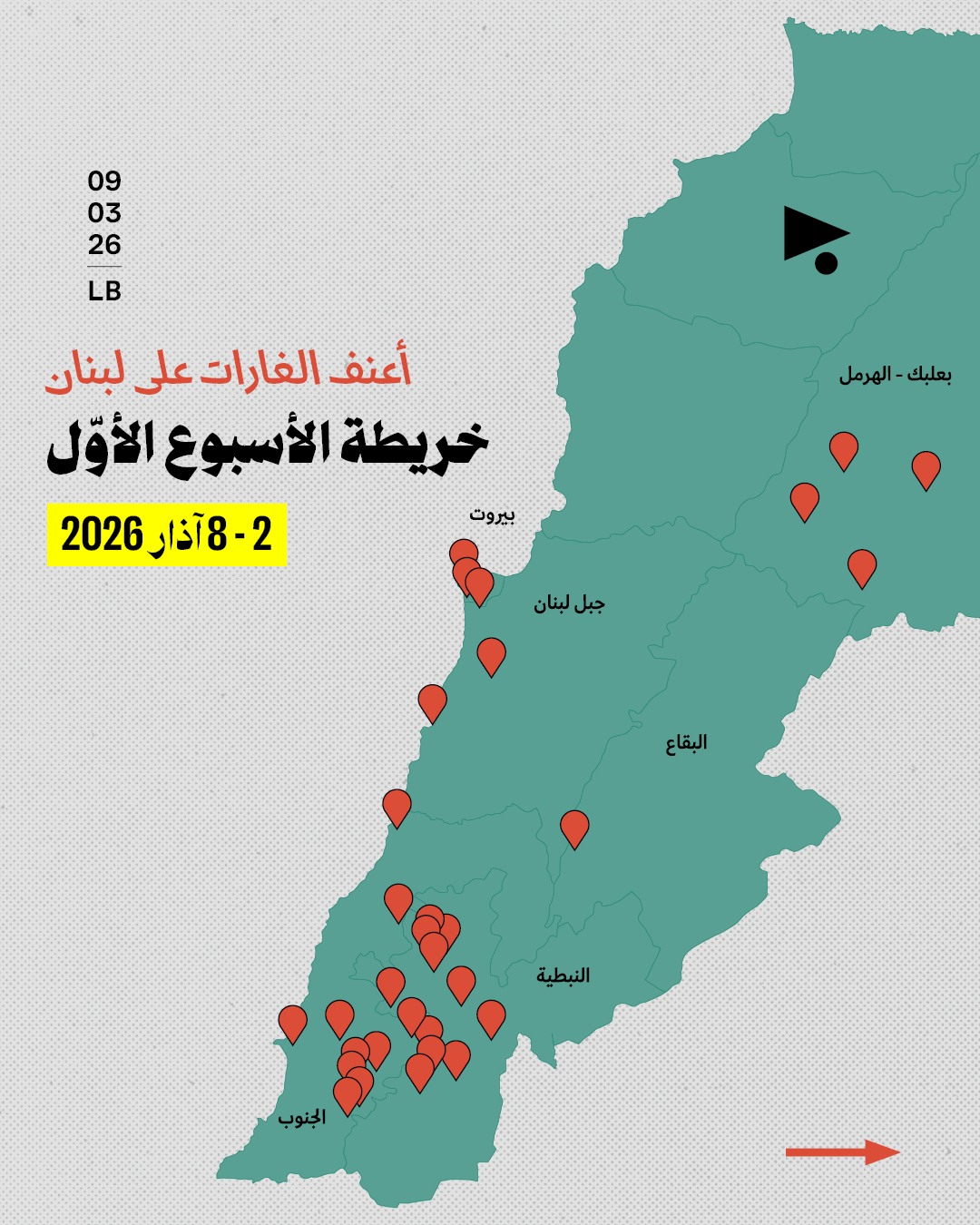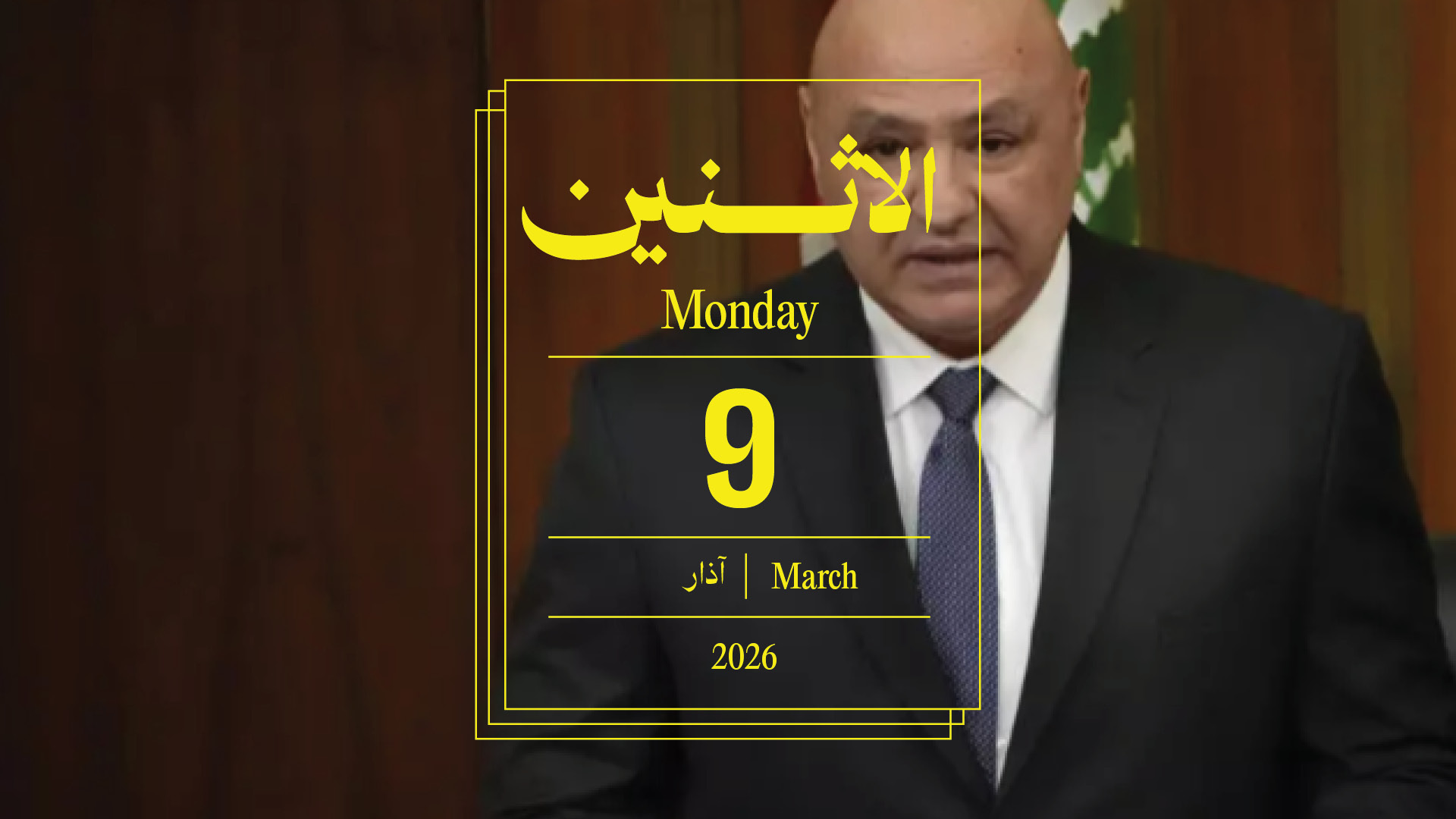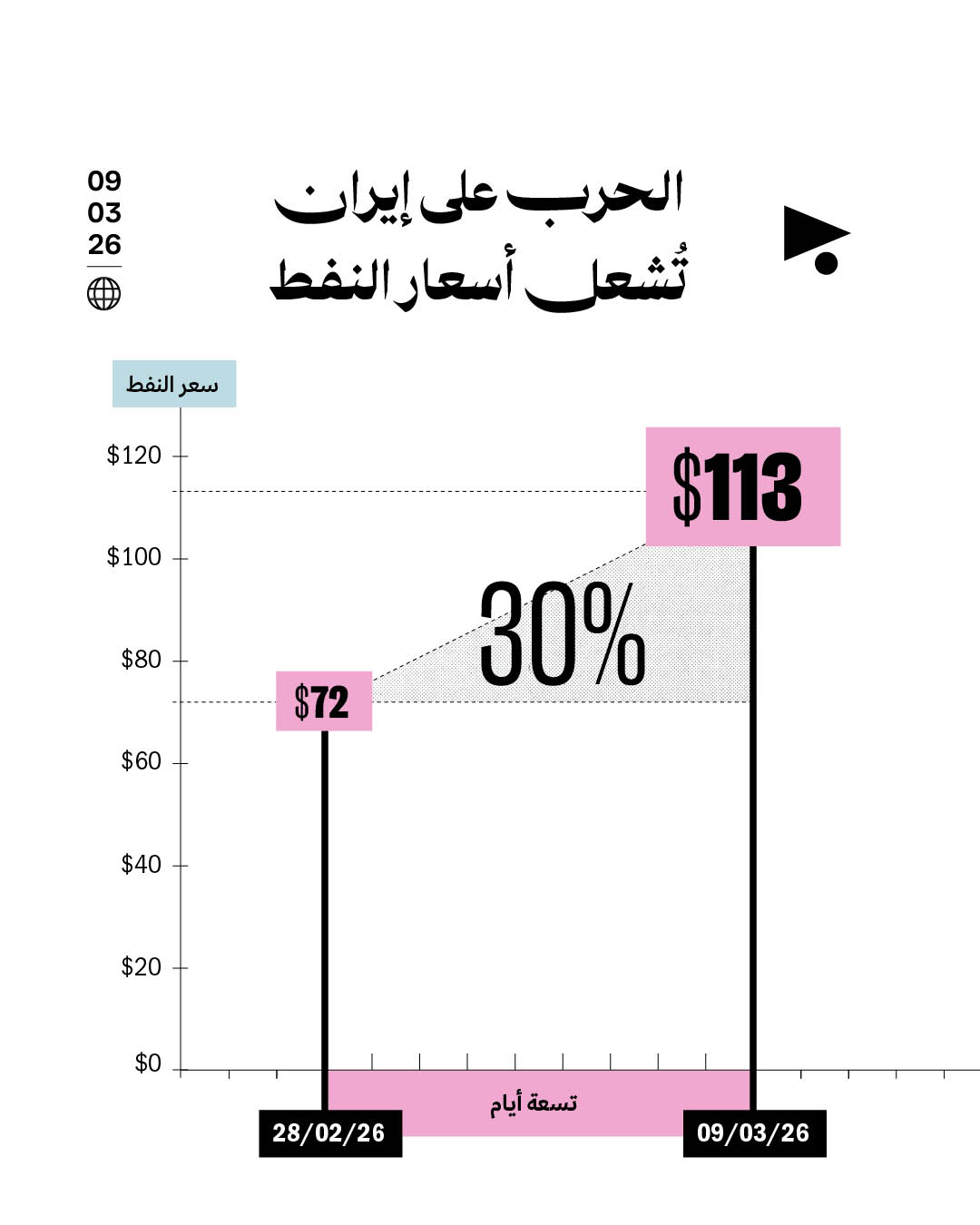الستارة البيضاء الخفيفة تنساب على دلفات باب البلكون الخشبيّ المطلّ على الشارع، كلّما تحركتُ، هبّت رائحةُ بخّورٍ طيّبٍ من الداخل، تسري لثوانٍ في الهواء، ثم تغادرنا.
تخرج الجارة السودانية تنادي على جدّتي وتسألها إن كانت ستخرج إلى السوق اليوم لتشاركها المشوار، وحين تقرّران، تقضيان معاً نصف اليوم في السوق، وحين يرسلنا أهلنا للبحث عنهما ومساعدتهما في حمل الخضار، نجدهما تنصبان جلسةَ سمرٍ لدى عطّارٍ أو بائعة خضار تحكيان وتتذوّقان البضاعة، ونحن كأطفال، نعاني من الملل ونهدّدهما بالانصراف لو استمرّت الجلسة.
كبرتُ وذهبتُ لتغطية الأحداث في السودان مرّتين، ومشيت إلى الخرطوم وأم درمان ثم جوبا في جنوب السودان. وأتذكّر، حين عرفت أنّ الجدّةَ في السودان يُطلق عليها اسم «حبوبة»، تذكّرتُ وجه الجدّة السوادنية جارتنا. كان الاسمُ يليق بها بالفعل. دائماً ما تُرقرق قلبَ جدّتي علينا، وغالباً ما تملك حلوى في أحد جيوبها الكثيرة. ظلَّ السودان نسيجاً عضوياً في حياتنا اليومية المصرية. العلاقة لم تكن موسمية أو مرتبطة بظروف الحرب والتهجير فقط، ولكنّهم موجودون في ذكرياتنا اليومية والعادية. هناك مَن بنوا بيوتهم وعمرّوا مناطق بعيدةً نائيةً وقدّموا لأرضنا الخير والمحبّة لعقود. عاش أجدادي كمستأجرين في منزلٍ تملكه أسرةٌ سودانيةٌ نزحت منذ أربعينات القرن الماضي. ألبوم الأفراح العائلي الذي يجمع خالاتي بفتياتهم وشبابهم في كل الأفراح، سيعطي انطباعاً وحيداً: أنّهم عائلة واحدة! لم يبلّغنا أحدٌ أنّهم «ليسوا منّا»، فلماذا يُخبرنا الساسة وسماسرة الحروب ودول صنعها الاستعمار، أنّهم ليسوا منّا؟ أو أنّهم مجرّد «لاجئين»؟ احتفَظوا بكلّ تقاليدهم السودانية في الأفراح والفواجع وشاركنا فيها على طريقتهم، وشاركونا طريقتنا في السرور والغبن. عشنا ولا نزال.
صرخت اعتماد في الحضور:
انتبَهَ العالم الآن لسقوط الفاشر، لأنّ الحكومة سقطت، لكنّ الناس سقطوا في الفاشر منذ عامَين، ولم يشعر هذا العالم بأي شيء. فمنذ بلغت عصابات الدعم السريع المدينة، حاصرونا وجوّعونا في منازلنا. وعند أي محاولة للخروج، كنّا نواجه القنّاصة على عتبات البيوت والأسطح. كان الاختيار بين الموت في الدار والموت في الشوارع. وهناك، جثّة، متروكة مثل المئات على الطرقات.
وكان لا بدّ أن ترحل اعتماد، محاولةً إنقاذ ابنتها. لم يكن هناك سبيل سوى النزوح إلى ليبيا في مغامرةٍ مأساوية. كانت اعتماد تعمل صحافيةً ومراسلةً لعددٍ من المواقع وتولّت قسم الإعلام في عددٍ من المؤسّسات في مدينة الفاشر…
ولكن ومنذ عام 2023، صار كلّ العاملين في مجال الإعلام مستهدفين أو محاصرين، وهذا سبب نقص التغطية الحاد في الفاشر. لقد أُلقيَ القبض على بعض الصحافيّين، أمّا الباقون فهم في عداد القتلى أو المخفيّين قسراً. قبل تشرين الأوّل من هذا العام وقبل السقوط الرسمي للفاشر، ظلّ الاختفاء القسري علامةً ثابتةً: يومياً يختفي نحو 500 شخصٍ. ولكن بعد السقوط الرسمي، تفوّقت الأرقام على ذلك، من دون أن نستطيع تحديدها، لأنّنا فقدنا الاتّصالات كليّاً مع رفاقنا المتبقّين هناك، والآن المدينة كلها مختفية قسراً، ولا نصل لأحد.
تجمد الحضور من كلمات اعتماد. تراب الرحلة لا يزال على حذائها. وصلت قبل أيّامٍ قليلة إلى مصر، بعد رحلةٍ مرعبةٍ من ليبيا التي لم تجد فيها القوتَ لأيّامٍ متتاليةٍ، ولكن يظلّ الجزء الأكثر وحشيّةً من هذا، كما قالت اعتماد، هو أنّ أغلب السودانيين يصلون إلى مصر سيراً على الأقدام في الليل.
كانت خطّة عزل المدينة عن العالم موضوعةً من قبل مهندسي الاستعمار في خليجنا العربي، الذين استغلّوا انشغال العالم بحرب الإبادة في غزّة، ليتمكّنوا من تغيير الواقع جذرياً في الفاشر لصالح رجالهم، قوّات الدعم السريع. يُدرك كلّ الدارفوريين خاصّةً والسودانيين عامّةً، أنّ الأسلحة التي قُتلوا بها في مدنهم وقراهم، تموّلها الإمارات التي تعمل أيضاً على إخفاء الجرائم التي وقعت خلال عامَين. ومن الغرور أن تتصوّر الدولةُ التي تتحكّم في جزءٍ من الواقع السيبراني في المنطقة العربية، أنّه بإمكانها إخفاء وقتل 200 ألف مواطن في الفاشر ودارفور.
رغم ما يمرّ به السودان من أهوال، لم يتوقّف شعبه عن الغناء. في كلّ مناسبة، يجتمعون من كل فجّ، للالتفات حول فنّانيهم الذين نزحوا بسبب الحرب. وبعد دعوة لجنة الحريات في نقابة الصحافيين لتنظيم يومٍ للتضامن مع السودان، حضر المئات من أربعة أحياء تمركزوا فيها في القاهرة: حي عابدين والحي التاريخي الذي يضمّ أقدم تجمّع سوداني منذ مطلع القرن الماضي، والأحياء الجديدة التي تمركزوا فيها بعد الحرب الأخيرة، حي فيصل في الجيزة وأحياء عين شمس شرق القاهرة وحي المرج، آخر حدود القاهرة مع الدلتا، وهي أحياء لما بقي من الطبقة الوسطى وبعضها تحوّل إلى أحياء شعبية مع التدهور الاجتماعي، بينما تمركز الميسورون منهم بين المعادي والمهندسين.
هذه الموسيقى السودانية الباهرة الإيقاعات، والمقبلة على الحياة رغم ضراوتها. غنّى الفنان السوداني البديع شمت محمد نور عدداً من الأغاني التي ضجّت لها قاعة نقابة الصحافيين، وشاركه عددٌ من الفنّانين المتواجدين في القاعة بالغناء والتمثيل أحياناً، ليبدو أمامنا الغناء السوداني كمشهدٍ جماعيٍّ حميميّ، ليس حكراً على مَن يمسك الميكرفون. شاركَت القاعة الممتلئة بالألوان الفنّان شمت أغنيته المؤثّرة التي لم أجد لها نسخةً الكترونيةً مع الأسف، أغنية «أم آدام»:
ﻓﻲ ﻃﺮف اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ و زﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻟﻘﻤﺔ ﻋﻴﺶ ﺿﻨﻴﻨﺔ ﻣﻮﻳﺔ ﻣﺰاﺟﺎ اﻋﻜﺮ ﻣﻦ
ﻧﻔﺲ اﻟﻐﺒﻴﻨﺔ
ﻟﻤﺒﺔ وزﻳﺘﺎ ﻃﺎﻟﻊ اﺷﺒﺎح اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ واﻻﺣﻼم ﺳﺠﻴﻨﺔ
واﻻﻋﻴﻦ ﺣﺰﻳﻨﺔ [...]
ﻫﻜﺬﺍ ﻫﻲ اﻟﺤﺮاﺑﻪ وداره وﺑﻘﺖ ﺧﺮاﺑﻪ للأﻳﺎم ﺑﺘﺴﺄل
ﻋﻦ ﻃﻴﺒﺔ ﺳﻼﻣﻪ وﺣﻨﻴﺔ ﻛﻼﻣﻪ وﻋﻦ
ﺻﺪى ﻗﺮﻗﺮاﺑﻪ ﻗﺒﻘﺒﺖ اﻟﻤﻬﺎﻟﻚ اﻟﺠﻨﻰ ﻣﻦ ﻗﻤﻴﺼﻮ ﺧﻠﺘﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺮق ﺟﻤﻌﺘﻮ ﻣﻦ
ﺧﻤﻴﺴﻮو ﺑﺖ ﻓﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﻫﺖ ﻻ ﻛﻢ ﻻ زراﻳﺮ واﻻﺣﺰان ﺗﻘﻴﺴﻮ [...]
ﺗﻠﻚ ﻫﻲ الحرابة… تباً للحرابة... ﻣﺠﺪﺍً ﻟﻠﺴﻼم…
بدت لي بلادنا في هذا اليوم، بكل بؤسها وتناقضاتها وقسوتها، ملاذاً مدهشاً للمحرومين والمفجوعين، وبدا لي السودانيون الذين يتعرّضون لأكبر حرب وحشية، مبتهجين ومنتصرين للغناء والوجود والحب. كانت من أكثر الجمل التي سمعتها في هذا اليوم: احنا مشينا مصر على كعوبنا يا اخوانا؛ لينطبق علينا، كلمات الشاعر جمال بخيت: ازاى تكون انت وتكون عيونك غيرك، تشوف ضلام نفسك، تلمح أمل غيرك، ازاي تكون البحر، وتكون شطوط غيرك!