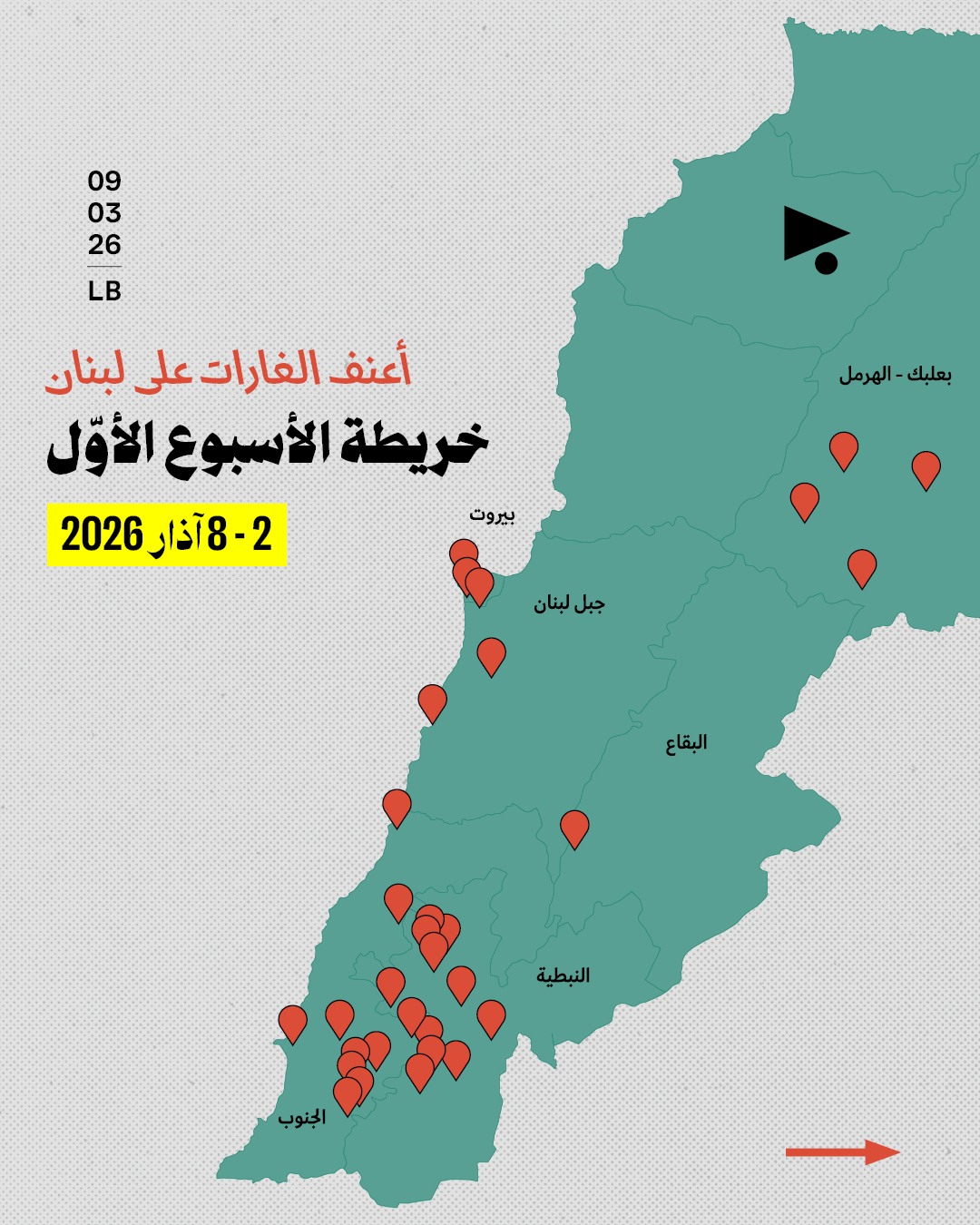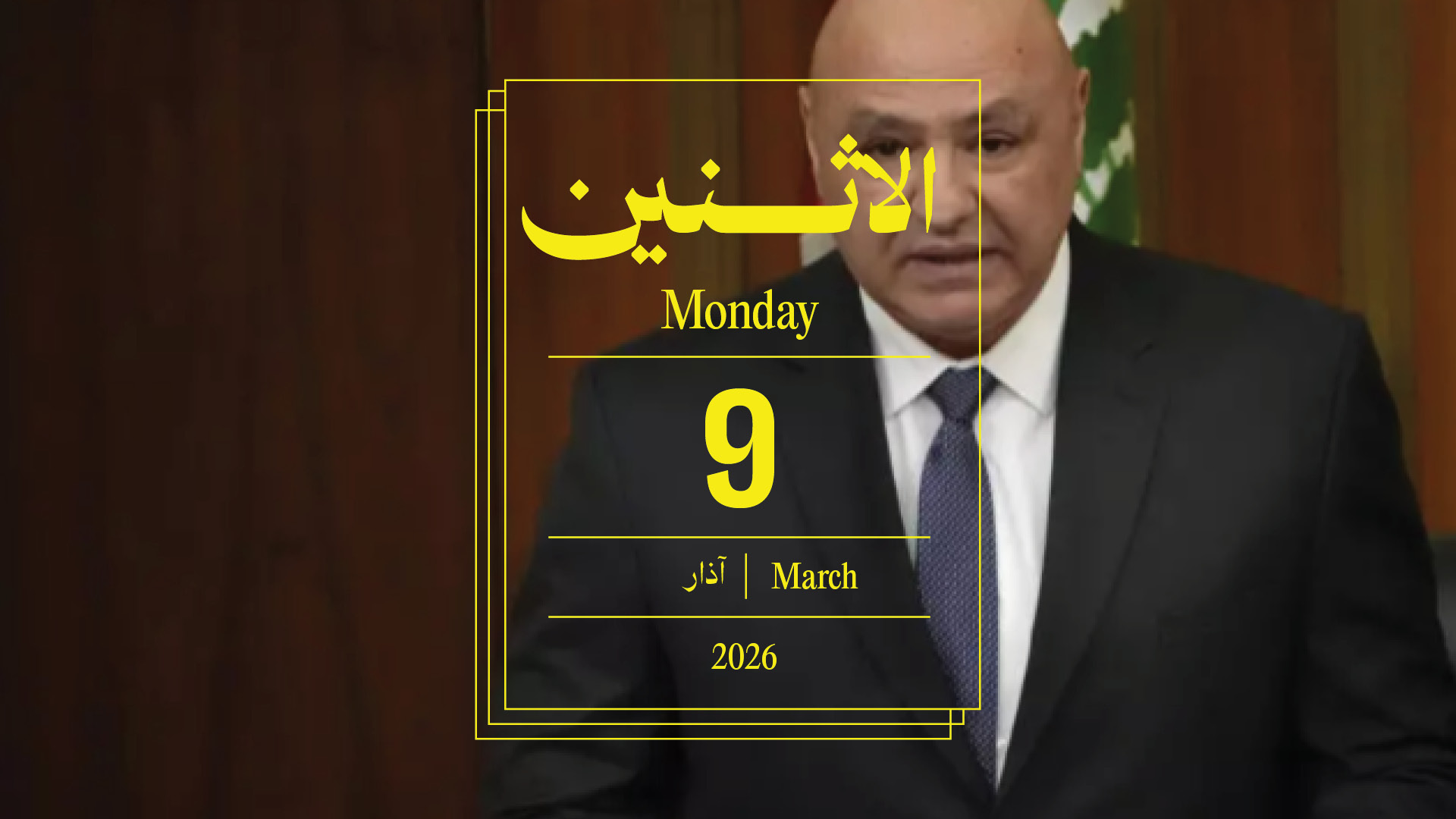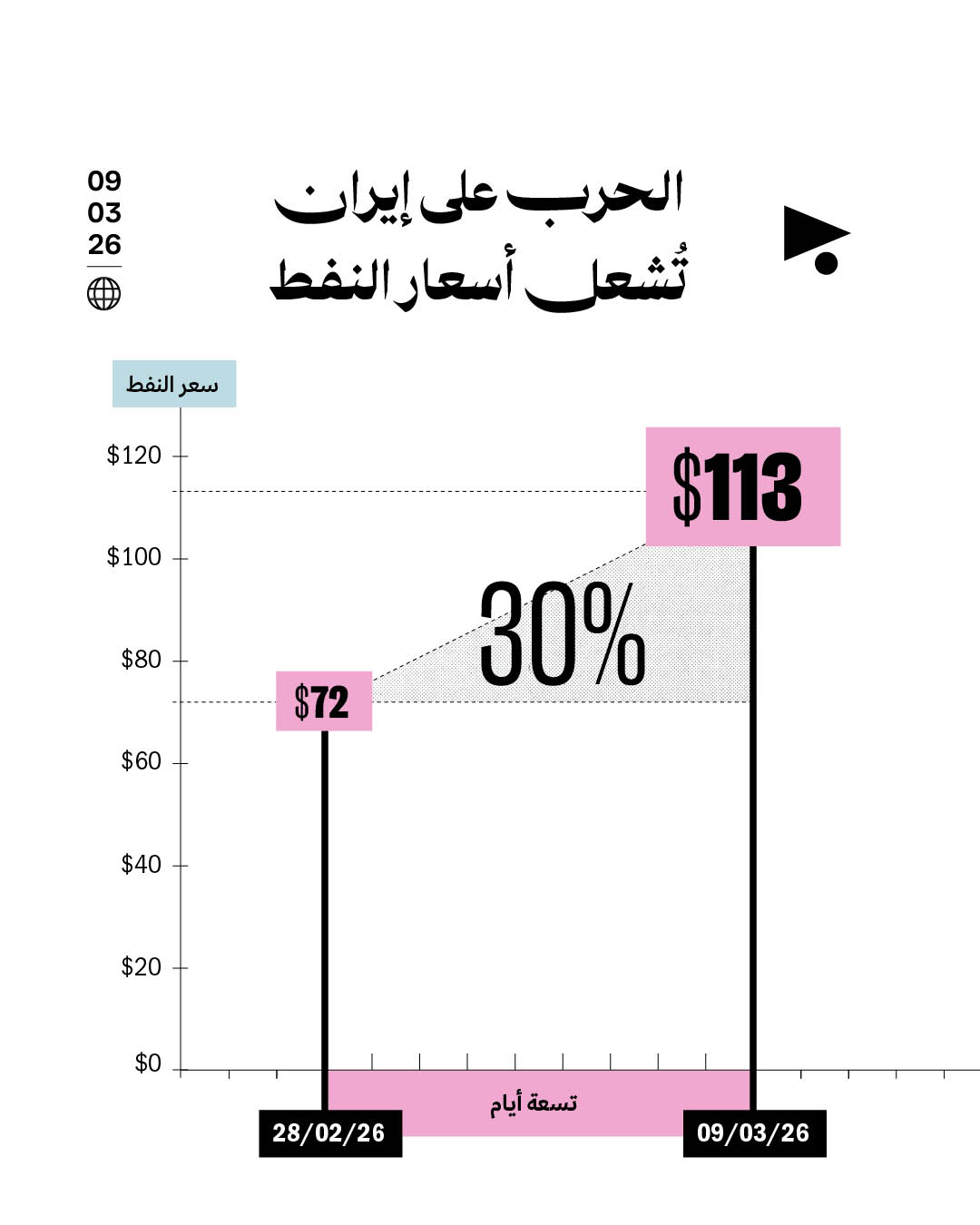مضى عام على السقوط المدوي للنظام الأسدي، ودخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» وبقية الفصائل المنضوية معها في تحالف «ردع العدوان» إلى العاصمة السورية دمشق. خلال 12 يومًا، تهاوى النظام الدكتاتوري كقصر من رمال، ودخلت قوات المعارضة القادمة من إدلب إلى كبرى المدن السورية، ابتداءً من حلب ومرورًا بحماه وحمص ووصولًا إلى اللاذقية وطرطوس.

نريد في هذه السطور أن نقرأ هذا الحدث الجلل من المنظور الإقليمي والدولي الأوسع وصولًا إلى المعادلات والتوازنات الداخلية. فسوريا الأسد انتهت، لكن سوريا الجديدة لم تولد بعد. إلى اليوم، لا تزال التسويات الإقليمية التي سمحت لهذا الزلزال الجيو-إستراتيجي الكبير أن يعبر بأقل الاضرار، مجهولةً أو غيرَ واضحة المعالم على أقلّ تقدير، سواء لجهة وقوف الحليف الروسي على الحياد، أو انسحاب الحليف الإيراني من كل مواقعه العسكرية وتبخّره بلمح البصر أو كون أول الواصلين الأجانب إلى دمشق والمهنّئين للشرع هما وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات التركيان أو كون أولى العمليات العسكرية غداة سقوط النظام هي سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية، الأكبر بتاريخ الدولة العبرية، والتي نالت الضوء الأخضر الروسي وسمحت بتدمير معظم معدّات ومعامل واسلحة الجيش السوري المتبقية، بما فيها ثكنات الساحل والأسطول الحربي السوري.
سوريا في محيطها
منذ النشأة الأولى للكيان السوري مع حكومة الأمير فيصل الهاشمية في العام 1917، وإلى يومنا هذا، لم تكن سوريا جزيرةً معزولةً عمّا حولها. فارتبط شكل واستقرار نظامها الحاكم بالتوازنات الإقليمية والتغيّرات التي طرأت في المنطقة والعالم. والولادة الأولى لهذا الكيان، جاءت في أعقاب الحرب العالمية الأولى وتفكّك الإمبراطورية العثمانية، كما أنّ نظام الانتداب الذي فُرض في العام 1920 على هذا البلد الوليد، جاء بمعزل عن رغبة الأهالي ونتيجة لاتفاقيات سايكس بيكو بين الإنكليز والفرنسيين والتسويات التي تلتها بين هاتين القوتين المنتصرتين في هذه الحرب.
ولادة الجمهورية السورية بشكلها الحالي كانت بدورها مرتبطة بنهاية الحرب العالمية الثانية وأفول نظام الانتداب والتقاء نضالات رجال الاستقلال المدعومين شعبيًا مع سعي الإنكليز لتقليص النفوذ الفرنسي في المنطقة. أما انقلاب حسني الزعيم على الحكم المدني بسوريا، في العام 1949، فأتى بدوره بعد عام على قيام دولة إسرائيل في قلب المنطقة تجسيدًا لفشل الجيوش العربية، وعلى رأسها الجيش السوري، في منع تقسيم فلسطين وتهجير سكانها.
وجاءت الوحدة بين مصر وسوريا، بدورها، تتويجًا لصعود المدّ القومي وسطوع نجم عبد الناصر وفشل العدوان الثلاثي على مصر. كما أن انقلاب 8 آذار في العام 1963 جاء في سياق التحوّلات الإقليمية التي أسقطت الملكية في العراق وأدخلت الجيوش وصغار ضباطها وأحزابهم الأيديولوجية كلاعب رئيسي في الحياة السياسية.
أما انقلاب حافظ الأسد، فجاء بعد هزيمة 1967 ووفاة عبد الناصر في العام 1970، تدشيناً للمرحلة السعودية وترسيخاً للهيمنة البترودولارية والأميركية على المنطقة، ولنشوء وازدهار مدن الملح وللأفول والخراب التدريجي الذي عمّ كلّ حواضر ومدن الهلال الخصيب بالتزامن مع ولادة المحور الإيراني ومشروعه التوسعي، بدءاً من البصرة ومروراً ببغداد والموصل وحلب وحماه وحمص وطرابلس ووصولاً إلى بيروت.
الربيع العربي
جاءت لحظة الربيع العربي التي بدأت مع حرق البوعزيزي نفسه في بلدة تونسية نائية في نهاية العام 2010، لتمتدّ الشرارة خلال شهور قليلة إلى معظم الدول العربية الوازنة شعبياً، كلحظة أمل فارقة تذكّر بالاستعصاء الديموقراطي في المنظومة العربية القائمة وبالغائب والمغيب الأكبر عن معادلة السلطة في العالم العربي، ألا وهي الشعوب العربية وحقها في الحرية والكرامة. ومن ميادين الحرية والاعتصامات السلمية و«الشعب يريد اسقاط النظام» وضرورة الاحتكام الى صندوق الاقتراع وإشراك الإسلاميين في السلطة، خرجنا إما الى أنظمة عسكرية أكثر توحُّشاً أو إلى حروب أهلية مستدامة.
كان واضحاً أنّ النظام العربي والمنظومة الإقليمية والدولية لا يريدان لهذه المنطقة لا الديمقراطية ولا الانتخابات الحرّة ولا حق الإسلاميين المعتدلين في الوجود والمشاركة السياسية ولا حق الشعوب في تقرير مصيرها، وبالأخص منها الشعب الفلسطيني، وجلّ ما يطمحان إليه هو الاستقرار القائم على الحديد والنار وعلى أنظمة شرطية على شعوبها، تقودها بالسوط ولا تقاد منها.
من هنا يمكن قراءة تردّد وحيرة النظامين الإقليمي والعربي بدايةً في استقبال التغيير في سوريا، ومن ثم فتح الأبواب الواسعة له، ليس فقط لوقوفه الحاسم في وجه النفوذ الإيراني، وهو أمر ضروري وإيجابي، ولكن لتأكيده أنه خارج سياق الربيع العربي نفسه ولحرصه على بناء منظومة حاكمة تستبعد المشروعية الشعبية القائمة على صندوق الاقتراع، وتستند في الواقع إلى شوكة القوة ومنظومة الولاء وحكم الفرد.
إسرائيل الكبرى
إسرائيل لم تغب يومًا عن هذه المعادلة الإقليمية، بل كانت في الصلب منها. فإذا وضعنا جانباً تبجُّح قادتها العنصري بأنها واحة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة والمحاطة بأنظمة قمعية وشعوب تريد فناءها، فإنّ الدولة العبرية لم تألُ جهداً منذ نشأتها، وإلى يومنا هذا، في المضي قدمًا في مشروعها التوسعي الكولونيالي، وفي إبقاء المجتمعات العربية قبل الحكومات، محرومة من امتلاك مصيرها بيدها، وبعيدة عن مصادر المعرفة والتكنولوجيا والتقدم، لتبقى فريسة للتخلف والفقر والجهل.
المشروع الإبادي في غزة والمنتقل إلى الضفة الغربية، وحرب إسرائيل على لبنان وتدميرها لمعظم القدرات العسكرية لحزب الله، وإلغاء إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك مع سوريا للعام 1974 وقصفها المستمر للأراضي السورية ودخول قواتها المتكرر إلى المناطق منزوعة السلاح والقرى السورية على أطراف الجولان المحتل، واستباحة سلاح الجو الإسرائيلي المستمر للأجواء العراقية والسورية واللبنانية… كل هذا وغيره كثير، يدل على أن إقامة إسرائيل الكبرى، لم تعد مشروعاً مستقبلياً، بل هي مشروع فاعل وقائم بجعل إسرائيل لاعباً رئيسياً وحقيقةً قائمةً على الأرض وفي الأجواء حيث تمتدّ سيطرة السلاح الجوي الإسرائيلي على كامل المنطقة بعيداً عن أي رادع عسكري أو قانوني.
لقد دخل العرب القرن العشرين، بأفكار وشعارات النهضة التي تنادي بمبدأ المواطنة وقيم المساواة وتكرّس فكرة «الدين لله والوطن للجميع»، وسرعان ما أتت الدول الاستعمارية لتجهض هذه المحاولة ولتزرع في قلب المنطقة دولةً مدجَّجةً بالسلاح والتفوّق التكنولوجي والتمييز العنصري، دولة تستند إلى المشروعية الدينية وتضرب بعرض الحائط قيَمَ المواطنة والمساواة بين جميع سكانها.
ربما يظن البعض أن السياسات الاستعمارية المستندة على منطق «فرِّقْ تسُد» والتي تنظر إلينا كقبائل وطوائف متقاتلة، باتت من مخلفات الماضي. لكن المتتبِّع للآلية التي تدار بها الأمور في منطقتنا ولتصريحات الخبراء والمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، يجد أن هذه الرؤية لا تزال حاضرة وفاعلة بقوة. فالمنطقة لم تكن ولن تكون في نظرهم مهيأة للدولة الحديثة الممثلة لكل مواطنيها والقائمة على فصل السلطات والمستندة الى المشروعية الشعبية وصندوق الاقتراع. فالعراق بات يُنظَر إليه ويُتعامَل معه كدولة شيعية في مواجهة سوريا كدولة سنية ولبنان كدولة طوائف متعددة بوجه مسيحي. وداخل كل بلد من هذه البلدان هناك ملل ومذاهب ومكونات متنازعة ومتصارعة يجب العمل دوماً على فض الاشتباكات والتناحرات فيما بينها، وإبقاء شعوبها بعيدة عن صناعة حاضرها ومستقبلها بإرادتها الحرة.
أما إسرائيل الكبرى وحلفها الإبراهيمي، فهي قائمة وحاضرة كشرطي للمنطقة، وإن خال البعض هذا التعبير بالياً من كثرة ما أسأنا واستسهلنا استخدامه. الطامة الكبرى في كل هذا، أن مجازر جبل العرب وسوء تقدير وقلة خبرة حكام سوريا الجدد، سمحت لإسرائيل أن تدخل إلى المعادلة الداخلية السورية من بابها العريض، كحامية لدروز سوريا والأقليات، لتبتز من خلال هذه الحماية سلطة دمشق، وتسعى لفرض شروط جديدة عليها تخص الجولان المحتل والمناطق منزوعة السلاح.
ماذا بعد؟

هذه التحدّيات المصيريّة التي تتجاوز مخاض ولادة وشكل سوريا الجديدة لترسم حال المنطقة بأكملها للعقود القادمة ودور سوريا فيها، هي أكبر من قدرة أي نظام سياسي حاكم على أن يواجهها بمفرده. فكيف بنظام هجين يستند في نواته الضيقة على قائد فرد وجهاز حزبي مغلق وتجربة جهادية عسكرية وعلى فكر إسلامي سلفي معادٍ للديموقراطية وكاره للأقليات. نظامٌ كهذا لم يكن ولن يكون صالحاً ولا قادراً على حكم سوريا ومواجهة التحديات الكبرى التي تنتظرها.
إن إعادة النظر بالإعلان الدستوري والمشاركة السياسية وإقامة دولة القانون والمؤسسات والمواطنة وفصل السلطات والاستناد إلى المشروعية الشعبية الآتية من صندوق الاقتراع وانتخاب مجلس تأسيسي يقرّ دستوراً جديداً للبلاد ويحدّد شكل الحكم، هذه الخطوات لم تعد ترفًا أو لزوم ما لا يلزم، بل هي المدخل الضروري واللازم لعبور المرحلة الحالية وجبر الضرر وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين، القدامى منهم والجدد، ولمواجهة الاستحقاقات المصيرية الكبرى التي تنتظر سوريا وشعبها.