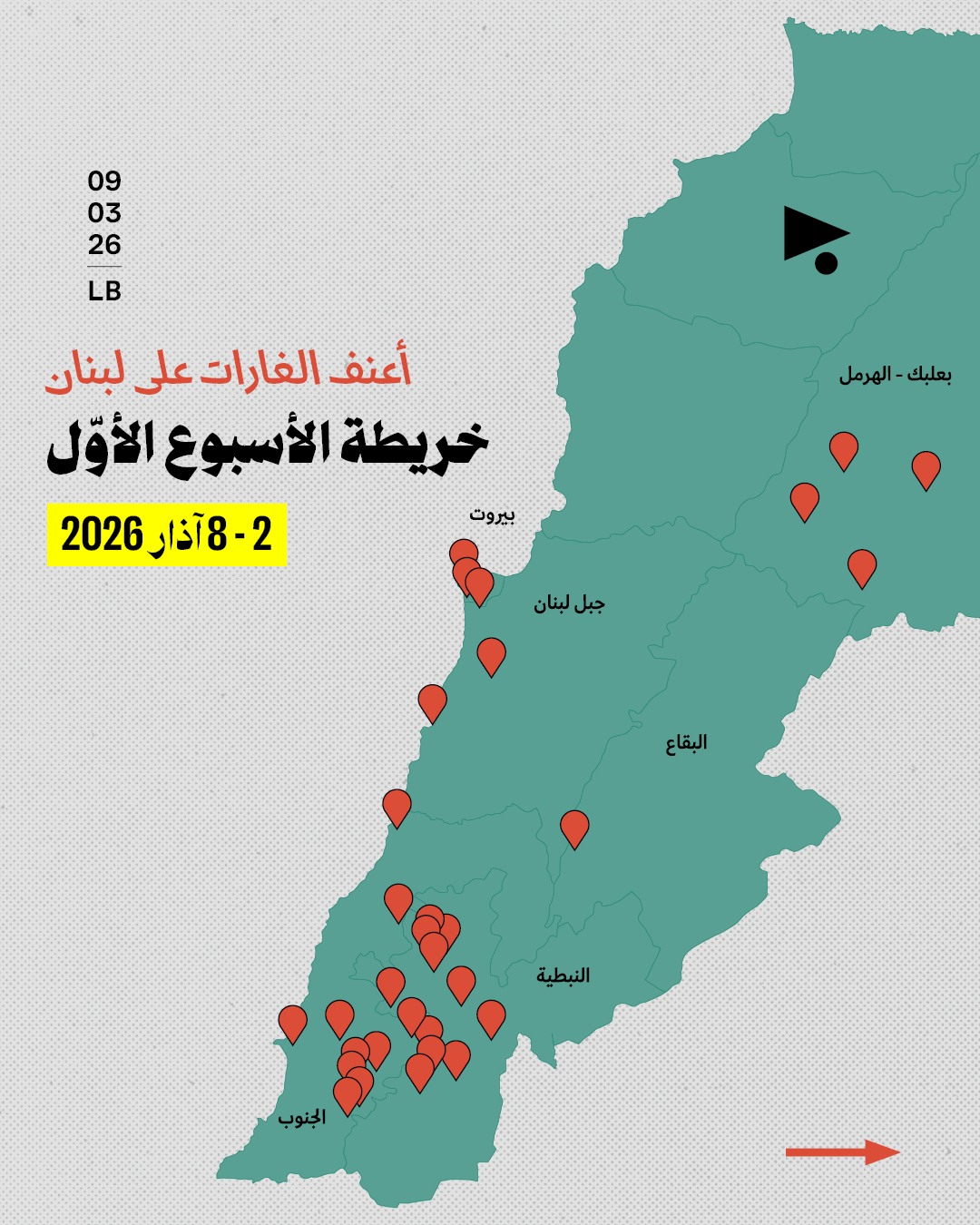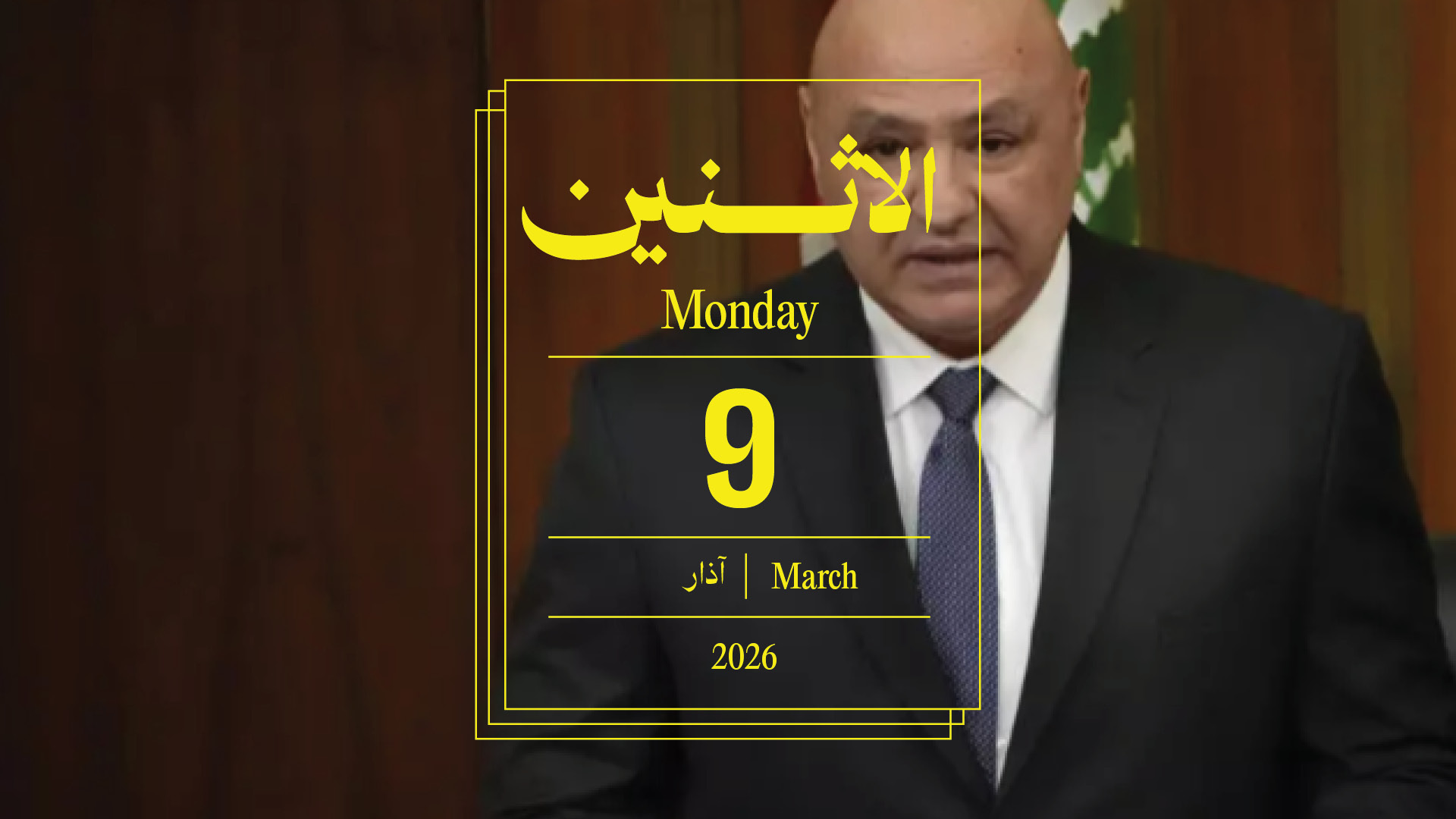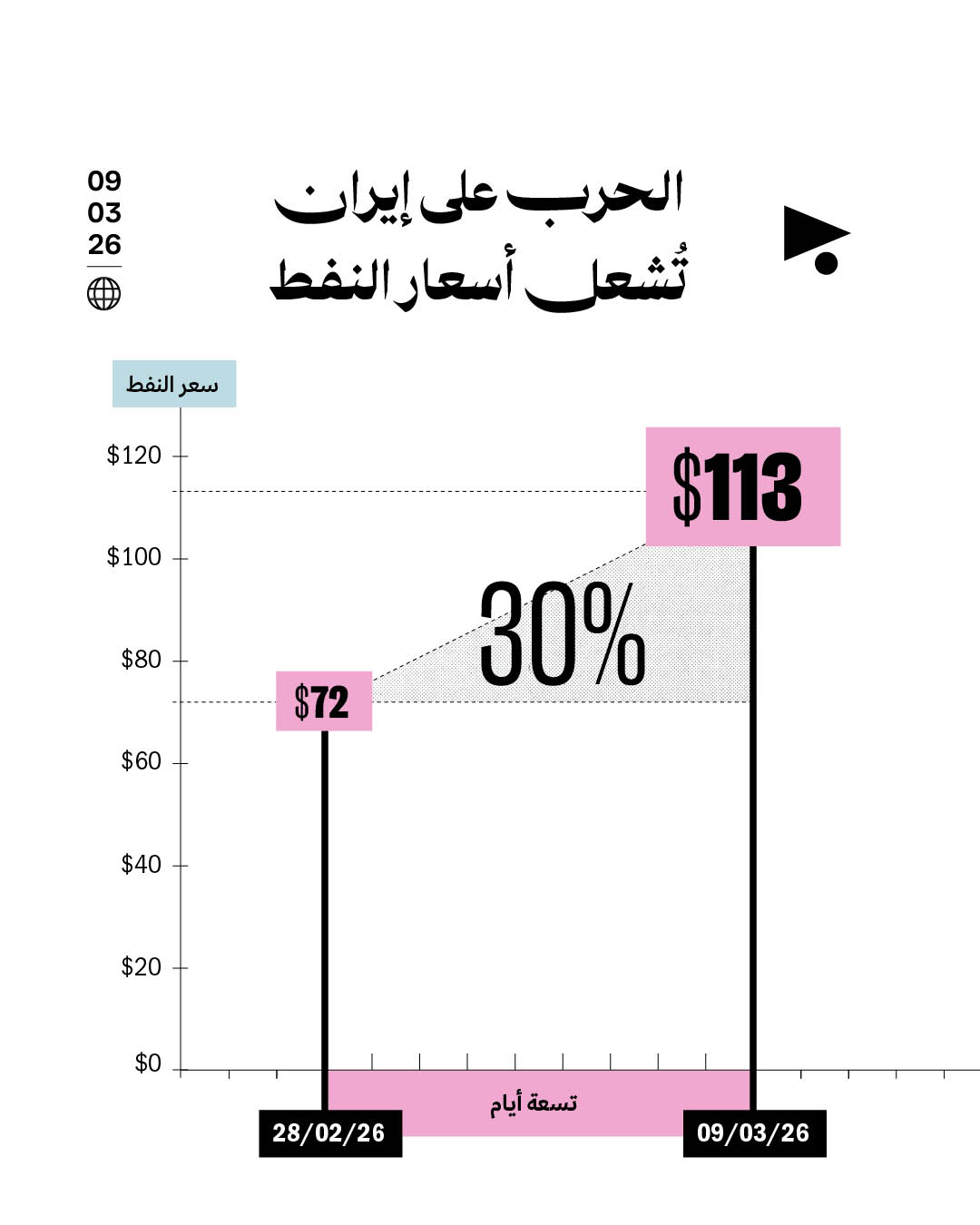في العام 2024، أطلقت صانعة الأفلام الوثائقية اللبنانية فرح قاسم فيلمها الوثائقي بعنوان «نحن في الداخل» الذي عُرض في أكثر من أربعين مهرجاناً حول العالم وحصد 22 جائزة، من أبرزها «تنويه خاص» في مهرجان «شاشات الواقع» و«نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي» في مهرجان الجونة السينمائي، كذلك «الجائزة الكبرى نانوك» في مهرجان «جان روش» الدولي للأفلام الوثائقية وجائزة «أستور بيازولا لأفضل فيلم» في مهرجان «مار ديل بلاتا».

في هذا الفيلم، تنعكف فرح على إيجاد لغة مشتركة للتواصل مع أبيها الشاعر من خلال كتابة القصائد، مسائلةً علاقتها بمدينة طرابلس، مسقط رأسها، بعد غياب دام 15 سنة. لقد اختارت فرح أن تقضي أيامها الأخيرة مع أبيها من خلال وسيطين فنّيين هما الوثائقي والشعر، أي لغتها ولغته، من أجل الاقتراب من أبيها في حضوره وتخليد ذكراه في غيابه، واضعةً بحنكة الأبديَّ واليوميَّ على قدم المساواة. فنراها تخرج من الإطار لتراقب حياة أبيها اليومية لتعود وتتفاعل معه داخل الإطار.
في هذا الحوار، تغوص فرح في طيّات فيلمها «نحن في الداخل»، كما تتحدث عن عملها كصانعة أفلام وثائقية، المرتبط ارتباطاً جوهرياً بعلاقاتها الخاصة مع الأشخاص والأمكنة.
إعلان فيلم «نحن في الداخل» (2024)
عن الأفلام الوثائقية وتعدُّد أبعاد الشخصية
سيرين: أشعر أن الأفلام الوثائقية غالباً ما تسلك مسارات غير مخطَّط لها. صحيح أنّ المخرجين ينطلقون من فكرة معيّنة لكننا نلاحظ أن الواقع يغلبهم في الكثير من الأحيان. في بعض الحالات، قد تُبنى الأفلام الوثائقية بالكامل على سلسلة من الصدف الخارجة عن النص. ربما لأن الوثائقي يعانق الحياة أكثر من الأنواع السينمائية الأخرى. لذلك لديّ فضول في معرفة كيف تَعامل والدُكِ مع وجود الكاميرا في يومياتكما؟ هل لمستِ أيّ تغيّر في تصرّفاته؟
فرح: تماماً. الصدف هي التي تسمح بتكوين صورة عن أشخاص أو حالات معيّنة. أنا مهووسة بالمقاربة الشاملة، لهذا السبب أسعى دائماً إلى إبراز جميع أوجه وحالات شخص معيّن، أي جميع الأبعاد التي يجسّدها. إن تعدّد الأبعاد هو عملياً جزء لا يتجزأ من تكوين الفكرة. عندما نولي اهتماماً لجميع أبعاد الشخصية، نكتشف أن هذه الأبعاد تكمّل بعضها. في هذا الفيلم، تعمّدتُ إعطاء جميع أبعاد شخصية أبي حقها، من الصلاة إلى الكتابة عن الخمر، ومن العزلة إلى الحياة الاجتماعية الصاخبة، وكذلك اهتمامه بما يحصل في الخارج رغم أنّ زمانه ولّى. قد يسلّط مشهد معيّن الضوء على شقّ من شخصيته فيما يسلّط مشهد آخر الضوء على الشق المعاكس. كان هاجسي ألا أقضي على فرادة شخصيته. وأظن أن الصدفة هي التي تسمح بإظهار مختلف هذه الفروقات الصغيرة. الصدفة هي التي تُظهر كافة تجليات الشخصية. هذا ليس فيلمي الأوّل مع والدي، فقد كانت لي معه تجربتان من قبل، أوّلهما في «أبي يشبه عبد الناصر» الذي صوّرته في العام 2012 وكان طريقة للتحدث عن الموت في اليومي وأعني بذلك وفاة والدتي، وكذلك العودة بالزمن لتوديع من فقدناه. وكان هذا الفيلم أمراً حيوياً بالنسبة لي ولوالدي لأننا كنّا عاجزين عن التحدث عن الفقدان. أما ثاني فيلم، فلم أعرضه بعد. وبالتالي، لقد اعتاد أبي وجود الكاميرا، فنحن لا نترسّم أمام الكاميرا بل نعتبر التصوير نشاطاً نقوم به سوياً، بمعنى أننا نلجأ إلى الكاميرا للتحدث عن مواضيع نتجنّبها من شدة الألم أو لمجرد أننا نعلم أنّها محطّ خلاف بيننا.
سيرين: إن التعامل مع عملية التصوير كوسيلة للتنفيس الوجداني (catharsis) بغية التخلّص من المشاعر السلبية حتماً يجعل الفيلم أقرب إلى الواقع ممّا هو إلى العمل الروائي، لكن على الرغم من ذلك، أنا من الأشخاص الذين يؤمنون أن الكاميرا تستنبط أموراً فينا ما كانت لتخرج ربّما في غيابها، حتى وإن كنّا حقيقيين إلى أقصى الحدود. ليس بمعنى أن الكاميرا تجعل تصرفاتنا مصطنعة بالضرورة، بل بمعنى أنها تعزز إدراكنا الذاتي كما تجعلنا نعيش اللحظة بطريقةٍ مختلفةٍ، ألا تشاطرينني الرأي؟
فرح: نعم، أوافقكِ وبشدّة. إن اعتبار أن الكاميرا ليست موجودة ولا تؤثر على الشخصيات فيه شيء من السذاجة، بل ينمّ عن كذب وتلفيق بالنسبة لي. فكيف يمكننا أن نتجاهل الكاميرا بحضور فريق عمل كامل متكامل على موقع التصوير؟ على العكس، يجب الإعتراف أن الكاميرا لها تأثير، وتأثيرها على الشخص هو ردة فعل طبيعية. إن تحوّل الإنسان إلى شخصية أمام الكاميرا هو انعكاس لأحد جوانب شخصيته. وأنا أحرص دائماً على تعزيز هكذا نوع من التفاعل بدلاً من طمسه لأنه يشكّل ثراءً كبيراً للعمل.
سيرين: تماماً، تتمتع الكاميرا بالقدرة على كشف المستور بمعنى أنها تفضح ما لا تراه العين أحياناً. في هذا الإطار، يتحدث بيل نيكولز عن ستّة أنماط أساسية لصناعة الوثائقي، نذكر منها النمط الرصدي والنمط التشاركي: يقوم النمط الرصدي، وهو وريث سينما الحقيقة (Cinéma vérité) والسينما المباشرة (Direct cinema)، على التفاعل المباشر مع حياة الشخصيات اليومية من دون تدخل من قبل المخرج، فيما يقوم النمط التشاركي على التفاعل بين صانع الفيلم والشخصية من خلال مقابلات أو أشكال أخرى من الانخراط المباشر، بدءاً من المحادثة وصولاً إلى الاستفزاز. بيل نيكولز، «مقدمة عن الأفلام الوثائقية» (2001). ويتميّز هذا النوع من التفاعل بإبراز حقائق جديدة عن الشخصيات ما كانت لتظهر من دونه. بما أن فيلمك الوثائقي يدمج ما بين هذين النمطين، ما هي الحقائق الجديدة التي اكتشفتها عن أبيك أثناء التصوير؟
فرح: لم اكتشف اموراً جديدةً فعلياً ولكنني اكتشفت لاحقاً أنني كنت أصوّر هذا الفيلم لأبقي أبي على قيد الحياة. كان هدفي أن أُشرِكه في صناعة هذا الفيلم. فأبي يشعر أنه ينبض بالحياة طالما أنه منهمك في مشروع ما. وكان يعلم كل ذلك لكنه لم يبح إلا في النهاية. لم ألاحظ أنه متيقظ للوضع كما أنني لم أعرف أي منحى سيتخذ هذا العمل، ولهذا السبب استمرّ التصوير أربع سنوات. لم أرد لهذا التصوير أن ينتهي لأنّني كنت أعلم أن أبي قد يرحل مع انتهاء التصوير. أظن أنه كان سعيدًا بأن هذا الوثائقي سيبقى بعد رحيله. وكانت لديه آراء في ما يريد أن يحتفظ به وما يريد أن يحذفه، حتى أنه كان يقرر أي جانب من جوانب شخصيته يريد أن يبرز في هذا المشهد أو ذاك لأنه كان يعلم تماماً أن هذا الوثائقي سيخلد ذكراه. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي: يجب أن يكون الشخص الذي أصوّره على دراية كاملة بالعقد القائم بيننا، لذلك يصعب عليّ تصوير أشخاص أو أماكن أجهلها أو لا يربطني بها شيء. واللافت أنّه مع مرور الوقت، استسلم أبي كليّاً أمام تقلبات الحياة في حلوها ومرّها، فانعكست حالة الاستسلام هذه أمام الكاميرا.
سيرين: يستشهد بيل نيكولز في كتابه الشهير «مقدمة عن الأفلام الوثائقية» بصانع الأفلام الوثائقية الرائد جون جريرسون الذي ابتكر مصطلح «دوكيومنتري» (الوثائقي) بالإنجليزية وعرّفه على أنه «معالجة الواقع بطريقة إبداعية». استناداً إلى هذا التعريف، يعتبر نيكولز أنّ الوثائقي يجمع ما بين الإبداع، أي حرية الروائي، والواقع، أي المسؤولية الصحافية والتاريخية، وبالتالي فإن الوثائقي ليس اختراعاً ولا إعادة إنتاج للواقع، بل إنه ينطلق من الواقع التاريخي لينقله من منظوره الخاص. ما هي نقطة الانطلاق أو مصادر الإلهام وراء فيلم «نحن في الداخل»؟

فرح: كان هذا الفيلم أشبه بمشروع مشترك بيني وبين أبي. أردت أن أدخل إلى عالمه الشعري الذي لطالما تجاهلته، لأنني كنت أشعر أنّ النهاية وشيكة وأنّ هذا الفيلم فرصتي الأخيرة لأفهم عالمه وانشغالاته. لكن بصورة عامة، غالباً ما أنطلق في أفلامي من حالة عدم تقبّل أو عدم فهم لوضع أو شعور معيّن، عندها أسخّر المساحة التصويرية للتعامل مع هذه الحالات والمشاعر التي تطاردني. علاوةً على ذلك، يشكّل الشعور بالنشوة الذي ينتابني إبّان التصوير لأنني أعيش اللحظة وأستسلم لها أحد مصادر إلهامي الرئيسية. وأدركت مع الوقت أهمية حالة الاستسلام، فأصبحتْ هي المبدأ التوجيهي في أفلامي، بل غدت نقطة انطلاقي. أحياناً قد يبدو تصوير فيلم مسألة حياة أو موت بنظري. إن عرفت الصيغة النهائية للفيلم منذ البداية، فلن أتوق لتصويره. أحبّ متى يؤدي القدر دوره في صناعة الوثائقي. أحسب نفسي أقول له «إليك اقتراحي، ماذا يمكن أن يحدث الآن؟». هذه هي باختصار العناصر التي أستلهم منها أعمالي.
سيرين: أين تتموضعين بين مجموعة صانعات الأفلام الوثائقية اللبنانيات أمثال جوسلين صعب ورندة الشهال صباغ وجوانا حاجي توما وإليان الراهب ورانيا ستيفان. هل تشعرين بأي نوع من الارتباط مع أولئك المخرجات؟
فرح: لم يراودني هذا السؤال من قبل، وربما عليّ التفكير فيه ملياً في يوم من الأيام. لكن للإجابة على سؤالك، ما أحبّه في أفلام إليان الراهب وأعتقد أنه موجود في أفلامي أيضاً هو استخدام المساحة التصويرية للقيام بنوع من التفاوض بين منظورنا لليوتوبيا أو الهتروتوبيا والواقع. فيصبح العمل على المساحة الداخلية جزءاً من التفاوض مع المكان، إذ نتوق لمعرفة ما هي حدود مكاننا وإلى أي مدى ننتمي إلى المكان العام، إلى آخره. لا يخفى على أحد أن علاقتنا مع المكان العام مضطربة جداً، لذلك يصعب تحديد مفهوم الحميمية، أي ما يُشارك منها وما لا يُشارك كذلك وما يقع داخل المنزل وما يقع خارجه… إذاً، التفاوض مع المكان أو مع اللحظة أو الشخص هو القاسم المشترك الذي أجده في سينما إليان كما أجده عند العديد من الأسماء التي ذكرتِها بمجرد أنهنّ حوّلن المساحة التصويرية إلى مساحة تفاوض.
عن شبح الموت والأماكن المألوفة
سيرين: من الواضح أنّ نظرتك لصناعة الأفلام تتخطى كشف الواقع، لتصبوَ إلى إدامته وإطالة حياة من تحبّين، لكن ما الذي يشدّك إلى الأماكن المألوفة ويُبعدك عن الأماكن المجهولة كصانعة أفلام وثائقية؟
فرح: ما يشدّني إلى الأماكن المألوفة هو مفهوم الموضعيَّة، أي أهمية الاستيعاب أو امتلاك ما يكفي من المعرفة المجسّدة لرواية قصص معيّنة. وإن لم أحظَ بالمعلومات الكافية، جعلتُ هذا النقص جزءاً من الفيلم. أرى أنّ وسيط الوثائقي يُحتّم استمرار العلاقة مع مواضيع التصوير ما بعد الفيلم، لأن الفيلم الوثائقي ينتمي إلى أزمنة مختلفة والعلاقات التي تُبنى مع الشخصيات من خلاله تواصل تطوّرها حكماً. مثلاً، لا أتخيّل نفسي أصوّر فيلماً في مكان ما من دون العودة إليه بعد انتهاء التصوير. أعرف أنّ بعض المخرجين يصوّرون في أماكن ومن ثمّ ينسونها كأنها لم تكن، لكن بالنسبة لي، الاستمرارية أساسية لأن الفيلم يأتي كجزء من علاقة مطوّلة مع الأماكن أو الأشخاص. وفي النهاية، سيُختتم الفيلم، لكن هذه العلاقات ستدوم، بل سيحدّد الفيلم معالمها في المستقبل نظراً للترابط الواضح بين الأفلام والحياة الواقعية.

سيرين: شعرت أنّ الفيلم بلغ ذروته عندما انكشف كل شيء في الحوار الأخير الذي جمعك بوالدك. وكأنه يختصر جوهر الفيلم ونهايته الأليمة. لم أستطع أن أحبس دموعي عندما اكتشفت أن والدك متيقّن تماماً ممّا يجول في بالك والنهاية التي تنتظره. يقول جاك دريدا إن السينما هي فن الأشباح، وكذا نستشفّ من هذا الحديث الختامي أنّ أباكِ مدرك تمام الإدراك أنه قد تحوّل إلي شبح. كانت شفافيته في تلك اللحظة موجعة، خاصةً أنّ هذا الحوار يمكن أن يحدث مع كلٍّ منّا. كيف تقيّمين هذا الحديث الأخير الذي دار بينكما؟ ولوعاد بكِ الزمن، هل من أشياء تعيدين النظر فيها أو مواضيع أخرى تثيرينها؟
فرح: في بادئ الأمر، لم أتقبّل فكرة أنه الحديث الأخير لأنني لم أدرك أنه فعلاً سيكون حديثنا الأخير. لكن بالنظر إلى الوراء، أشعر أنّ الفيلم بكامله هو حديثي الأخير مع أبي. أمّا المشهد الأخير الذي يجمعنا في الفيلم، فهو المشهد الأخير الذي صوّرته معه. شعرت عندها أنني استنفدت طاقته فقرّرت التوقف عن التصوير حالاً. أحسستُ بذنبٍ شديدٍ عندما فهمت أنّه يعرف بالضبط ما يدور في بالي وكأنّه كشف لعبتي، لذلك أوجعَه هذا الحديث. وقتَها قلت لنفسي أنني لن أصوّر أبي بعد اليوم. لا أظن أن هناك أسئلة لم أطرحها على أبي لأنني أمضيت عمري أطرح عليه الكثير من الاسئلة، ولكن ما من إجابة تشفي غليل الفقدان في نهاية المطاف. ليس بوسعنا إلا أن نتعايش مع الغياب. إنّ مفهوم الوقت الذي يتحدث عنه أبي في هذا المشهد مؤثّر جداً بالنسبة لي، لأنه أعطاني وصفة سحرية أحتفظ بها حتى اليوم، خاصة عندما قال إنّ الحياة عبارة عن 60% ماضٍ و10% حاضر و30% مستقبل. قوله إنّ النسيان جزء من الذاكرة يواسيني أيضاً. حتى أنني استخدمت مفهومه للوقت في الفيلم بعد هذا المشهد بحيث يتبدّل تسلسل الأحداث بعد وفاته. في الواقع، تعتبر بعض الحضارات أنّ الماضي هو الأساس، هو الأرشيف، وهو بحد ذاته المستقبل لأنّ المستقبل فكرة غير ملموسة وبعيدة المنال. لذلك، كثيراً ما أعود إلى هذا التخبّط الزمني وأتماهى معه في حياتي. أعتقد أنّ آخر هدية قدّمها لي أبي، هي أنه جعلني أعيد النظر في مفهومي للوقت. فأبي له حدث خاص مع الوقت: لقد عرف متى وصل الفيلم إلى نهايته، تماماً كما كان يعرف متى تصل القصيدة إلى ختامها.
عن السياسة والأهل وطرابلس
سيرين: لطالما شكّلت الحروب والظلم والنزاعات السياسية في منطقتنا أرضاً خصبةً للأفلام الوثائقية. في القرن الماضي، برز المخرج عمر أميرلاي في سوريا كأحد أهمّ رواد سينما المؤلف الوثائقية التي تتقاطع مع النشاطية السياسية. أمّا في التاريخ الأقرب، فقد ولّد الربيع العربي عدداً ملحوظاً من الأفلام الوثائقية ذات الطابع السياسي، نظراً لوجود رغبة بتوثيق هذه الفورات الشعبية وتداعياتها عند الجيل الجديد من صنّاع الأفلام، الذين استعانوا بالكثير من الأحيان بهواتفهم الذكية لنقل الصورة من قلب الميدان. واللافت في هذه الثورات كان تسخير منصات كيوتيوب وفيسبوك وتويتر بشكل غير مسبوق من أجل مشاركة الفيديوهات مباشرةً وموافاة المتظاهرين والرأي العام بآخر التطورات بعيداً عن الرقابة. أصبحت عندها الهواتف أداةً لتوثيق مجريات الأحداث وعنف الشرطة وانتهاكات حقوق الإنسان التي سُجِّلت في خضمّ هذه الحراكات، مما أفرز موجة من الأفلام الوثائقيّة الملتزمة سياسياً. ولا يزال المخرجون والمخرجات العرب متمسكين حتى اللحظة بالعدسة السياسية عند تناول مواضيع شائعة مثل البيئة والهجرة والهوية وحقوق الإنسان، لا سيّما في ظل تركيز الجهات التمويلية وقنوات التوزيع على ثيمات سياسية محدّدة.
لكن بالتوازي مع تيار الأفلام الوثائقيّة السياسية، هناك ثيمة تزداد انتشاراً في الآونة الأخيرة في الأفلام الوثائقية العربية، وهي العائلة والعلاقة بالأهل. نذكر، على سبيل المثال، فيلم «أبي ما زال شيوعياً» للمخرج أحمد غصين وفيلم «يامو» للمخرج رامي نحاوي وفيلم «إبراهيم» للمخرجة لينا العبد وفيلم «أمّك» للمخرجة سميرة المزغباتي وفيلم «رسائل من الكويت» للمخرج كريم غوري والكثير غيرها. هل تعتبرين أن العائلة تحدّد شكل الوثائقي العربي في عصرنا هذا؟
فرح: لا يمكنني أن أجزم لأنني لا أملك المعطيات الكافية. لكن بالنسبة لي، لا يتعلق الأمر بالنوع السينمائي بقدر ما يتعلق بما يحاول المخرجون والمخرجات أن يرونه من خلال هذه العلاقات. فمحور فيلمي، على سبيل المثال، هو فكرة العام والخاص أو الخاص المُسيّس، التي تملي علاقتي بالمكان وبكافة أشكال السلطة، خصوصاً أنني وُلدت في مدينة مهمّشة ومتروكة، لذا فإنّ علاقتي بالشأن العام لطالما مرّت بالعائلة وبالمجتمعات من حولنا. لقد حدّد هذا الرابط بين العام والخاص آرائي السياسية كذلك، وتفاعلي مع مفهوم الوطن والمواطنة. ولطالما سكنتْ هذه الأحاديث التي وثّقتُها في «نحن في الداخل» وجداني لأنّها متأصّلة بنشأتي في كنف عائلة طرابلسية. وهي أساساً تنتمي إلى سلسلة الأحاديث التي تستمر مع الوالدين حتى بعد غيابهما. بمعنى آخر، علاقتي مع مفهوم المدينة أفرزت علاقتي المزعزعة بالسلطة. في الواقع، تؤسّس الروابط العائلية لفهم أوسع لعلاقة الفرد بالمدينة والسلطة، لذلك يدور الفيلم حول فكرة الخارج والداخل. في لبنان، لا يشعر الأفراد بحسّ الانتماء إلى المكان العام لأن معظم الأماكن خاصة، غير أن ثورة 2019 جعلت الداخل يتجلى إلى الخارج وسمحت بنوع من الأخذ والعطاء بين المكانين. لم يتسنَّ لي أن أقف في ساحة النور إلى جانب شبّان وشابات من باب التبانة والمعرض وحشود من كافة الطبقات الاجتماعية قبل العام 2019، لأن مفهوم المكان العام كان مقتصراً وقتها على أماكن محدّدة مثل السوق والكورنيش والمقاهي، ثم أتت الثورة لتخلق لحظة اتحاد سياسي داخل هذه الأماكن العامة. لذا تبدّلت علاقتنا بالمكان العام رأساً على عقب لأننا استعدناه على طريقتنا في العام 2019. وهكذا أصبحت ساحة النور بعد الثورة رمزاً لإمكانية التلاقي السياسي في المكان العام.

لقطة من فيلم «نحن في الداخل» (2024) للمخرجة فرح قاسم، بإذن من المخرجة
سيرين: بالفعل، يوثّق «نحن في الداخل» الفعاليات والحشود الغفيرة التي شهدتها ساحة النور خلال ثورة 17 تشرين. رأينا والدك مُسمّراً أمام التلفاز لمتابعة التغطية الإعلامية وفي عيونه لمحة من التفاؤل. ما كان رأي والدك في هذه الثورة؟ هل يعتبر أنها ساهمت في تحقيق المطالب أم خيّبت آمالنا جميعاً؟
فرح: في بادئ الأمر، كان أبي متحمّساً للثورة، لكن عندما رأى المنحى الذي اتخذته الأحداث خاب ظنّه، إذ كان يعوّل على تعويض الموظف الحكومي. لقد عمل أبي جاهداً طوال حياته ليعيل نفسه في فترة التقاعد لكنه لم يكن يدري أن تعويضه سيخسر قيمته على هذا النحو. أظنّ أن تدهور الثورة لم يخيّب آماله وحسب، بل خيّب آمال جيل بأكمله آمن بفكرة بناء الدولة. كان أبي شخصاً نزيهاً، لم يلجأ يوماً إلى وزير أو نائب أو أيّ حزب من الأحزاب، على الرغم من فكره السياسي والأيديولوجي الواضح. لطالما آمن بفكرة مشروع الدولة، فكان تدهور هذه الانتفاضة القشّة التي قصمت ظهر البعير.
سيرين: لقد شهدنا في السياق اللبناني العديد من الأفلام الوثائقية ذات الطابع السياسي في أعقاب الحرب الأهلية وحرب تموز وانفجار المرفأ وثورة 17 تشرين. والجدير بالذكر أنّ معظم هذه الأفلام تتمحور إمّا حول بيروت أو الجنوب اللبناني. يُعتبر «نحن في الداخل» من الأفلام المعدودة التي وثّقت ثورة 17 تشرين في طرابلس. والأكثر من ذلك، يتراءى لنا منذ بزوغ السينما اللبنانية أن طرابلس لا تحظى إلا بتمثيل خجول في صالات العرض وكأنّ المخرجين لا يكترثون إلى أهميتها الثقافية وثراء تاريخها ولا يولون اهتماماً للقصص النابعة من داخلها، رغم تفاخر اللبنانيين علناً بعاصمة الشمال. على الصعيد الشخصي، جُلّ ما أعرفه عن سينما طرابلس هو أفلام رندا الشهال صباغ ورائد ورانيا الرافعي. هل كان أحد أهدافك تخصيص مكانة لطرابلس في السينما اللبنانية من خلال هذا الفيلم؟ استوقفتني أيضاً اللهجة الطرابلسية في الحوار، فنحن قليلاً ما نسمع لهجات غير اللهجة البيروتية السائدة في الإنتاجات السينمائية المحليّة. ما الأهمية التي تكتسيها اللهجة الطرابلسية التي لا يعهدها المشاهد اللبناني في فيلمك الوثائقي؟
فرح: بالطبع، هذا الفيلم محاولة تندرج في إطار التصدّي لمركزية بيروت في السينما، فأنا لم أصنع فيلماً على مقياس أهالي بيروت، بل صنعته من أجل أهالي طرابلس مدينتي. صنعت فيلماً يمكننا التماهي معه في أدق التفاصيل، ولعل اللهجة من أبرز عناصر هذا التماهي، ان لم تكن أهمها، إذ تشكّل حيّزاً أساسياً من الهوية الطرابلسية. أتذكّر ما قاله لي أحد المشاهدين بعد عرض الفيلم في طرابلس: هيدي أوّل مرّة بشوف حدا بيحكي متلي على الشاشة الكبيرة. على الصعيد الشخصي، لقد شكّلت لهجتي محطّ استهزاء في الجامعة عندما ذهبت إلى بيروت لإكمال دراستي، فعدّلتها، ثم قاطعت اللغة الفرنسية التي تعلّمتها منذ نعومة أظفاري لأعيد صياغة علاقتي بها لاحقاً. في أعقاب الثورة السورية في العام 2011، أصبح تركيزي على اللغة العربية العاميّة والفصحى مع قدوم بعض الأصدقاء السوريين إلى لبنان قبيل الرحيل الى أوروبا. وبالتالي، لقد سافرت لغتي كثيراً بين طرابلس وبيروت قبل أن تتبدّل مع قدوم أصدقائي السوريين، كذلك تطوّرت لهجتي مع الأحداث التي شهدتها المنطقة. أمّا اليوم، فأنا متصالحة تماماً معها، وقد كان من البديهي أن تأخذ مكانها في هذا الفيلم عن طرابلس، إدراكاً منّي لأهمية اللامركزية، بمعنى أهمية خروج السينما اللبنانية من بيروت.