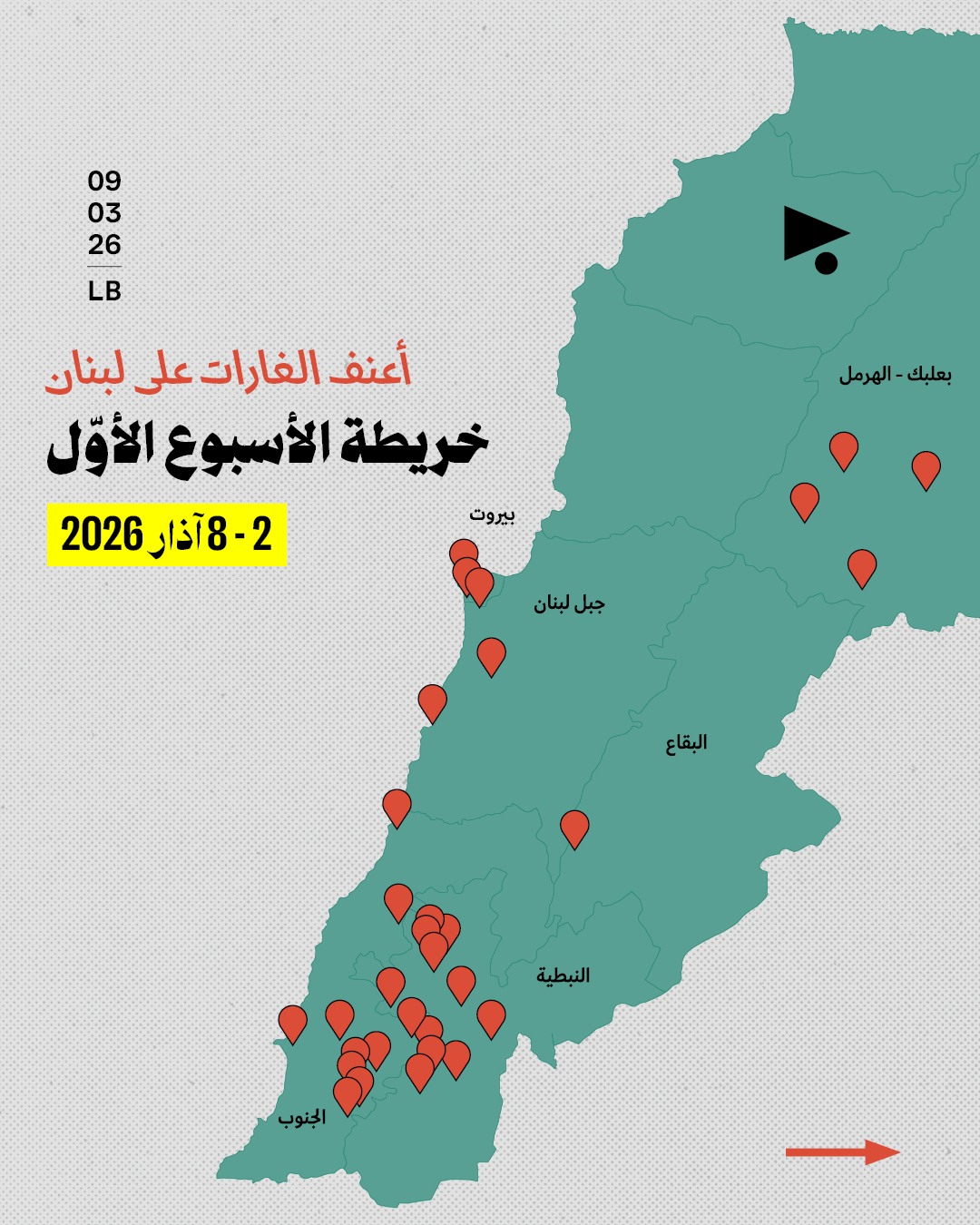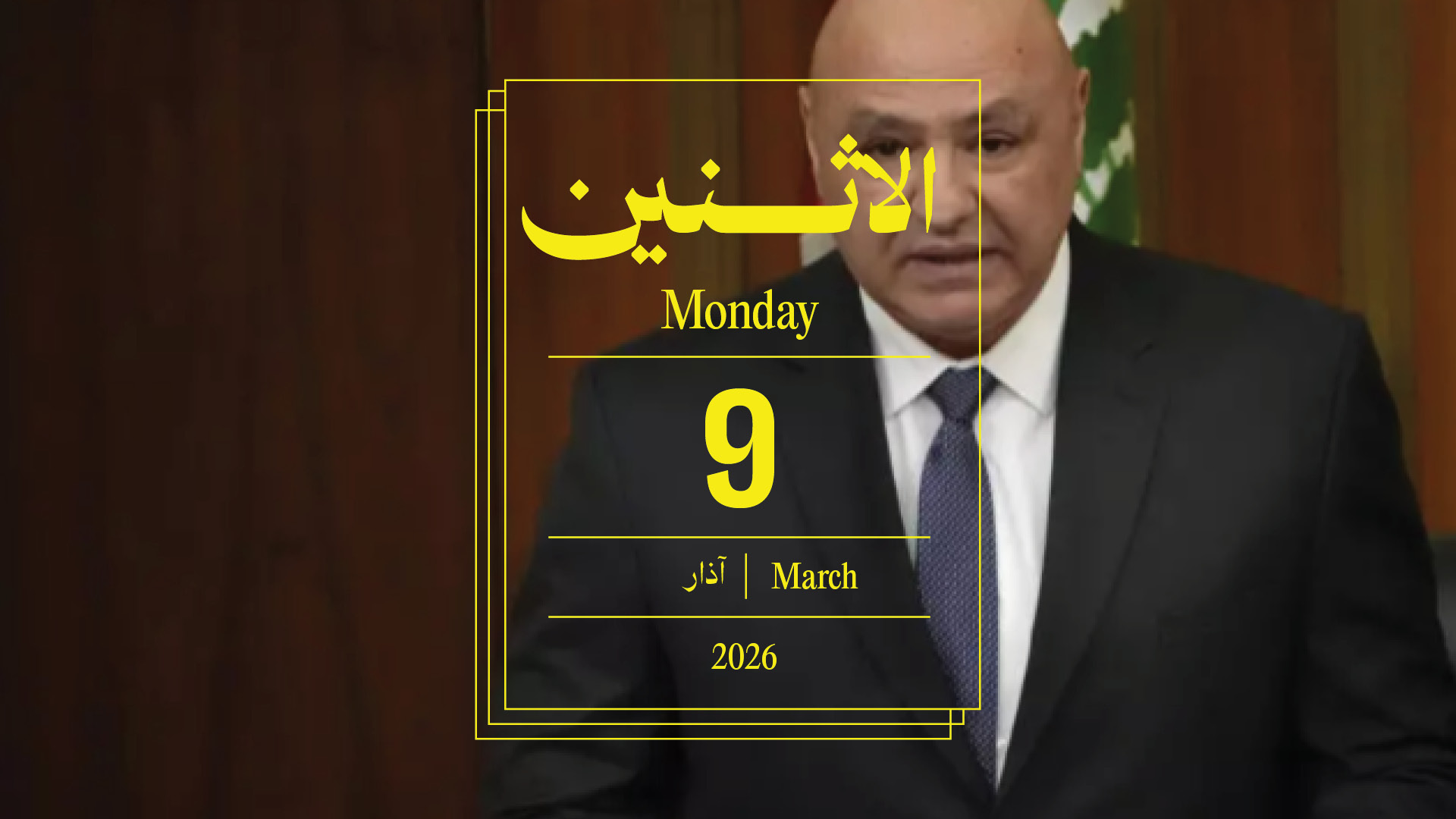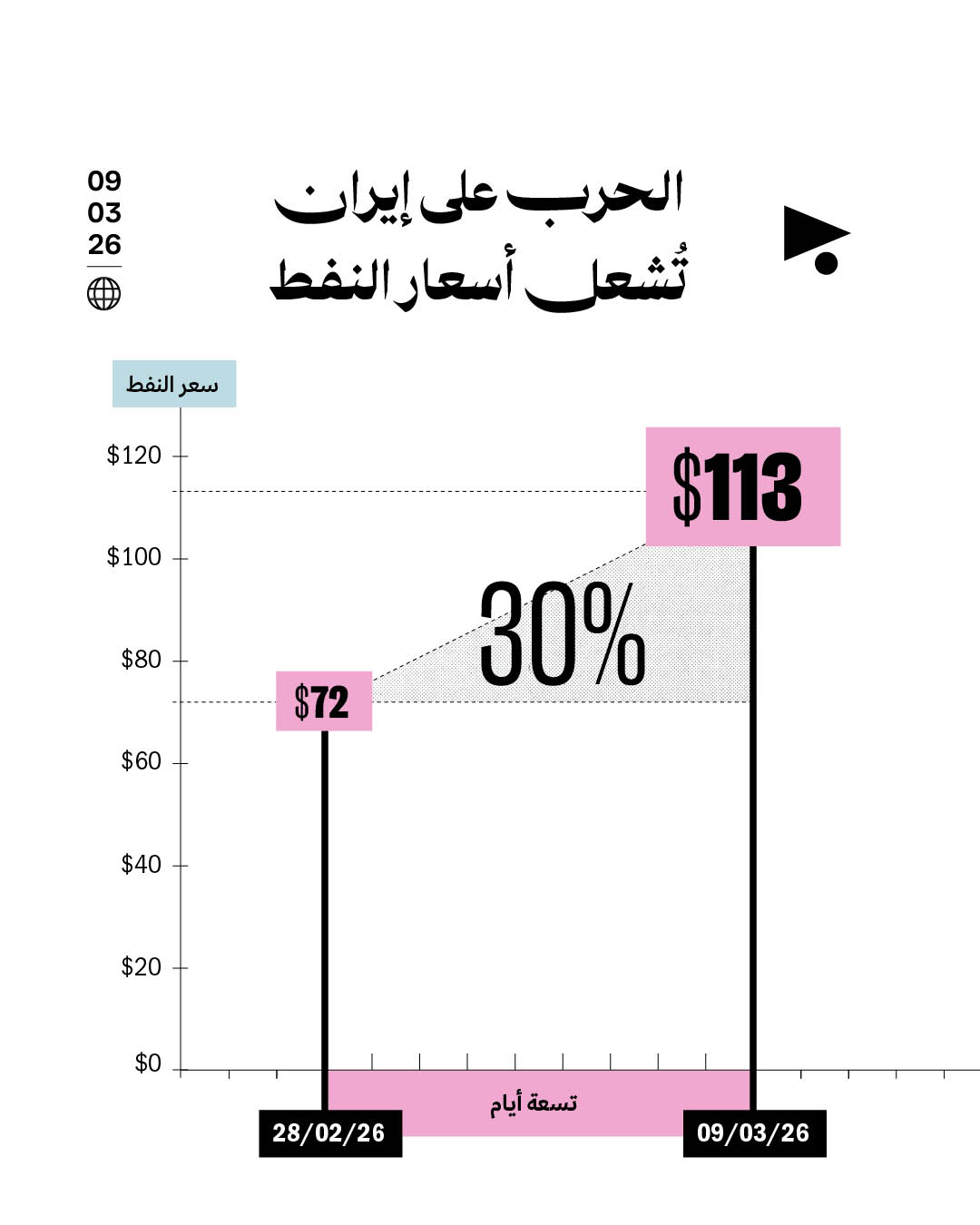منذ اللحظة الأولى لصدور فيديوهات الشابّين محسن محمد مصطفى وأحمد شريف اللذين يبدو أنّهما اقتحما مركز أمن الدولة في حيّ المعصرة في القاهرة، تمنّيتُ من كلّ قلبي أن يكون مشهداً تمثيلياً، لأنّ لحظة ظهور الفيديوهات، تعني أنّ الشباب يواجهون مصيراً لا نرضاه لأشدّ أعدائنا، وهم الضحايا. مصيرٌ أدركه قبلهم آلاف المصريّين، وقامت ثورة كانت أيقونتُها شابّاً تعرّض للتعذيب. ثمّ جاءت حادثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي صكّت والدتُه الجملةَ المؤلمة: «قتلوه كما لو كان مصرياً»!
أمامنا سيناريوهان في هذه القصّة المخيفة، وقد رتّبتُ المعلومات المتاحة لرسم كل سيناريو، ويمكن للقرّاء الانحياز إلى أحدهما، أو خلق سيناريو ثالث.
السيناريو الأول: كلّ شيءٍ حقيقي
عزَل الشابان أحمد ومحسن نفسَيْهما عن ذويهما لفترةٍ من الوقت، فكّرا في الخطوة، مهّدا لها بدقّةٍ وسهولة. أحدهما، وربّما كلاهما، اعتُقل في فترةٍ سابقةٍ بنفس التُّهم التي توَجَّه إلى آلاف المصريين. شاهدا جزءاً من عمل فرع جهاز أمن الدولة بقسم المعصرة، والذي تكفي أخباره المتاحة على الإنترنت للكشف عن طبيعة الممارسات التي تحدث فيه. أحدهما أو كلاهما، لديه ملفٌّ ولديه سوابق في المراقبة اليومية التي تطال آلاف الشباب بعد انتهاء فترة اعتقالهم، وبالتالي فإنّه ليس غريباً عن المبنى والعاملين فيه، ويزور المكان يومياً من أجل إثبات المراقبة. ومن المعروف لدى زوّار هذه المكاتب، أنّها منفصلة عن مبنى القسم الرئيسي، وأن الدولة أنشأت العشرات من هذه المباني المنفصلة في الإدارة عن إدارة قسم الشرطة، بعد قيام الثورة المصرية. ففي السابق، كانت مقرّات أمن الدولة محدودة وتقتصر على مقرّات مركزية، ولكن صار النظام يحتاج إلى المزيد منها في الأحياء الصغيرة أيضاً.
اختار الشابان موعد تنفيذ الفكرة. سجّل أحدهما ملاحظةً صوتيةً يوم 24 يوليو/تمّوز لتصدر في اليوم التالي. اختيار التوقيت كان لافتاً، ففي فترة صلاة الجمعة، تكون أقسام الشرطة غير متأهّبة، وكذلك عدد القيادات المتواجدة يصبح قليلاً، وهذا يفسّر طبيعة المشهد الذي رأيناه في الفيديو، وآثار معركة ودماء على بعض الأوراق التي تمّ تصويرها. فما جرى هو أنّ عدد المتواجدين في الجهاز كانوا نفراً قليلاً، ومن المعروف أنّ أفراد قسم الشرطة العاديين لا يستطيعون الصعود أو الاقتراب من مباني أمن الدولة، إلا إذا تمّ استدعاؤهم، وبالتالي عزلَ الشابان أفراد القوّة ولفترةٍ من الوقت، قُدّرَت أنّها ساعة. وهذا يبرّر أيضاً، لماذا هادن أفراد الشرطة محتجِزيهم، لأنّهم يدركون أنّه من الصعب أن يتواصل معهم أحد.
أكّد شهود عيان حول قسم الشرطة، أنّ نهار الجمعة الماضي كان صاخباً حتّى المساء في المنطقة المحيطة، وحضرَت تعزيزات كبيرة للقوّات، كما أكّدت معلومات أنّ القوّات ألقت القبض على عددٍ من أفراد أسرة وعائلة الشابَّين في حي المعصرة، وأنّ سكّان المنطقة يعرفون أنّ الرواية حقيقية، ولكن مع الفزع الذي ضرب الحي، والانتقام المتوقَّع، لن يستطيع أحد البوح. كما تضمّ الفيديوهات بعض كروت المراقبة لمعتقلين، تمّ الاستعلام عن بعضهم، وتبيّن أنّهم معتقلون بالفعل.
المشهد كله غارق في اللامعقولية، ولكنّنا وحدنا في مصر، نُدرك أنّ بلادنا تصعد شمسها واللامعقول مع كل صباح.
السيناريو الثاني: كلّ شيء مُصطَنَع
انطلاقاً من الرواية الرسمية وردود اللجان الإلكترونية (التي هي صوت النظام الحقيقي بالمناسبة، وليس إعلاميّي البزّات الرسمية)، يبدو أنّ الفيديو كلّه مفبرك، وأنّه يمثّل احتجاز ضابطٍ بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة وينشر وثائق لا تمت بصلة للواقع، بدليل أنّ الشبّان ذكروا الدور الرابع بقسم المعصرة، رغم أنّ مبنى القسم مؤلّف من دورَين فقط، وفجأة انتشرَت نفس الصورة بنفس زاوية التصوير لقسم المعصرة.
وذكرَ بيان الداخلية أنَّ مَن وراء الفيديو هم جماعة الإخوان الإرهابية وأنّ ما جرى ليس إلّا محاولات يائسة للجماعة الإرهابية وعناصرها الهاربة بالخارج للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد.
وهذا يعني أنّ المشاهد التي رأيناها، التُقطت في موقع تصوير، وأنّ جميع الأشخاص ممثِّلون، وليسوا متَّهمين أو ضبّاطاً، وأنّ الغرفة والممرّ واللافتات والملفات ما هي إلّا ديكور مصنوع. ولأنّ الدولة اعتبَرت أنّ ما رأيناه لم يحدث في الحقيقة في قسم المعصرة ولكنّه مصوّرٌ في مكانٍ آخر، فإنّه يجري البحث عمّن نشروا الفيديو المزيّف وبالتأكيد من ظهروا فيه.
لم تكترث الدولة لتوضيح أسماء المتّهمين أو ما إذا كان قد قُبِض عليهم. البيان مُجهّل في كل التفاصيل، عدا نفي حدوث الواقعة من الأساس.
هكذا يتساءل إعلاميُّ النظام مصطفي بكري: لو كان ذلك صحيحاً… أين هم هؤلاء الشباب؟ هل عملوا العملة وذهبوا إلى بيوتهم سالمين غانمين؟
ونضمّ صوتنا إليه: أين الشباب إذن؟ أين أهالي هؤلاء الشباب؟
نكران الدولة واستغلال الإخوان
قلنا مراراً، إنّ القلوب المجبرة على الصمت والإذعان، لن تبقى كذلك، وإنّ العقول الشابّة العالقة بالفراغ، لن يدوم هيامها من دون مجالٍ تحطّ فيه، وإنّ تجفيف منابع الوعي الحرّ في الجامعات وفي مجالات الحياة المدنية، لن ينتج عنه إلا خلايا معتلّة، تعيش تحت جلد المجتمع، ولن يضمن أحد، كيف ستخرج علينا.
لقد تركنا ملايين من الشباب المصري في معركة منفردة مع العجز والهوان وقلة الحيلة. أُغلق الجامع، والجامعة، والشارع، والأحزاب، والمنظمات الحقوقية، وعمّرنا الساحل الشمالي وعاصمة في الصحراء وفتحنا السجون.
إن نكران الدولة لما جرى في ما عُرف بوقائع قسم المعصرة، لن يفيد أحداً، بما فيها الدولة نفسها. هل سألنا أنفسنا، كم لدينا من الشباب الذين يشعرون بكل كلمة قالها الشبان، محسن مصطفى وأحمد شريف؟ هل تستطيع أجهزة المراقبة الحديثة معرفة ما يدور في ذهن هذا الشباب؟ هل استطاعت جيوش المخبرين رصد كل الأصوات الغاضبة في مصر؟ هل يستطيع نظامٌ، مهما كان باطشاً ومسيطراً، أن يتوقع لحظة الانفجار الشعبية؟
أدرك تماماً أن التعتيم هو الوسيلة التي تعتمدها الدولة البوليسية لمواجهة السقطات والثغرات والأزمات، وأن صورة الدولة القوية هي ما تريد أن تحفره بالإكراه في عقول المصريين، خاصّةً بعد وقائع جمعة الغضب 28 يناير/ كانون الثاني 2011 وتشفّي المصريين في وضع رجال الأمن كما صاغته الجملة الشهيرة: «الشعب ركب يا باشا»! ولكنّ مرور كل هذا الوقت، نحو 15 عاماً، يعني أنّ شباب قسم المعصرة كانوا أطفالاً وقت اندلاع الثورة: أحمد الشريف (27 عاماً)، خرّيج تجارة، جامعة الأزهر، ومحسن محمد مصطفى (23 عاماً) خرّيج تربية رياضية، جامعة حلوان.
أصدّق تماماً أنّ هؤلاء الشباب لم يتمّ تجنيدهم من الإخوان أو من أي تيار سياسي، لأن البلد تصحّر سياسياً، ولم يعد فيه سوى أحزاب الموالاة اللقيطة التي لا يعرفها الناس. هؤلاء الشباب حقيقيون، حتّى ولو تمّ إثبات أنّ الفيديوهات مضروبة أو مصنوعة، لأنّ ما يقولونه حقيقي، ستبقى كل كلماتهم المشبعة بمسحة دينية واضحة، تختلف جذرياً عن كل الخطاب الإسلامي الذي سمعناه خلال السنوات الماضية، رغم استغلال صفحات الإخوان لمصيبتهم، بشكل انتهازي كما جرت العادة. ومن السذاجة أن نتوقّع أنّ هذا الشباب يحكمه تيار أو فصيل أو حتى جماعة. هؤلاء الشباب كفروا بالجميع.
معارضة من كرتون
للمعارضة ومن يسمّون أنفسهم نشطاء في مصر الآن، تؤكّد فيديوهات الشباب أننا معزولون تماماً عن السردية الشعبية في ما يخصّ دورنا في غزة. لقد فشلنا في اختبار غزة، لقد ربّى النظام على مدار عقد كامل الفزع الدائم في قلوب المصريّين، وفي كل أزمة إقليمية حولنا، يلوح لنا، كأنّنا أسرى أمنه وأمانه ورعبنا.
سرق هذا النظام القوت، وجوّع الأغلبية وأقرضَ البلاد لأجيال قادمة، بحجّة حماية الحدود والأمن القومي، وها نحن نفقد بوّابة شرقية عمرها آلاف السنين، وسيادتنا على معبرنا، بالإضافة إلى جزيرتين على مضيق دولي، ولا تزال أغنية الأمن القومي تجد صداها. لقد طبّع الرفاق مع خطاب العجز الرسمي. شباب الثورة الذين صاروا عجائزها، يتحدّثون مثل حزب الكنبة، عن الفتات والممكن. تخلّوا عن المستحيلات والمأمول، لا يتحدّثون كيف تقلّص الدور المصري، ومنح أوراق اللعبة إلى أميركا والخليج، لا يتحدّثون إلا عن الخوف. سندفع جميعاً ثمناً، لتجاهل ما يشعر به ويراه هؤلاء الشباب، وهو أن مصر لا تفعل لغزّة ما هو متوقّع وحتميّ أن تفعله، لولا أنها لا تملك قرارها، لأنها مفلسة، مديونة، منهوبة ومُعسكَرة.
هناك شيء يحدث، في أعماق هذا المجتمع، بعيداً عن حسابات الساسة والأجهزة الأمنية والمعارضة الكرتون. هناك تكتّلات غامضة في جسدٍ منهك، ناتجة عن غضب عميق مكتوم، ولا يمكن التكهّن بطبيعتها، إلّا باستخدام العلم والحرية وإعادة اختراع الأمل.
الجنون في عيونهم
إنّ ما يهمّ السلطة في مصر أن تنفي أنّ شباباً بهذه المواصفات، بمسدّس صوت، استطاعوا السيطرة على دور في مبنى خاضع لأمن الدولة بعد سنوات من التسليح وتغيير البنية الشرطية، ممّا لا يسمح بالاقتراب من هذه المقارّ. الهيبة محور الصراع، وفقط.
ولكن ما يهمّنا نحن، شعب هذا البلد، وأهل هؤلاء الشباب، هو أن ندرك حجم الخطر القادم من هذا النوع من التصرّفات اليائسة والعبثية للشباب المصري التي هي أقرب إلى عمليات انتحارية. وأكرّر، حتى لو كانت الفيديوهات كما ادّعت وزارة الداخلية ملفّقة، فهي تعني الكثير، والرسالة وصلت للملايين. ولذلك أسأل:
هل شاهدتم الجنون والرغبة في الخلاص في عيون الشباب في قسم المعصرة؟
أنظر إلى حي المعصرة، وهو حي عمّالي فقير، نشأ بجوار النيل، على خدمة المصانع، وأبرزها مصانع السكّر التي تعمل على عصر قصب السكر، لذلك جاء اسم الحيّ من العصر. ومن داخل هذه البقعة المعصورة، يعيش بعض من شعبنا الكبير بمرارة تواطؤ النظام مع الغطرسة الصهيونية. نعرف قدر الخذلان ويقتلنا الذنب، بينما يبحر آلاف الغزيين يومياً الى الأهوال، حيث مقرّات وكالة إغاثة، تقتل شخصاً وتطعم آخر الدقيق الدامي. في الصباح يخرجون من العراء للعراء، تحت سياط الشمس، تصحّرت المدينة في عامَين، وصارت كل الطرق مفتوحة بلا ظلال، تؤدّي إلى الهلاك الحتمي. وبما أنّ الموت هو أسهل ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان الغزّي الآن، كما وصف صديقنا الصامد في جباليا، فلا مانع من المقامرة من أجل باقي إطعام الأسرة الهالكة. صار شوال الطحين الوصية الأخيرة، قبل العودة إلى ما تبقّى من العائلة، فوق عربات الكارو الخشبية، ممدّداً، مقطوع النفس، وفي فمه طحين أحمر.
في نفس اللحظة، وعلى بعد كيلومترات محدودة من أهوال يوم القيامة في غزة، يخرج شباب من البطانة غير المرئية للمجتمع المصري، الفقير المنهك، يصل بهم العجز والعدمية لأن يطلبوا من ضابط بقسم بضاحية هامشية في العاصمة، فتح معبر رفح! كان جنون العجز بادياً في عيونهم. وعلينا أن نخاف، ولهذا، فإنهم حقيقيون في كل حال.