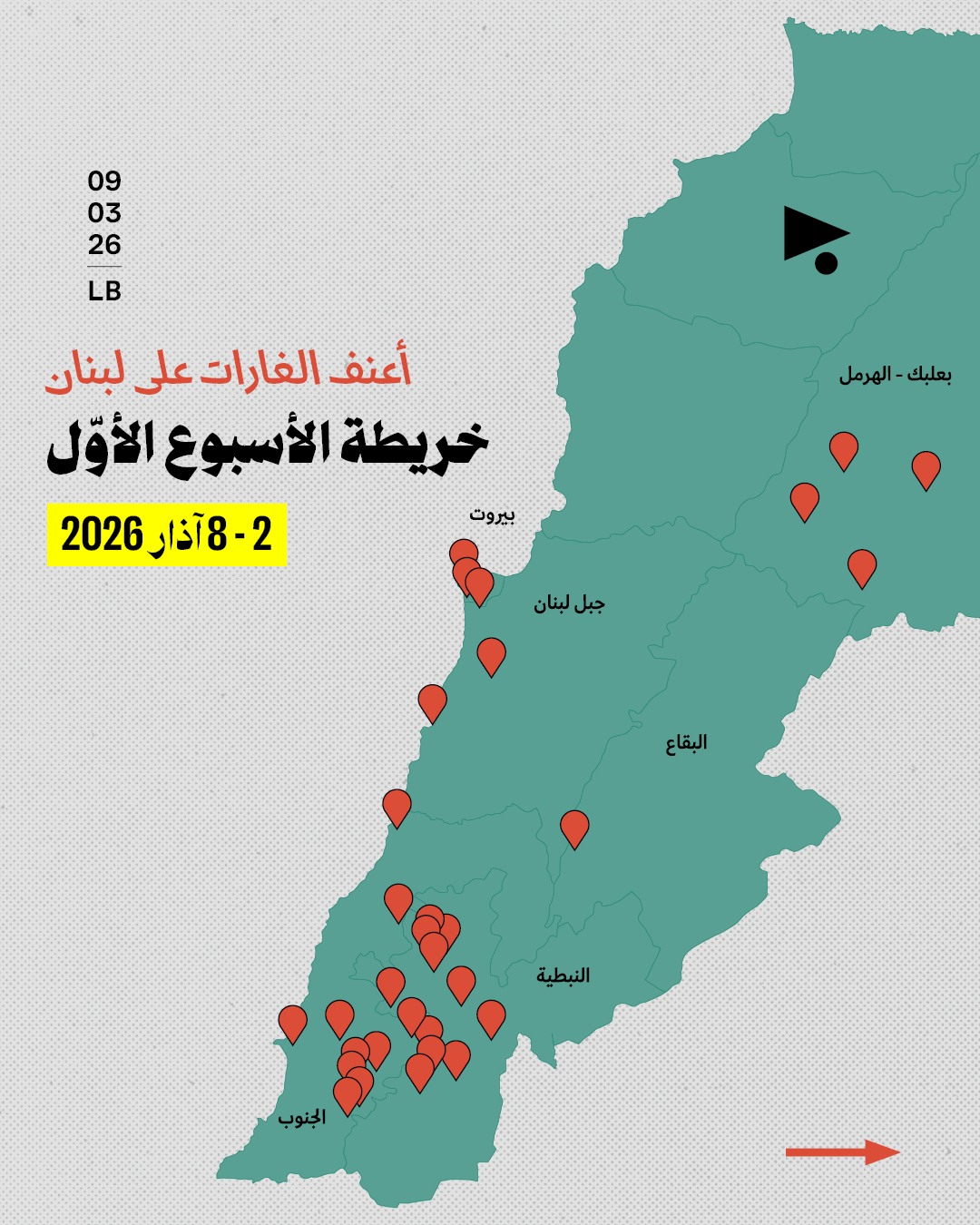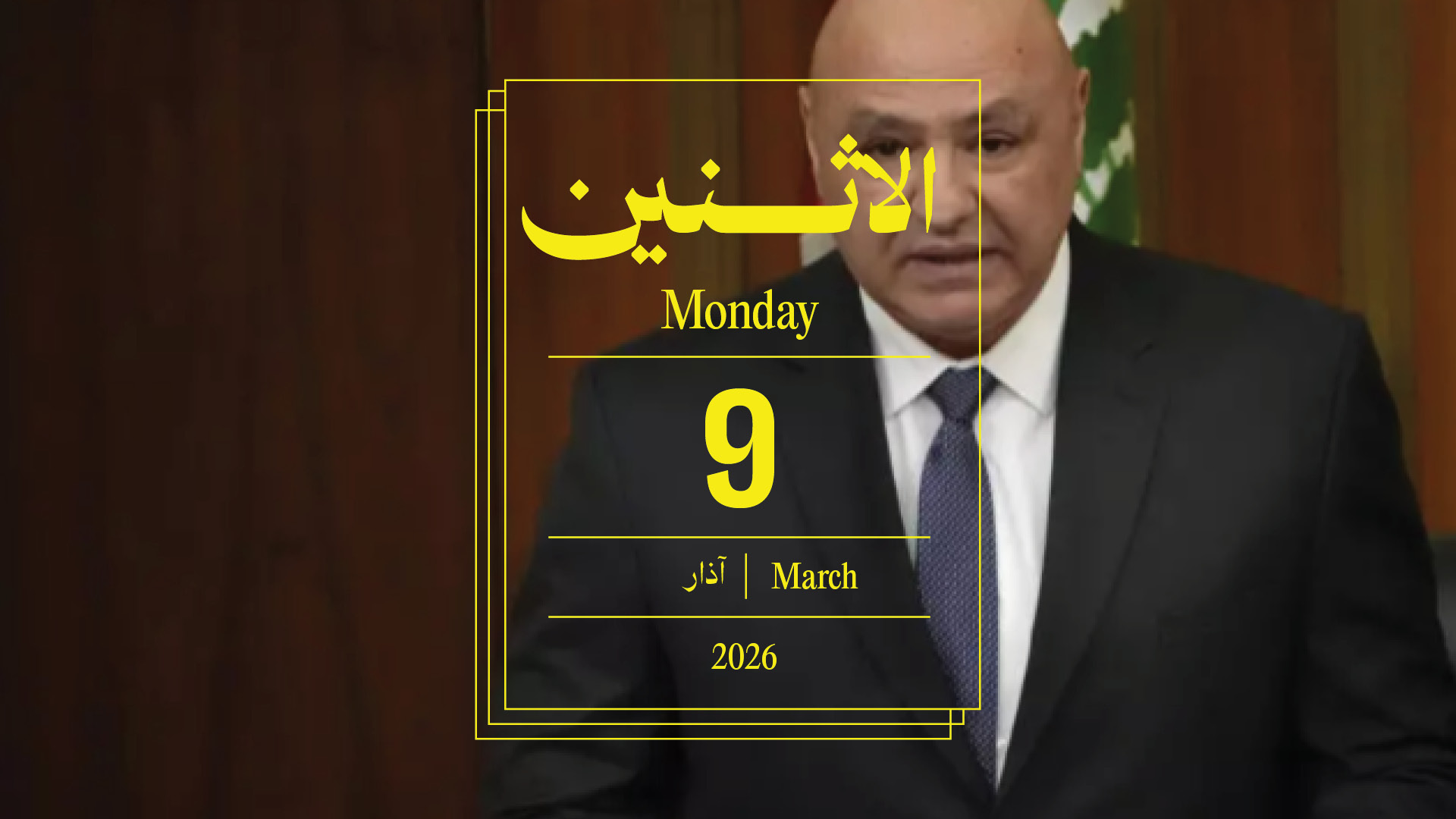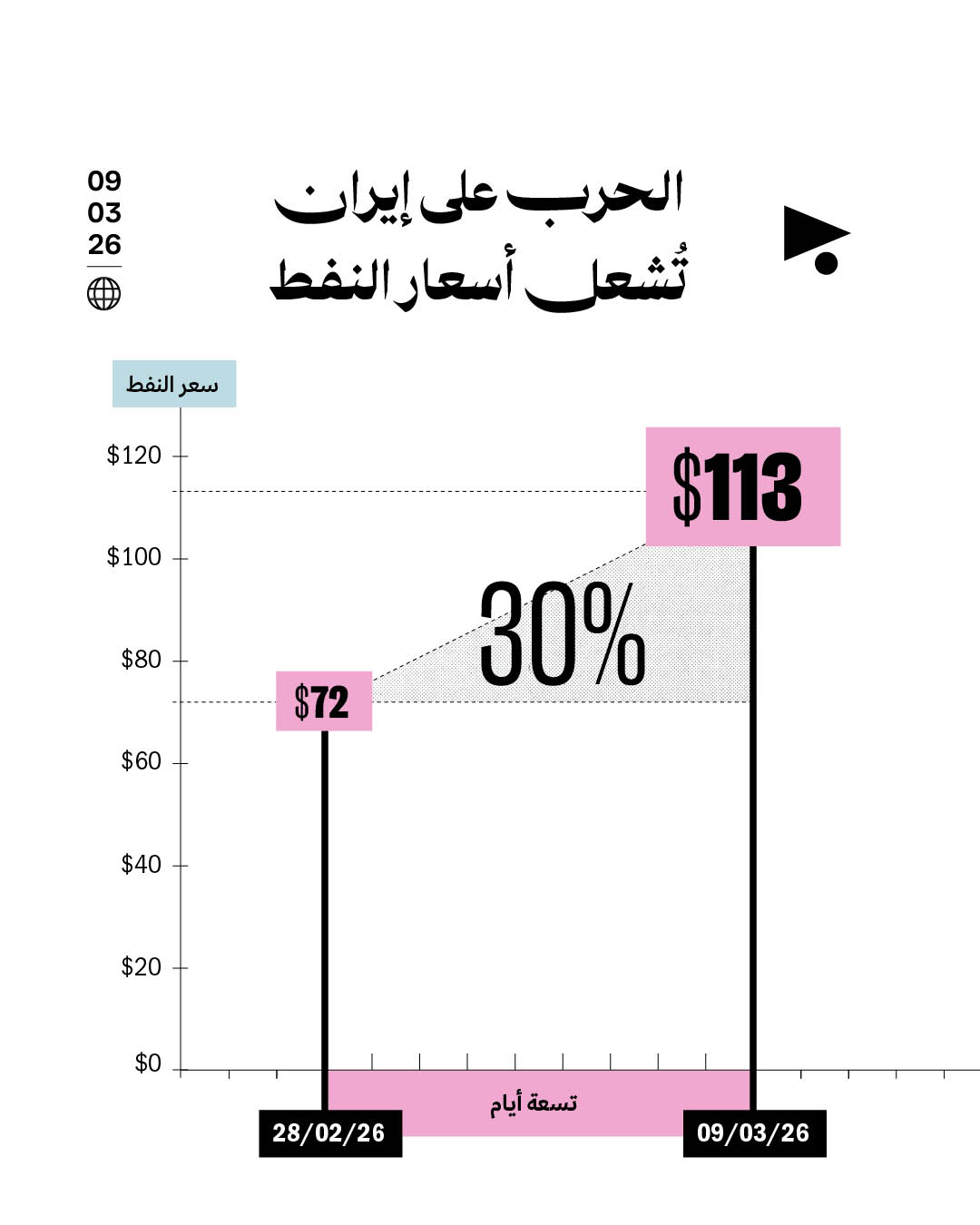المشترك المكاني
تتتالى الكوارث البيئية في لبنان، فلا يكاد يمرّ يوم من دون خبرٍ عن اعتداءٍ هنا أو حادثة هناك. لكن بناء فيلا فوق مغارة الفقمة في عمشيت، أو إقامة حفل زفاف داخل مغارة جعيتا، أو اندلاع الحرائق في الغابات أو سوى هذه كلها، ليست إلا أحداثاً تخفي خللاً بنيوياً في علاقة اللبنانيين بالمكان الذي يعيشون فيه. فما نشهد تفكّكه وتحلّله ببطء منذ سنوات ليس الدولة ولا العقد الاجتماعي ولا الاقتصاد فقط، بل المشترك الأكبر الذي يجمع بين اللبنانيين، أعني المكان نفسه. وبين التدمير الإسرائيلي جنوباً والجشع الرأسمالي داخلياً والفساد السياسي على طول الجغرافيا الوطنية، يبدو ملحّاً إعادة تعريف هذا المبدأ الذي اسمه «العيش المشترك» ليتخطى مجرّد الاتفاق بين الطوائف ويشمل العلاقة بين اللبنانيين والحيّز الجغرافيّ الذي يعيشون فيه: الأرض التي يمشون عليها والهواء الذي يتنفّسون سمومه والمياه التي يتآخون مع بكتيرياتها والبحر الذي يُمنعون عنه والجبل الذي يُستثمَر. أن نعيش هنا يعني أن نعيش مع هذا المكان لا فيه فقط. أن ندرك أنّ ما يتداعى من حولنا ليس الطبيعة كفكرة رومانسية وفضاء يوتوبي، بل علاقتنا بها وبأنفسنا.
علاقة نفعيّة مع الطبيعة
صحيح أنّ الانهيار البيئي مرآة لانهيار الدولة وفسادها المزمن ونتيجة لهما، لكنه شيءٌ آخر أيضاً. ثمة ما هو أعمق من سوء الإدارة وأكثر رسوخاً من الفساد السياسي. إنها العلاقة النفعية خصوصاً والمحكومة بمنطق الغنيمة بين اللبنانيين والطبيعة. فهذه الأخيرة لا يُنظر إليها بوصفها مجالاً مشتركاً للعيش، بل كثروة قابلة للاستثمار. السياحة ثم السياحة ثم السياحة. رغم أن العالم كله يعيد اليوم تقييم أثر السياحة المفرطة على البيئة والعيش المحلي، لا يزال اللبنانيون يعتبرونها قيمة فوق النقد ويحمّلونها منطقاً خلاصياً موهوماً. فإذا بالأرض تقاس بالعقارات وبالبحر يختزل بالمنتجعات وبالجبل يتحوّل إلى بيوت ضيافة تُستهلك في عطلة نهاية الأسبوع. لا أفهم مثلاً كيف لا يستغرب أحد بناء مسابح فوق البحر. من يملك بحراً ويعرف معنى البحر، هل يحتاج فعلاً إلى مسبح؟ ثمة مشكلة عميقة في النظر إلى الأمور، في كيفية تقييمنا لها، في ما نعتبره جديراً بالحماية وما نراه مباحاً للتدمير.
والطبيعة في لبنان أيضاً تُختزل غالباً إلى منظر، إلى واجهة إعلانية، وقيمتها مشروطة بما يظهر في الصورة. لاحظوا الصور والفيديوهات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي: تكاد كلها أن تكون مأخوذة من زاوية نظيفة لا تظهر فيها النفايات، أو بلقطة جوية لا تبان فيها تفاصيل الكارثة، أو في مشهد مستقطع يخفي فيه صوت فيروز في الخلفية ضجيج المولّدات والسيارات وصهاريج المياه أو حتى الدرونز التي تحوم فوق القلوب والرؤوس. في لبنان، تُستهلك الطبيعة انستاغرامياً بدل أن تعاش فعلياً.
في الجبال والجرود والقرى، نرى منذ بضع سنوات عودة إلى الريف لا للعيش فيه أو لتحسين ظروف أهله بل لاستهلاكه. رحلات الهايكنغ العشوائية محكومة بمنطق الاستهلاك نفسه. جماعات تدخل الغابات والأحراج كما تدخل مولاً تجارياً. إنفلونسرز يتسلقون شجرة أرز معمّرة في القبيّات ليتصوّروا فوقها. «عودة» إلى الطبيعة يرافقها جهل تام بالنظام البيئي لهذه الأمكنة وبحساسيتها. ناهيك عن بيوت الضيافة التي تنمو مثل الفطريات لتحوّل القرية إلى «منتج» بدل أن تكون مجتمعاً. كل هذه ممارسات تتماهى فيها الجغرافيا والطبقة، الطبيعة والسلطة، الجمال والتربّح، لتتآكل العلاقة بين الناس والمكان وتكفّ الطبيعة عن كونها حيّزاً مشتركاً للعيش وتصير رأسمالاً جمالياً وواجهةً مُربحةً تُعرَض وتُباع.
العنف البطيء الإيكولوجي
أما خلف الصورة، فيتعايش اللبنانيون بالحيلة مع تلوّث المياه والهواء وتكدّس النفايات ويتعاملون معها كأنها قدرٌ محتوم. صحيح أنّ كل هذه الكوارث وسواها هي مشاكل بيئية بالمعنى التقني لكنها أيضاً وخصوصاً مظهر من مظاهر عنف عضويّ يصيب البشر والمكان معاً. عنف بطيء، كما يُسمّى في أدبيات الدراسات الإيكولوجية، حرب أخرى أو انفجار آخر، أقل مشهدية ولكنه ليس أقل فتكاً. عنف لا يُرى لأنه ليس حدثاً، بل مدّة. ليس انفجاراً بل استنزافاً. عنف لم يكن انفجار الرابع من آب إلا استعارة مشهدية عنه كثّفت عقوداً من تحلّلٍ لا صوت له ولا صورة.
من هنا، بدا مشهد غسل صخرة الروشة مؤخّراً عبثياً بامتياز. بغضّ النظر عن وجهات النظر البيئية المختلفة التي برّرت أو اعترضت، فجأةً حضرت الدولة الغائبة عن كل شيء لتنظّف وجه الصخرة، لتلمّع الصورة والرمز بينما الشوارع متسخة والأرصفة غائبة والهواء ملوّث والمجارير تصبّ في البحر. هذا البحر الذي لم يعد يصل إلينا إلا كصورة. وباتت بيروت خصوصاً مدينة تُختبر فيها الطبيعة بوصفها غياباً مستمراً.
وعيٌ مكانيٌّ بدل حنين إلى الماضي
لا يجب أن يُفهم ممّا سبق بأنه دعوة للعودة إلى «الطبيعة» كمساحة نقية وبسيطة. فهذا التصوّر، رغم جاذبيّته، يخفي نزعة رومانسية وخطاباً محافظاً يعيد إنتاج ثنائية قديمة بين الطبيعة النقية والمدينة الفاسدة. الأزمة البيئية في لبنان لا تحتاج إلى حنين بل إلى تفكير مختلف. فالجبل ليس فردوساً ضائعاً والمدينة ليست خطيئة. كلاهما فضاء اجتماعي وسياسي محكوم بالطبقة والسلطة والاقتصاد. وما دمّره رأس المال والفساد على مدن الساحل يتكرّر اليوم في القرى والجبال التي يُعاد تشكيلها وفق تصوّر سياحي واستهلاكي طبقي، لا وفق حاجات الناس الذين يعيشون فيه.
المشكلة ليست في غياب الوعي البيئي أو الإرادة السياسية فقط، بل في النظام الرمزي الذي يجعلنا نرى الطبيعة مجرد خلفية جميلة والمكان سلعة للاستهلاك. لذلك، ليست الدعوة هنا إلى إنقاذ مغارة هنا أو غابة هناك، على ضرورة هذه التحركات، بل دعوة إلى إعادة تعريف معنى العيش المشترك ليشمل الناس والمكان، وإعادة التفكير في موقعنا في هذا الحيز المكاني المسمى وطناً: كيف نعامله بوصفه شريكاً لا بوصفه مادّةً خاماً قابلة دوماً للاستثمار والاستهلاك، وكيف نعيش معه لا فيه فقط.