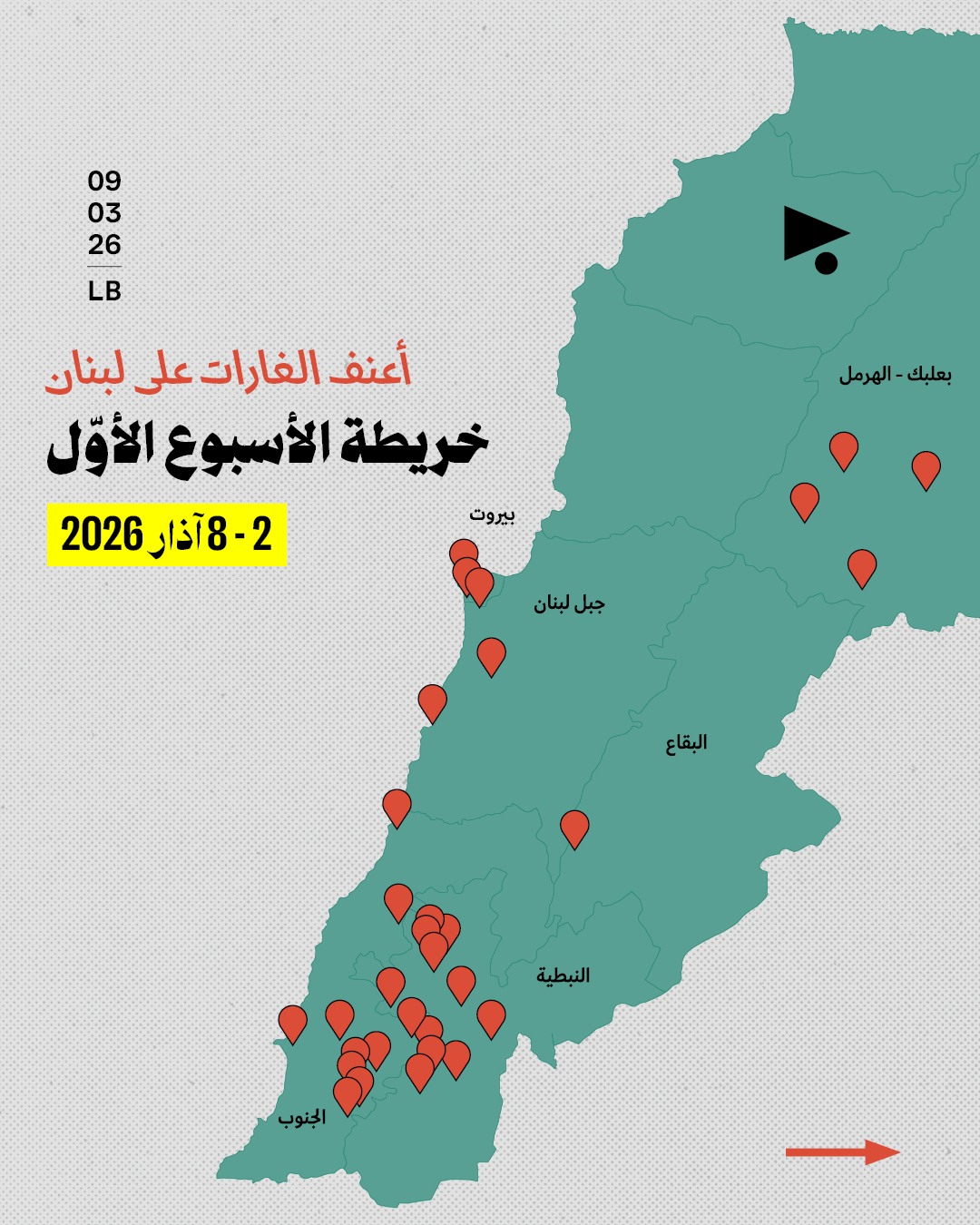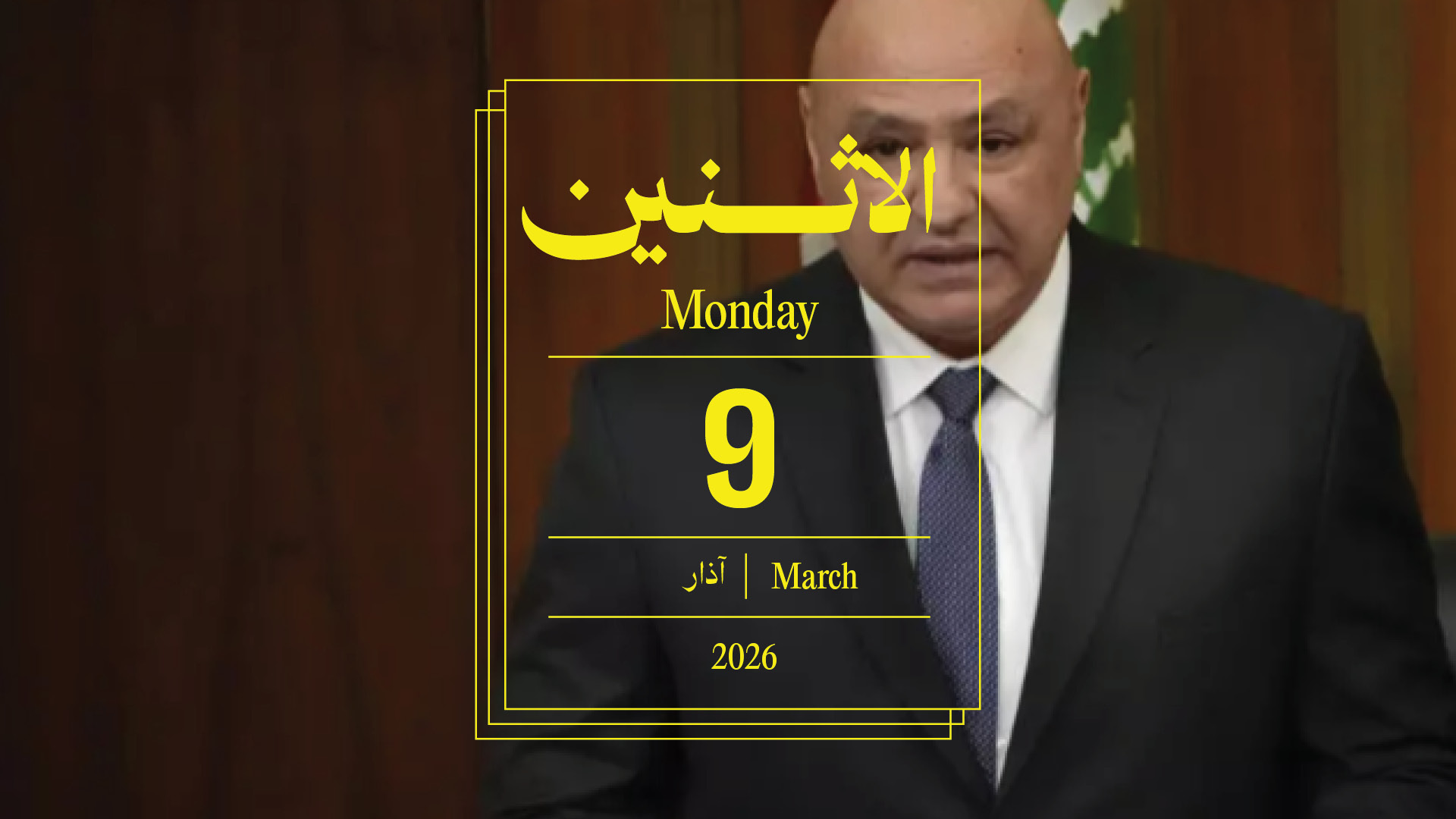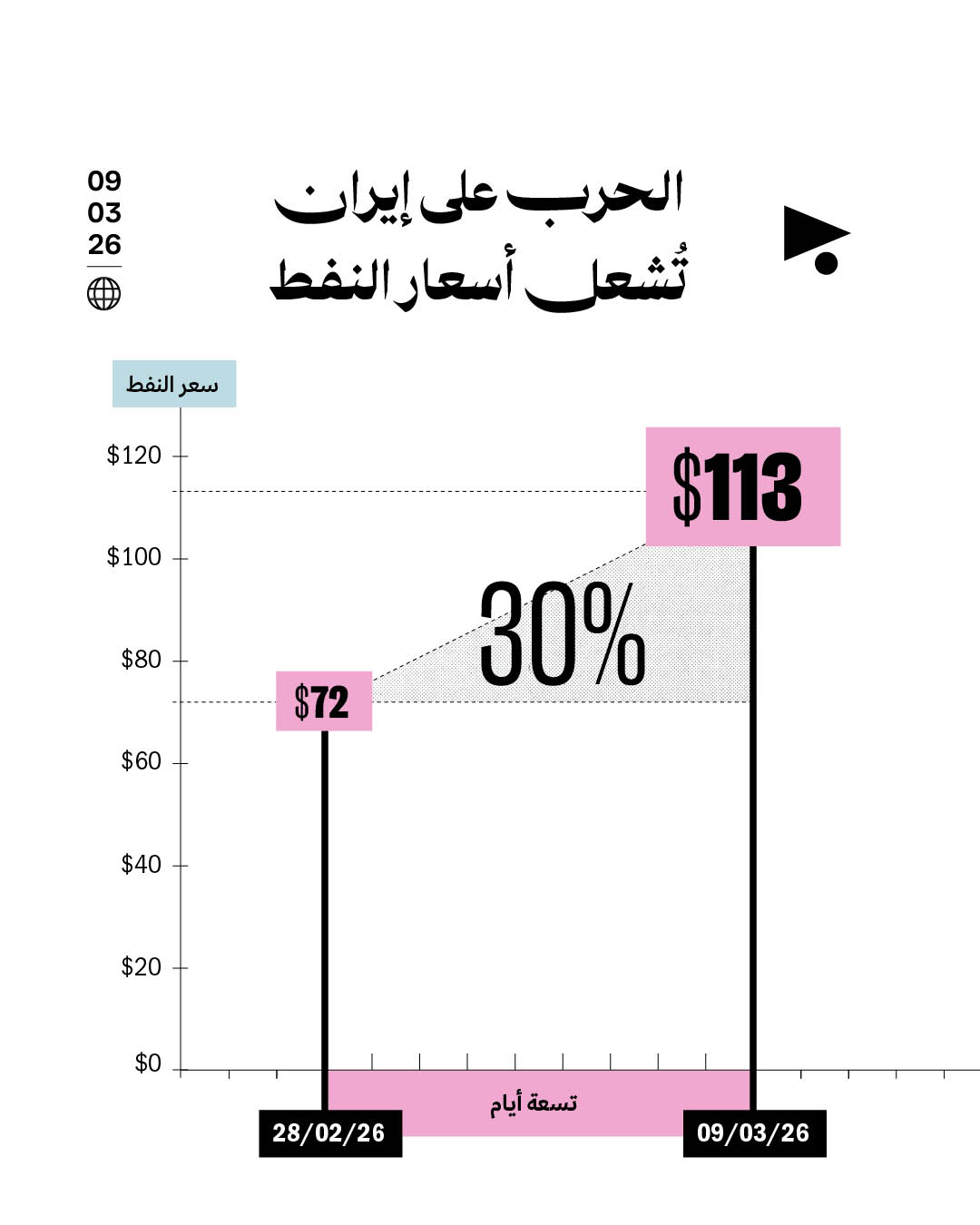تلقيتُ خبرَ رحيل زياد الرحباني وأنا غارقة في قراءة كتاب الروائي والباحث الفرنسي فيليب فورست «التفكيك وإعادة البناء: شجار الووك» (غاليمار، 2023). وتابعتُ ردود الفعل اللبنانية وهي تعيد استذكار زياد وتناول مشروعه الفني ومواقفه السياسية، والتي تراوحت بين التأليه والتأنيب ومحاولات الاستعادة الوطنية. وبدا لي كل ذلك نموذجاً لما يسمّيه فورست «أيديولوجيا إعادة البناء»، وهي الرغبة الجامحة في إقفال المعنى داخل يقينٍ هويّاتي مريح، في اعتقادٍ واهم أنّ ذلك ينقذ الإنسان الحديث من العدمية التي أوصلته إليها سنوات من الشك والتفكيك.
ثلاثة أنماطٍ من التلقّي برزت سريعاً. أوّلها، مَن يرفع زياد الرحباني أيقونةً لقطيعةٍ تامّة مع مشروع أهله، بوصفه الابن المتمرّد الذي هدم الفردوس الرحباني. وثانيها، مَن يردّه إلى العباءة اللبنانية الضيّقة، ويجذبه تحت سقف السرديّة الوطنية المطمئنة، تماماً كما استعادت السرديّة ذاتُها جبران المتمرّد في ما مضى. وثالثها، من يختزله بموقفٍ سياسيّ بعينه، وأعني موقفه من الثورة السوريّة، ليحاكم مجمل مسيرته انطلاقاً من تلك اللحظة. أما القاسم المشترك بين الثلاثة، فهو إقفال مشروعه الفنّي ضمن صيغةٍ إيجابيةٍ جاهزة، تُلغي توتّره الخلّاق وتعدّده الدلالي.
في كتابه، لا يتناول فورست طبعاً معضلاتنا اللبنانية السياسية والفنية، لكن فيه الكثير مما أَعانَني على فهم المشهد المستمرّ منذ السادس والعشرين من تموز. يعتبر فورست أنّ نزعة إعادة البناء أصبحت بمثابة الأيديولوجيا الجديدة في زمننا، وباتت تُقدَّم بوصفها عملية إصلاح لما فكّكته أو «دمّرته» الحداثة وما بعد البنيوية. فيُظهّر كيف أنّ أنصار الووك ومناهضيهم يلتقون اليوم حول معاداة التفكيكية ويتهمونها بالعدمية والنسبية الثقافية ويشتركون، رغم تناقضاتهم الظاهرة، في الرغبة في إعادة تأسيس قيم ثابتة. فبرأي فورست، إنّ ما يُسمّى بتيار الووك يعالج العنصرية والتمييز الجنسي والهوياتي بهوية مضادة، والمعادون له والرافعون شعار مقاومة الهوياتية يقعون بدورهم في هوياتية جديدة تدعو للعودة إلى الجذور واستعادة هوية وطنية أو دينية أو ثقافية ثابتة تستند إلى «الطبيعة البشرية» و«الثوابت الأنثروبولوجية».
يشير فورست، مع ذلك، أنّ لا جديد في كل هذا: فعبر العصور، كلما انهارت القيم السائدة، برز ميل قوي إلى استعادتها أو استبدالها بأخرى بدل مواجهة الفراغ القيمي الناتج من سقوطها. هذا الميل قد يحوّل المشكِّك إلى دوغمائي ويفتح المجال للانغلاق والتعصّب الذي يقود إلى كوارث جديدة وخطابات أسطورية ذات طابع فاشي. باختصار، إن محاولات تجاوز العدمية عبر إعادة البناء من أجل تحقيق المصالحة النهائية بين الإنسان و«جوهره» أو «هويّته» الأصلية التي تخلّى عنها أو شوّهها تُفقده، حسب جوليا كريستيفا، تجربة الصراع الداخلي أو التناقض، التي هي جزء أساسي من كوننا بشراً في العالم الحديث. فما يُسمّى بأزمة هوية ليس مرضاً أصلاً، بل هو وضع طبيعي ناتج من التعدّد والتناقض، وبالتالي، فإن محاولة إزالته بالقضاء على «الحسّ السلبي» (أي القدرة على مساءلة «الحقيقة» وفتحها للنقاش والتشكيك في المسلّمات) هو إلغاء لشرط أساسي من شروط الحياة الفكرية والإنسانية الذي يجعل الهويّة والفكر والنصّ أموراً قابلةً للمساءلة الدائمة.
وفي هذا تحديداً يُعيننا فورست على تسمية ما يحدث. فهذه النزعة في قراءة مشروع زياد الرحباني من خلال استبعاد تناقضاته والبحث أو محاولة ترميم معنى واحد ونهائي له، لا تُتنج نقداً بل أصناماً، ولا تحلّل بل تحنّط، ومن الضروري مقاومتها وتفكيكها هي نفسها. فتأليه زياد واعتبار مشروعه قطيعة تامّة مع مشروع أهله يُسقط السياق الذي خرج منه ويُبطل المفارقة في مساره. أما محاولة استعادته من قبل خطاب الوطنية اللبنانية، فتُحوّله رأسمالاً رمزيّاً لهوية منكمشة على ذاتها وتضيق كل يوم أكثر، تُسكِت حدّته النقدية وتطمس نزوعه إلى زعزعة اليقينات. وأخيراً، فإنّ محاكمته أخلاقياً استناداً إلى موقفه من الثورة السورية والنظام السوري السابق، تُحوّل لحظةً سياسيةً إلى «جوهر» ثابت يلغي التعدّد الدلالي لعمله الفنّي. هذه كلّها وجوهٌ متعدّدة لـ«إعادة البناء»، أي خنق مشروع فنّي حيّ ومتوتّر داخل يقينٍ مريح.
لكن كيف نقرأ مشروع زياد نفسه إذا تخلّصنا من غواية «إعادة البناء» هذه؟ ما يدعونا إليه فورست، بالاستناد خصوصاً إلى جاك دريدا ورولان بارت وجوليا كريستيفا، هو أن نفهم «التفكيك» لا بوصفه هدْماً أو عدميّة، بل باعتباره طريقة قراءة من الداخل: زعزعةٌ للبُنى تكشف فراغاتها وتعدّد طبقاتها، وتعليقٌ لـ«الحضور» الواحد للمعنى من غير إسقاطه في اللامعنى. بهذا، يظهر مشروع زياد الرحباني نموذجاً مثالياً للتفكيك: إنه ابنُ العباءة الرحبانية الذي يدخلها من طيّاتها، لا لينسفها، بل ليظهّر ما تخفيه.
يعمل تفكيك الرحباني على ثلاثة مستويات متداخلة.
في اللغة، يرفض إنشائية سعيد عقل المتعالية ورومنسية الأخوين الرحباني اليوتوبية ليبدع عامية مشغولة بدقة حرفية رغم ما يبدو عليها من عفوية. فهو يشظّي القوالب اللغوية، ويحدث ثقوباً في الجملة، ويعلّق الدلالة بدل أن يقفلها، فيفعل ما سمّاه بارت «تعليق السلطة» الكامنة في اللسان، ويستبقي، على طريقة كريستيفا، على التوتّر الخلّاق بين ما يُنتج المعنى وما يفلت منه.
في الموسيقى، لا يُسقط «هوية» جاهزة على الصوت، بل يُركّب طبقاتٍ هجينة تُرجئ الحسم: لا شرقي صافٍ ولا غربي خالص، بل اختلافٌ وتأجيل ينسف فكرة الأصل المتعالي للّحن.
في البناء الدرامي/السردي، يقيم عن عمدٍ في ما يسمّيه دريدا «aporie» أي المعضلة، فلا يبشّر ببديلٍ مريح، ولا يكتفي بنقضٍ سهل، بل يضعنا أمام تناقضٍ مقيم، هو نفسه مادّة المعنى.
من هنا، لا يستقيم وضعه بين حدَّي القطيعة والطاعة. فمشروعه ليس نقضاً جذرياً لمشروع الرحابنة، ولا امتثالاً له. إنّه «نيغاتيف» يحافظ على البنية ويقلب الإضاءة عليها: يفتح سرديّة الفردوس الرحباني على تشقّقات المدينة والعنف الطبقي والطائفي والسياسي، ويعيد الأسطورة إلى عاديّتها ويوميّتها. لا يقدّم «هويّة» بديلة، بل يخلخل آليّة إنتاج الهوية ذاتها، وهذا هو التفكيك في جوهره.
وعليه، فقراءة عمله مشروطة بالمبدأ التالي: النصّ/ العمل الفني يتجاوز صاحبه. إن مفهوم «موت المؤلّف» عند بارت ليس إعفاءً أخلاقياً، بل تحريرٌ للنصّ من قبضة النيّة الواحدة. من هنا، يمكن (ويجب) أن نقيم مسافة نقديّة من مواقف زياد الرحباني المتأخّرة من غير أن نحوّل تلك المواقف إلى محكمة تُسقِط طبقات العمل وتعقيداته. فالتفكيك كما مارسه في أعماله لا ينسف الانتماء بل يعقّده.
ولكي نرى ذلك بوضوح، يفيدنا ما يقترحه جيل دولوز عن «الطية»: العالم، وكذلك النصّ/ العمل الفنّي، لا يتكوّن من أسطحٍ منفصلة، بل من ثنيات يكشف فيها الداخلُ ما كان يُحسَب خارجاً. ومشروع زياد الرحباني ممارسةٌ لفعل الطيّ هذا: انعطافٌ داخل العباءة الرحبانيّة يُظهر ما طمسته زخرفتها، من غير أن يقطع القماش. لذلك تبدو لغته وموسيقاه سلسلةَ انثناءاتٍ لا قرار لها، كلّ طيّةٍ تُخرج طبقةً جديدة من الصوت والمعنى واللّغة.
في الواقع، لا يُفهم مشروع زياد الرحباني خارج مشروع أهله، لا لأنه مجرّد استمرار له، بل لأنه يفكّكه من الداخل. فلا صوته، أو أصوات من اشتغل معهم، يُفهم من دون صوت فيروز مع الأخوين رحباني، ولا هجاؤه للفكرة اللبنانية يُفهم من دون سردية الفردوس الرحباني. مشروعه يقتات من الرحابنة ليُخالفهم، ويستند إلى مناخهم ليُعرّيه، ويستبطن سرديتهم ليُحرّفها سردياً وجمالياً. لم ينقض زياد «الحلم اللبناني» الذي رسمه الأخوين الرحباني بصوت فيروز، بل أفرغه من شاعريّته المصمَتة، ليُعيده إلى واقعه المتصدّع ويخلّص السردية من سذاجتها.
لكنّ هذا المشروع الذي بدأ كـ«نيغاتيف» نقدي، كمحاولة لخلخلة البنية من داخلها، بدا كأنه فقدَ شيئاً من حدّته حين انهارت البنية نفسها، أو على الأقلّ، حين انهزمت أيديولوجياً. فالحلم اللبناني الذي سخر منه زياد، والنموذج الرحباني الذي هاجمه، واللغة اليوتوبية التي فضحها، لم تعُد هذه كلها تحكم الخيال الجماعي كما في السابق. ومع غياب الهدف أو «الخصم»، لم يعد التفكيك ممكناً بالطريقة ذاتها، فبدأ المشروع يفقد توتّره النقدي.
هكذا بدا زياد في سنواته الأخيرة: غارق في إرهاق وجوديّ جرّاء خيبات متراكمة. لم تتراجع موهبته، بل تراجع العالم من حولها، وتراجع التساؤل الداخلي معها، ذاك الذي كان قادراً ذات يوم على صنع الدهشة.
وعليه، من الضروري أن نرفض حصر زياد في معسكرَين متخاصمَين يتنازعان ملكيّته الرمزيّة وكلاهما يغلقه: معسكرُ الأصالة الهوياتية اللّبنانية ومعسكرُ القطيعة العدميّة. وأن نُؤثِر قراءة مشروعه فنياً لا إيديولوجياً: أن نعيد الاعتبار لـ«كيف» يشتغل عمله الفني، لا لِما قد يخدمه من عناوين. فما من تكريمٍ أصدق لزياد الرحباني من أن نقرأه ضدّ محاولات تأميمه. فلا نُضيفه إلى طابور الرموز، ولا نُسقط عليه عدميّتنا، ولا نختزله في عثرةٍ سياسية. الوفاء الحقّ هو أن نحرس في عمله ما سعى هو نفسه إلى إيجاده: مساحة للالتباس الخلّاق. أن نُبقي نتاجه الفني مفتوحاً للسؤال، وأن نتركه يربكنا. فـ«التفكيك» الذي كان في جوهر مشروعه هو فنّ إحداث ثغرات وفجوات يدخل منها الهواء إلى البُنى التي نخنقها بمحبّتنا أو بكراهيتنا وتخنقنا. وإذا كان موت زياد قد استدعى فينا رغبة التئامٍ سريع ومحاولات محمومة لإعادة البناء، فإنّ درسه الأعمق والأبقى، والذي هو درس الفنّ ذاته، يقول لنا: اتركوا النص مفتوحاً. فهناك، في الهوامش، لا في المركز، يولد الفنّ ويزدهر وينقذنا من أنفسنا ومن المدّ الظلاميّ المقبل علينا.