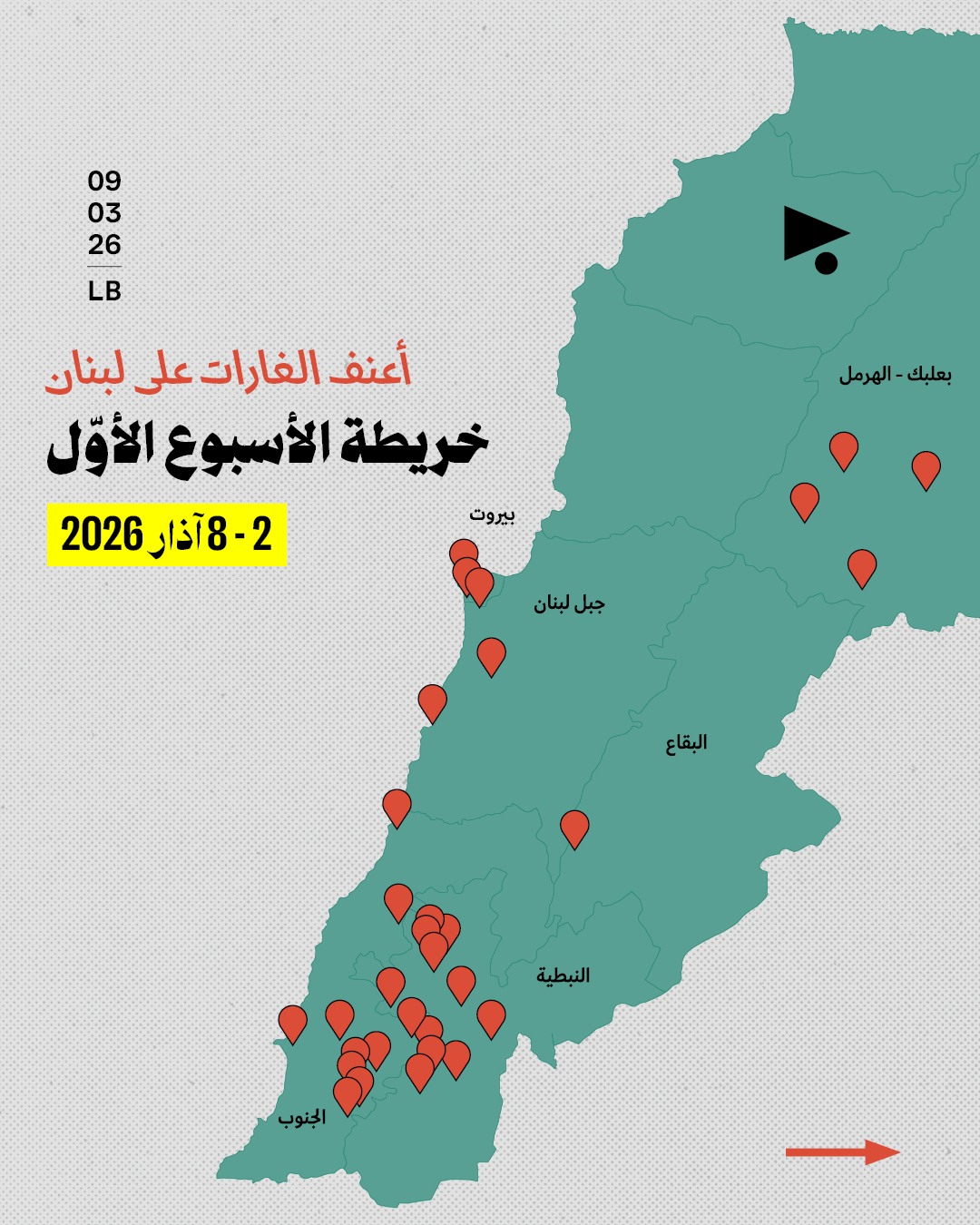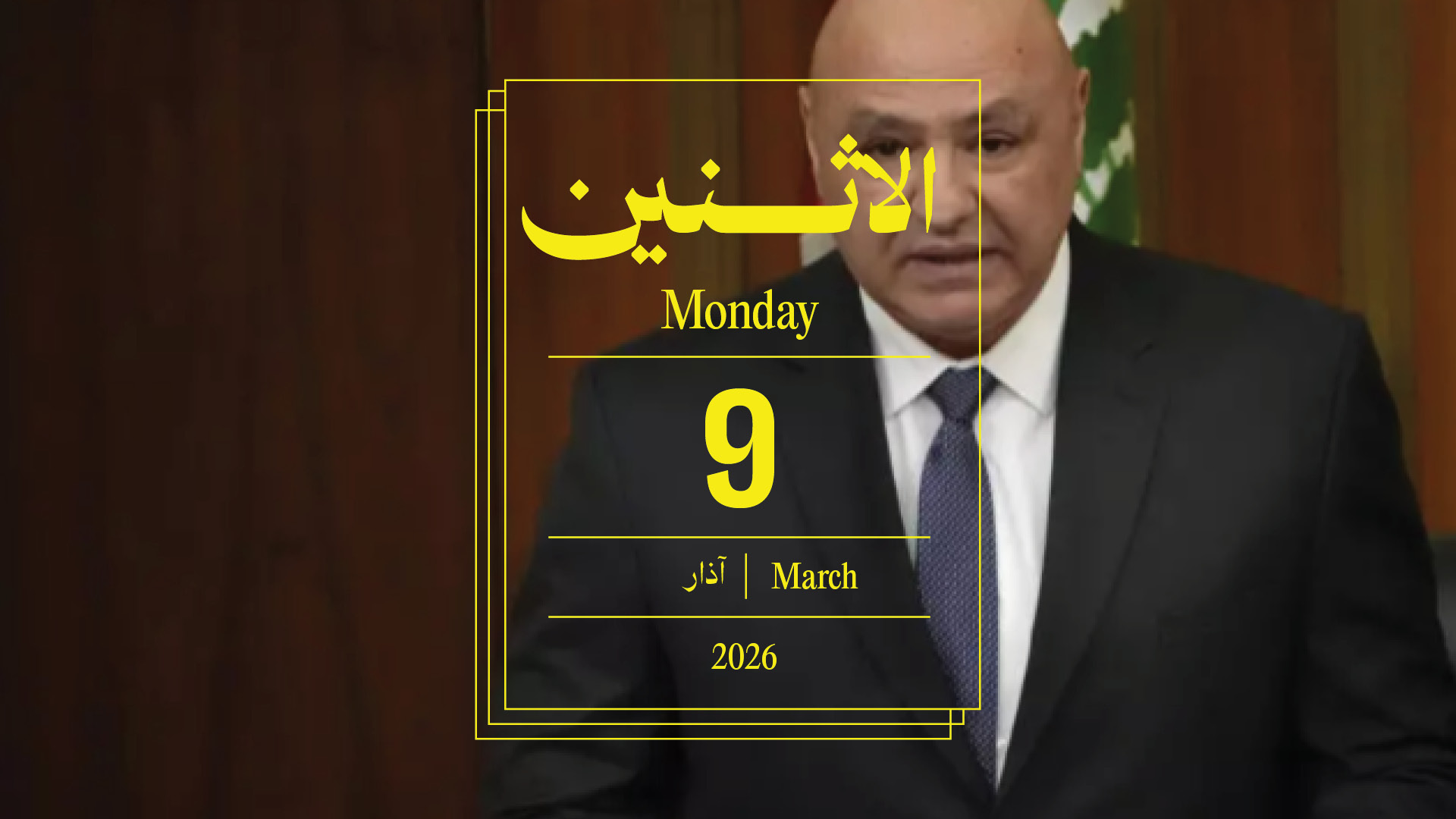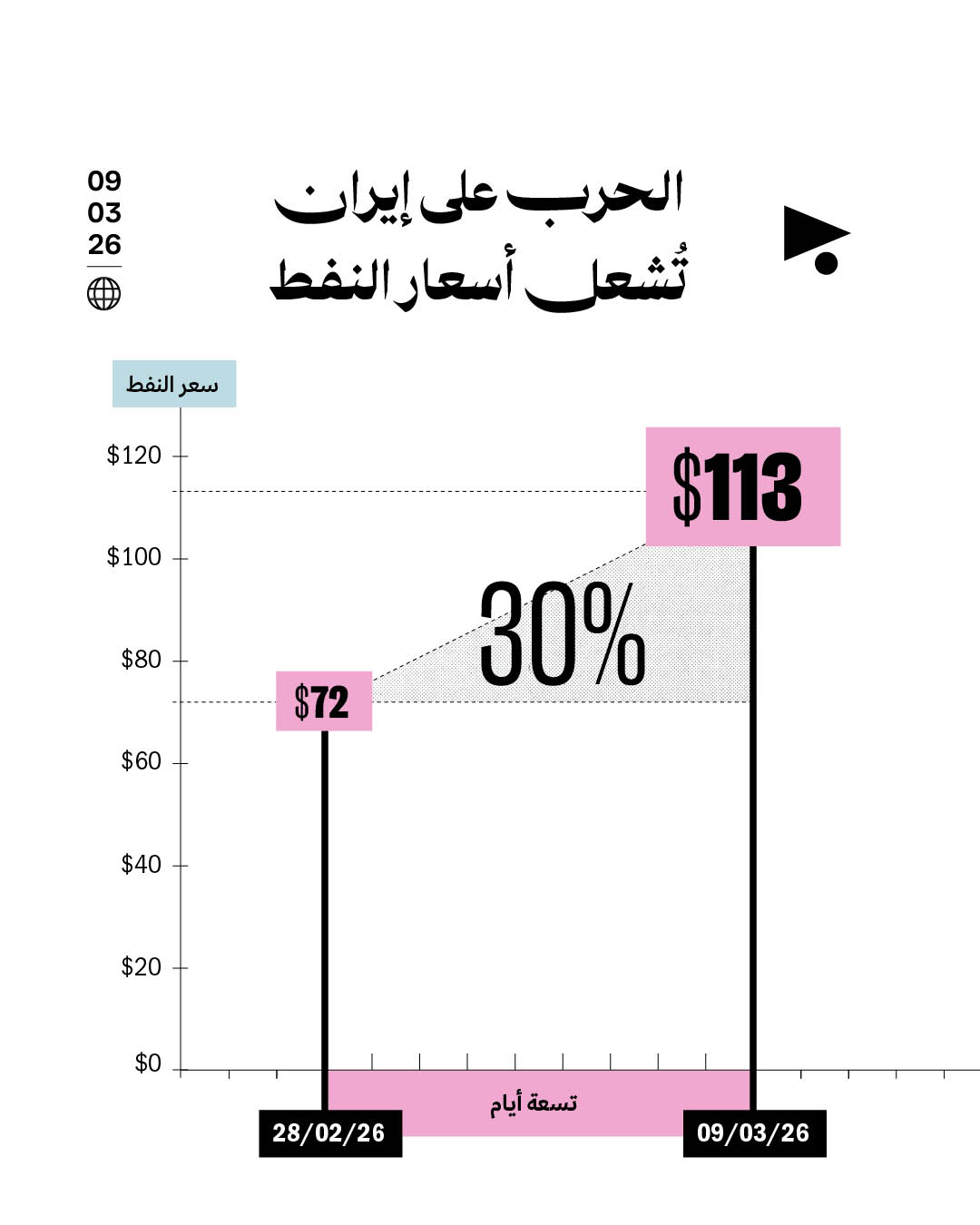الظاهرة
قبل دخولنا عصر الصورة وغرقنا في بحرٍ من صنّاع المحتوى والمؤثِّرين (إنفلونسرز)، وقبل أن يرتبط مفهوم القيمة بعدد المتابعين والشيرز، وقبل الترند والفيرال… قبل كلّ ذلك بعقود، انشغل الإعلام بـ«ظاهرة زياد الرحباني». صحف ورقيّة، مجلّات، إذاعات، ومن بعدها التلفزيونات في تسعينيات إعادة الإعمار، تناولت الظاهرة، حللتها، وساهمت بتغذيتها وإعادة إنتاجها على مرّ السنوات:
المتمرّد، الساخر، الهمشري، كاسر القوالب، فنّان الشارع، مجترح لغة شعبية، ناقل الواقع بلا مواربة، العبقري، المشاكس، الثوري، النبيّ، قاتل الأب (والعمّ)، ناسف لبنان الرحابنة، المسؤول عن إعادة الأمّ من سفيرتنا إلى النجوم إلى أرض الواقع (المسؤول الأوّل عن إغلاق السفارة)، نازع الهالة القدسية عن فيروز ومحطّم الأيقونة بعدما جعلها تغني الخَسّ والمكنسة والدخّان اللايت.
فهل كان الرحباني الإنفلونسر الأوّل؟ إنفلونسر زمن الترانزستور في الملاجئ وصور المجلّات الفنيّة الملوّنة والمسجلّات المزدوجة الناسخة لشرائط الكاسيت؟
ترك «لوك» الرحباني في شبابه (شعره القصير، الذقن، الحذاء الرياضي، شنطة الكتف، الجاكيت/الجيليه) أثره على أكثر من جيل من الشبّان الذي حفظوا تفاصيل تلك الصور وحاولوا التشبّه بها. هل تذكرون مثلاً صورته إلى جانب سامي حوّاط على غلاف شريط أنا مش كافر؟ لكن، هل كانت ظاهرة الرحباني مجرّد نجوميّة فنيّة، ومحاولات التماهي مع صورته مجرّد علاقة معجبين بنجمهم؟
الحقيقة أعقد من ذلك، لأسباب كثيرة لعلّ أهمّها أنّ الرحباني خارج عن الاقتصاد السياسي الرسمي لصناعة النجوم ووسطهم. فلا صانع نجوم هندسه وسوّقه، ولا هو لبّى رغبات سوق، ولا نظام سياسي تبنّاه ووضعه في الصدارة، ولا موجة ركبها فحقّقت له انتشاراً واسعاً، ولا قضيّة نطق رسميّاً باسمها فطوّبته ممثّلاً لها. فهو، على سبيل المثال، لم يتخلَّ يوماً عن التزامه بالقضيّة الفلسطينيّة ولكنها، بخلاف إرث أهله وأعمال مجايليه من المغنّين الملتزمين، غائبة عن أعماله الأساسيّة وعن كلماته. تجدها بعد جهد في قطعة موسيقيّة قديمة تأخر صدورها، «تلّ الزعتر-MEA»، وفي موسيقى تصويرية، وفي تفاصيل عمله في التوزيع الموسيقي لأعمال المغنين الملتزمين من سبعينيات القرن الماضي كـ«أحمد الزعتر» لخالد الهبر وبعض أعمال فرقة الأرض. أمّا اليسار الشيوعي الذي انتمى إليه وانتقده، فكانت أعمال زياد الرحباني ربما أهمّ عطاء ثقافي منح له في الخمسين سنة الأخيرة، من أناشيد السبعينيات ومهرجانات الحزب الشيوعي إلى صوت الشعب لاحقاً، التي من الصعب تصوّرها من دون موسيقى الرحباني وصوته.
وعد الصوت
قبل أن يكون صورة، زياد الرحباني ظاهرة صوتية.
ركن أعماله المسرحية والإذاعية والغنائيّة هو الصوت- نبرة، لهجة، لكنة، لدغة، بحّة، رنّة، تأتأة، تنّهد، خامة، مخارج حروف، إيقاع، مدّ وبتر. بالإضافة إلى بصمة صوته الخاصّة، لا يمكننا تخيّل أعماله من دون حملة أصواتها التي وزعّها على كثيرين حفرت بصماتهم الصوتيّة عميقاً، لدرجة يستحيل معها فصل نصّ المسرح والأغنية عن مؤديه.
جان شمعون، كارمن لبس، زياد أبو عبسي، بطرس فرح، جوزف صقر، مونيكا أبو عسلي، سلمى مصفي بيار جامجيان، نبيلة زيتوني، غازاروس الطونيان، ستيفاني ستيفانو، سامي حوّاط، توفيق فرّوخ، ختام اللحام، مادونا، وغيرهم كثر.
الصوت الذي لا يصدر عن آلات موسيقيّة تقليدية أساسي أيضاً في أعمال الرحباني الغنائيّة: تصفيق، تهييص، كلام جانبي، شوك وسكاكين، أبواب، تكسير، خطب سياسية، أصوات العاملين في الاستوديو، خلفية إيقاعية تصدرها أصوات حيوانات (ما شاورت حالي)، إيقاعات مركّبة من زخّات رصاص مختلفة (عودك رنّان)…
فلا أظن أن هناك من عمل في الثقافة العربية المعاصرة على صياغة كلّ هذا الكمّ الهائل من المعاني والمشاعر من خلال نحت الأصوات وتركيبها كما فعل زياد الرحباني منذ بداياته. يكفي مقارنة الإلقاء في حوارات «نزل السرور» بمسلسل «عشر عبيد صغار» التلفزيوني الذي عرض في نفس السنة (1974) لتبيان الفرق ما بين أصوات تصلنا حاملة علامة الزمن، وأخرى تبدو أكثر نضارة ومباشرة. نحتُ الأصوات الدقيق والمركّز الذي عمل عليه الرحباني طويلاً هو طبعاً جزء من مزاج شخصي وحساسيّة عالية لالتقاط المعاني الكامنة في المعاش اليومي. لطالما تخيّلت الرحباني على أنّه إنسان وصل إلى هذه الأرض مع مسجّلة عالية الجودة مزروعة في داخله. مسجّلة تلتقط المعاني الكامنة في ما لا يقال، وما يلمَّح إليه من دون قوله مباشرة وفي كيفيّة صياغة ماذا يقال ولمن وأين يتمّ ذلك.
سحر الأصوات الرحبانية ومباشرتها زوّدتها بقوّة لا يستهان بها، نجحت في استيقاف المستمعين وفي جعل تعليقات إذاعيّة ظرفيّة سُجِّلت قبل نصف قرن (بعدنا طيبين قول الله)، أو قبل أربعة عقود (العقل زينة وشي تابع لشي تابع شي)، تُنسَخ على شرائط ويعاد سماعها بعد سنوات على إنتاجها. فالصوت عنده، إلى جانب الكلام المكتوب، أساسي في تخليد ما كان يجب أن يكون ابن يومه، زائلاً كمقال جريدة يوميّة.
كما أن تحميل الأصوات كلّ تلك المعاني والمشاعر هو ما جعل ترجمة أعماله عمليّة شبه مستحيلة. النصّ المكتوب عنده لا يعيش إلّا بأداء الصوت. هذا ما جعل قراءة كتاباته، خاصّة تلك التي نشرها في الصحف، أشبه بعمل شاقّ، قليل المتعة وحتّى غير مفهوم أحيانًا؛ بالنسبة لي على الأقلّ، كان الأمر كذلك. كتاباته الكثيرة التي لم يُحيِها صوت في الإذاعة أو على خشبة المسرح بقيت نائمة في أدراج أرشيف الصحف. لم تدخل ضمن حيّز «الظاهرة». قليلاً ما تناقلتها الأيدي ونسختها كما تداولات شرائط البرامج الإذاعيّة والمسرحيات والموسيقى. فالظاهرة أصلها الصوت ومباشرته. ذلك الذي لا تظهر له تجاعيد مع الوقت، ولا يتغيّر شكله مع الموضة الموسمية، ولا يحمل أي مؤشّر حسّي آخر على مرور الزمن. قد يكون عدم تسجيل المسرحيّات بالصوت والصورة، الأمر الذي لطالما نظر إليه بحسرة على أنّه خسارة من الزاوية التوثيقيّة، نعمة مستترة ساهمت بانتشار الأعمال وأدامت سحر الصوت المجرّد والمباشر.
الصوت المحمّل بكثافة دلاليّة شديدة الخصوصيّة والمحليّة، يحمل معه أيضاً سياسته في أعمال الرحباني. سياسة ترتكز إلى تحديد العلاقة باقتصاد التداول و«بالعالميّة». لا تحديد مسبقاً في أعمال الرحباني «الشعبيّة» لشكل العمل بناءً على مرتكزات تحدّدها السوق مسبقاً، كالرسوم المتحرّكة اليابانية التي شكلّت وعي جيلين بعدما دبلجت إلى الفصحى لتسهيل بيعها في سائر البلدان العربيّة، أو كالمغنّين الذي يتخلّون عن لهجاتهم طلباً لانتشار أوسع في أسواق مصر أو الخليج. كذلك، لا تحديد مسبقاً لشكل العمل بالارتكاز إلى علاقات سلطة بنيويّة تحدّد التداول، كمن يكتب في العربيّة وعينه على المترجم إلى الإنجليزية ليكرَّس «عالمياً». وهذا ما قد يفسّر حملته التخوينيّة الفظّة قبل سنوات على تجارب موسيقية عربيّة (ربيع أبو خليل، أنور براهام) تبلورت في الغرب ونجحت فيه، من باب الارتماء في حضن الاستعمار ونشر الاستشراق من خلال تسليع الموسيقى الشرقية كما يريدها الغرب.
نبيّ شعبيّ
من الصعب فصل الصوت، «المعبِّر العفويّ عن وجع الناس»، أيضاً عن إعلان «نبوّة» الرحباني الذي طوّبته الظاهرة مستشرفاً للمستقبل، سابقاً لزمانه، شايف كلّ شي من الأوّل. لكن إن دقّقنا قليلاً، بعيداً عن أدبيّات إنتاج الظاهرة، ننتبه إلى أن أعمال الرحباني المسرحية لم تكن متقدّمة على زمنها، بل كانت أحياناً متأخرة بعض الشيء. فإبراز التناقضات الطبقية ونقد «بالنسبة لبكرا شو» (1978) أتى بعد حرب السنتين واغتيال كمال جنبلاط وتلاشي المشروع التغييري الذي حملته الحركة الوطنية. أمّا نقد القوميّة اللبنانيّة والمسرح الرحباني في «شي فاشل» (1983)، وإن تمّ في بداية عهد أمين الجميّل، فقد جاء في زمن شكّل أيضاً لحظة إعادة اكتشاف للمسألة اللبنانيّة من بعض اليسار وبداية إعادة النظر في تجربة النظام اللبناني قبل الحرب كصيغة سياسية مبتكرة لإدارة التنوّع المجتمعي.
يبقى الأهمّ من كلّ ذلك أنّ ما أنتجه زياد الرحباني كان «متأخراً» لأنه خرج على زمن الرأسماليّة. ليس لأنه كان شيوعيّاً، وليس لأن محتوى بعض أعماله يساري، بل لأنّه نجح بإنتاج أصوات مضادة لمنطق السلعة التي لها تواريخ صلاحيّة معيّنة، وتعبّر عن موضة موسميّة يأفل نجمها بعيد انتشارها. أعماله تسلّلت إلى زوايا قلوب كثيرة، لكنّها، وهنا المفارقة الأبرز، لم تُستهلَك كسلع ولم تتقادم مع مرور الزمن. من الصعب مثلاً التأريخ لأغنية كـ«هيك بتعمل هيك» على أنّها صوت التسعينيات الموسيقي، مقابل «شو عدا ما بدا» على أنّها تعبّر عن أغنية الثمانينات، أو موسيقى «ميس الريم» على أنّها تمثّل موجة موسيقيّة من السبعينيات عفا عليها الزمن وأعيد اكتشافها. الصوت الذي صاغه الرحباني تحدّى دورات الإنتاج الرأسمالي وزمن السلع الثقافيّة التي يحتفى بها عند صدورها، لتتحوّل بعد سنوات قليلة إلى كيتش يُزدرى، قبل أن يعاد اكتشافها وإدخالها في دورات الإنتاج والتداول مجدّداً من باب النوستالجيا وإعادة الإحياء. فكيف ينتج تراث حديث في زمن الرأسماليّة المتأخرة؟ وكيف أصبحت كلّ تلك الأعمال في داخل كلّ منّا من دون استهلاك؟ وكيف تنتشر وتُتَداول على نطاق واسع عابر للأجيال وللحدود (خاصّة في سوريا وفلسطين) خارج منطق السوق العام وخارج منطق الأسواق الهامشية (الأندرغراوند والبديل)؟
المفارقة المؤسِّسة لنبوّة الرحباني تكمن في أن اللغة الشعبية والعفوية مشغولة بعناية فائقة، والمباشرة بالتعبير منحوتة بدقّة هائلة، كلكنة سلمى مصفي الفرانكو-لبنانية في أغنية «un verre chez nous». إن كانت موهبة الرحباني الأولى هي دقّة الملاحظة والتسجيل الذي يكشف اللاوعي الجمعي للّبنانيين، فموهبته الثانية هي نحت الصوت ومونتاجه، المرادفة لتوزيعه المتعدّد الطبقات دوماً في الموسيقى. نحت يوصل مشاعر ومعاني لا تولد إلّا بواسطة الصوت الذي يفضح اللاوعي الجمعي من خلال إبراز الفرق بين ما يقال وما يراد به، («كلّنا إخوة»، «طول عمرنا إسلام ومسيحيّة عايشين مع بعض»، فيلم أميركي طويل). تلخّص تلك المفارقة المؤسِّسة ما يفصل بين أعماله المتقنة التي توصف بالشعبية وأعمال مقلّديه الكثر التي تُتّهَم بالشعبوية، والتي هي على الأرجح أقرب لصوت الشارع «الحقيقي».
ذهب شخص زياد الرحباني نفسه «ضحيّة» الصياغة الفذّة للصوت الشعبي المباشر الذي صنع هالته ونبوّته. فزادت عزلته مع بداية تطويبه «روح الشعب» تجنّباً لمحاصرته من الناس الذين يريدون إيقاف «أبو الزوز» في الشارع لسؤاله «شو كيف شايفلنا الوضع؟»، قبل استبدال السؤال بالسيلفي.
مواقع شبه مستحيلة
قد يكون الرحباني منصت الجمهوريّة الأوّل، مما جعله أبرز محلل نفسي لعصاب الطوائف اللبنانيّة ورغباتها التي تتجلّى شفهياً وتستتر أكثر كتابةً؛ تماماً كالفرق بين الذعر الملموس في صوت إدوار المصاب برهاب المحمودات والحجج العقلانية والدعوات النظريّة عن ضرورة إنشاء دولة فيدراليّة. في إعادة إنتاجه ونحته لتلك الأصوات، لا ينقل زياد الرحباني الواقع كما هو، بل يعيد تركيبه لإبراز آليّات عمل السلطات الطبقية ونقد تلك التي تشكّل الأفراد كممثلين عن جماعاتهم الطائفية وهواجسها. السلطة في عالمه في قلب الفرد، وداخل نسيج المجتمع نفسه، بقدر ما هي مجسّدة بطبقات تستغلّ أخرى. الشعب عنده يتأرجح دوماً ما بين المسكين والعنيد، ما بين اندفاعة الثورة وضرورة قمع العسكر له، ما بين التمرّد والنظام، ما بين السياسة من تحت والسياسة من فوق.
مَن يضحك مع الرحباني، يضحك أحياناً كثيرة لأنه يتعرّف في شخصّياته على جزء أساسي من تكوينه الشخصي الذي يكبته أو ينكره، قبل أن يفضحه صوت المؤدّي. كما يتبلور الالتزام السياسي عنده من خلال فضح آليات عمل السلطة الطبقية في المعاش اليومي المشترك. بدل أن يغنّي للطلقة في صدر الفاشستي (خالد الهبر)، التي تتبنّى ثنائية العدو/ الصديق السياسيّة، يغنّي لزمان الطائفية التي هي «فيّي وفيك»، ويفكّك آليّات الاستغلال الرأسماليّة العابرة لاصطفافات الجماعات الطائفيّة اللبنانيّة. اليساري الشيوعي زياد الرحباني لم يخاطب في أعماله اليساريين فقط، بل خاطب الجميع، وهذا ما يفسّر قوّة حضوره خارج عصبيّات اليسار الضيّقة وقدرة أعماله على استقطاب من لا ينتمي لمعسكره.
نجح من خلال ذلك في احتلال موقع شبه مستحيل: فهو أصرّ في آن واحد على مخاطبة اللبنانييّن جميعاً في خضمّ أكثر أيّام انقساماتهم دمويّةً، وفعل ذلك مِن موقع ملتزم ومنحاز لطرف من المتقاتلين. أمّا أحد شروط إمكانيّة ذلك، فكان انتماؤه إلى اليسار؛ أي أنّه واجه مشروع القوميّة اللبنانيّة بمشروع إيديولوجي مغاير، لكنه يعمل مثلها على نطاق وطني. هذا ما أصبح متعذّرآً لاحقاً مع اصطفاف زياد الرحباني في معسكر الممانعة بقيادة حزب الله الذي خرج عقائدياً وعسكرياً من حدود لبنان، وبنى مشروعه على عقيدة دينيّة مذهبية حركيّة، شديدة الاختلاف عن «الطائفيّة- العلمانيّة» اللبنانيّة؛ عقيدة لا قدرة لها على إنشاء مشروع يلمّ شمل هذه الجمهوريّة، ولا رغبة لها بذلك أصلاً.
أمّا إحدى أهّم نقاط قوّة أعماله، فكانت القدرة على المزاوجة الصعبة أيضاً بين التكثيف والمباشرة. فبجملة بسيطة- «شوف الليرة ما أحلاها، بتقطع من هون لهونيك»- استطاع أن يكثّف النقد اليساري عن القطيعة بين البنية التحتية الاقتصاديّة اللبنانيّة الموحّدة والبنية الفوقيّة السياسيّة المنقسمة طائفيّاً. بقيت الليرة مجرّدة من أي روابط، لا هويّة لها ولا انقسامات طائفية تصيبها، وبقي المواطن المجرّد من انتماءاته الطائفية مجرّد أمنية قد تتحقّق بتنييم «أحمد مع باتريك».
خطّ ساخن عابر للأجيال
كلّ ذلك جعل أعمال الرحباني التفكيكيّة بمثابة خطّ ساخن عابر للأجيال. أنقذ كثيرين من الخوف من الآخر ومن العزلة ومن خنقة الطوائف وشعاراتها التي تشكّل ذوات اللبنانيين وعصبيّاتهم. ما أن يضع مراهق في الثمانينيات والتسعينيات، وربما في السنوات التي تلتها أيضاً، شريط كاسيت في مسجّلة ويتمدّد على تخته حتّى تبدأ جلسة علاج تنقله من خلالها الأصوات إلى عالم آخر خيالي، على خلاف كلّ من يدّعي أن مسرح الرحباني واقعي. عالم يتّسع لشخصيّات لم يلتقِ بها من قبل، من طوائف لا يعرف أيّاً من ممثّليها، ومن مناطق لم يزرها من قبل. وهنا أحد مكامن القوّة العلاجيّة لأعمال الرحباني التي لا تمتّ لواقع المراهق بأي صلة، ليس لأنّ أحداثها تتمحور خارج أيّ حيّز حميم (منزل، عمارة، حيّ، ضيعة) وتتمركز في أماكن عامّة وعابرة لا تنبت جذور فيها (الوطن: النزل، السناك بار، المصحّ، المسرح الفاشل)، بل لأنها تصرّ على وحدة الجمهوريّة اللبنانيّة من خلال تبيان انقساماتها البنيوية الطبقية والطائفية. وبذلك تصبح عمليّة الاستماع وإعادة الاستماع إلى أصوات الرحباني بمثابة خطّ ساخن يكسر العزلة ويرمي بحبل نجاة للتسلّق فوق أسوار الجماعات من خلال عمليّة سخرية تفكيكية تُفقد الشعارات المسلّحة للإخوة- الأعداء بداهتها.
وعد الصوت: عالم آخر ممكن
ليس من المبالغة بشيء القول إنّ أعمال الرحباني المتنوّعة شكلّت أبرز ماكينة أيديولوجيّة لليسار اللبناني من حيث قدرتها على إحداث خرق صغير في قلاع الجماعات الطائفية، نفذ منها أفراد إلى اليسار وإلى ما سيسمّى لاحقاً المجتمع المدني. إن كان مسرح الرحابنة قد تخيّل لبنانَ غيرَ واقعيّ في فترة وجود الجمهورية اللبنانية كمساحة مشتركة من بعلبك إلى البيكاديلي، فإنّ مسرح زياد الرحباني قد تخيّل لبنان واقعيّاً لكنه غير موجود في مرحلة انقسام كلّ شيء ما عدا الليرة اللبنانية. فجوقة الأصوات هذه ولهجاتها المتعدّدة لم يكن لها وجود لها في واقع التطهير الطائفي للجغرافيا الناتج عن الحروب اللبنانية، باستثناء ربما في بيروت اللقاء، وهي الكلم المربّع الذي شكّلته راس بيروت التي لجأ زياد الرحباني إليها في شهور الحرب الأولى. عاش، وعزف وسجّل وعرض فيها وشهد عبر العقود انتقال لاجئين جدد إليها، تتحمّل أعماله مسؤولية ما عنه. كما لا بدّ أنه راقب أفول بريقها في سنوات عزلته الأخيرة، قبل خروج نعشه منها بعد نصف قرن على لجوئه إليها محمولاً على إيقاع تصفيق حارّ من محبّيه الكثر.
أبو الزلف وأبو الزوز
غلبت الماكينة اللبنانية سخرية الرحباني النقدية التي شكلت خطاً ساخناً للكثيرين منّا، فاستطاعت هضمها وتطويعها. من السهل الآن تصوّر كيف بإمكان الجماعات أن تستعيد مفرداتها التي أعاد الرحباني صياغتها إلى الحظيرة دون شحنتها النقديّة الساخرة (المحمودات، مثالاً). لكنّ المثال الأبرز لذلك يبقى تحوّل السخرية الرحبانية النقدّية إلى فولكلور وطني جامع لجمهوريّة دائمة الانقسام، بعدما أصبحت عبارات رحبانية قصيرة جزءاً من لغة الناس، وصار أسلوبُه علامة على طريقة التنكيت اللبنانية. وهنا أيضاً ذهب زياد الرحباني الشخص والموسيقي ضحيّة «ظاهرة زياد الرحباني» التي هي من صنع يديه ولسانه، مع بدء تطويبه على أنّه «روح الشعب» وهو لمّا يزل في بداية عشرينياته. فأن تصبح كلماتك جزءاً حيّاً لا يتجزّأ من كلام الناس اليومي، فهذا في آن واحد أهمّ تكريس بإمكانك الحصول عليه ولعنة عظيمة. فما الذي ستفعله بسنيّك القادمة؟ هل تكرّر نفسك؟ هل تبقى المعجزة معجزةً إن تكرّرت؟
ما لا ينتبه إليه كثيرون عند تناول مسيرة الرحباني هو أنه لم يهتّم فقط بإنشاء مشروع مضاد لأهله (قتل الأب)، بل كان يتحرّك أحياناً باتّجاه «قتل ما يغذّي ظاهرة زياد الرحباني» بالتوازي مع القطيعة الإيديولوجيّة مع أّهله والبناء الموسيقيّ على ما شيّدوه. فنقد لبنان الرحابنة في «شي فاشل» تزامن مع كتابته لأوّل عمل مسرحيّ بلا أي أغنية بخلاف المسرحيّات الثلاثة الأولى، لمحاولة الالتفاف على جماهيرية الأغنية في مسرحياته الثلاثة وإعطاء المسرح حقّه خارج صيغة يمكن اختزالها بتكرار سكتش + أغنية. لكن «شي فاشل»، وإن قطعت مع الأغنية في المسرح، شكّلت استمراراً للمسرح المرتكز على الصوت وعلى السخرية الرحبانية المعتادة من الجماعات الطائفية والقوميّة اللبنانيّة. أتت القطيعة مع كلّ ذلك في مسرحيّتَيْ ما بعد الحرب– «بخصوص الكرامة والشعب العنيد» و«لولا فسحة الأمل»– اللتين اعتمدتا أكثر على الأبعاد الثلاثيّة للمسرح والحركة والصورة، وأضافتا تنويعات على الشخصيّات الطبقية/ الطائفية المألوفة. كذلك بعض كتاباته بعد انتهاء الحرب في «السفير»، ولاحقاً في «الأخبار»، تتّجه في نفس منحى التكثيف بلا مباشرة، وكأنه أراد تحدّي تحنيطه مجدداً في أصواته التي لم يتوقّف تردادها منذ السبعينيات.
حالَ تكثيف المعاني وتعدّد وسائطها اللذين طغيا على غواية الصوت المباشر في المسرحيتين الأخيرتين إلى صعوبة استيعابهما عبر السمع. فكانت النتيجة عدم انتشارهما وعدم انضمامها إلى فلكلور ظاهرة زياد الرحباني المبنية أساساً على السمع، لا على المشاهدة ولا على القراءة. وأظنّ أنّه لم يكن ممتنّاً لذلك، وأعتقد، ولا سبيل للجزم هنا، أنه تأرجح دائماً بين رغبة عارمة لنيل الاعتراف به والانتشار ورغبة ثانية للابتعاد عن التحنيط الذي ينتج عن التكريس والجماهيرية. كما تأرجح بين الرغبة بالتواصل لكسر عزلته، وقد حققها من خلال الكلام في الإعلام المرئي والمسموع، ورغبة ثانية في الوحدة والابتعاد عن الاجتماعيات.
أمّا ذلك التأرجح، فهو في صلب مفارقات «الشعبي»، التي تبرزها «ظاهرة الرحباني». فكيف لثائر ومتمرّد أن يجسّد «روح الشعب»؟ وكيف لمن كرّس موهبته لبلورة التناقضات الطبقية والانقسامات الطائفية لمجتمع ممزّق، أن يصبح بمثابة صائغ فلكلورنا المحدث؟ ألم تحوّل ظاهرة زياد الرحباني، «زياد»، الإسم الحركي لها، إلى أبو زلف مديني؟ وهذا ما تنبّهَ له هو نفسه مبكراً، وعبّر عنه أحياناً بالرفض من خلال تعبيره عن تعبه من «عايشة وحدها بلاك» و«كيفك أبو الزوز»؟ وأحياناً أخرى بتغذيته من خلال بعض عروضه الإعلامية التي خلطت الحابل بالنابل، والتي كان يطلق فيها بخفّة أحكاماً عن كلّ شيء، من علاقة الرجل بالمرأة إلى السياسة والفن والاجتماع ونقد الشعب العنيد. فتعيد النبوّة تجديد نفسها إثر ذلك، ويستعيد الرحباني مكانته لساعات كمضحك الجمهوريّة الحكيم، وروح الشعب، قبل أن تضمر هالته مع موجات الثورات العربية الأولى واصطفافاته السياسيّة الممانعة. فلا مجال هنا لمقارنة «الحدث السياسي- الإعلامي» الذي شكلّه ظهوره مع الإعلاميّة الراحلة جيزيل خوري في برنامج «حوار العمر» (المؤسسة اللبنانية للإرسال) في منتصف التسعينيات، واستضافته مجدداً في نفس البرنامج نزولاً لطلب الجمهور، ولقاءاته في السنوات الأخيرة مع الإعلامي عماد مرمل (قناة المنار).
إعادة
لم ألتقِ أحداً سمع شريطاً (مسرحياً، إذاعيّاً أو موسيقيّاً) لزياد الرحباني مرّة واحدة، بخلاف الجواب التقليدي عن مشاهدة الأفلام السينمائية: إيه حضرته. لا تسمع أصوات الرحباني لالتقاط محتوى ما، يضعه المرء في جيبه ويضيفه إلى لائحة الأمور التي حصّلها، ثم ينتقل إلى عمل آخر. السمع، بما هو إعادة سمع، لتلك الأعمال، أصبح عنصراً أساسيّاً في تكوين ذوات كثيرين لازمت أصوات الرحباني حياتهم اليوميّة. تسرّبت عوالمه الصوتيّة، الموسيقية والكلامية، إليهم وهم يقودون سيّارتهم، ويسهرون على الشرفات، ويجتمعون بأصدقائهم ويحضّرون أنفسهم للنوم. وفاة الرحباني لفتت الانتباه إلى ما كنّا نعرفه كلّنا دون الإحساس بأي ضرورة لإعلانه. لكنّه يُعلَن الآن من قبل كثيرين ليس فقط تقديراً ووفاءً لمن نحت كلّ تلك الأصوات التي رافقت حيوات كاملة لأجيال متعددة، بل أيضاً للإحساس بحزن لفقدان إمكانية صوت جديد نسمعه، ونعيد سماعه.
عند سؤاله عن سبب توقّفه عن إنتاج مسرحيّات جديدة، كان الرحباني يجيب أنّه لا يريد تكرار ما قاله من قبل. فالطائفية ما زالت هنا، وكلّ ما أراد قوله عنها قد قاله من قبل. فما الفائدة من كتابة نفس المسرحية أكثر من مرّة؟ تكرار الصوت هنا موت ويباس.
حمل عمل الرحباني الموسيقي مفهوماً مضادّاً عن الإعادة، حيث لا استعادة دون مغايرة. إذ مع كلّ استعادة للصوت في موسيقاه، حياة جديدة له. هنا أيضاً ميزة له أظنّ أنّها خاصّة جدّاً، لست على علم بتواجدها في الموسيقى العربية المعاصرة. لم ينقطع الرحباني يوماً عن إعادة توزيع أعماله الموسيقية وأعمال أهله واستعادتها بصيغ مختلفة في التسجيلات والحفلات. مع كلّ استعادة، ترك لنا أثراً صوتيّاً جديداً يشبه أثراً سابقاً ويعلن تمايزه عنه. كاتدرائيّة مهيبة من الأصوات. ثراء هائل. آثار يتبيّن لنا يوماً بعد يوم أنها لم تكن قَطعاً آثاراً على الرمال.