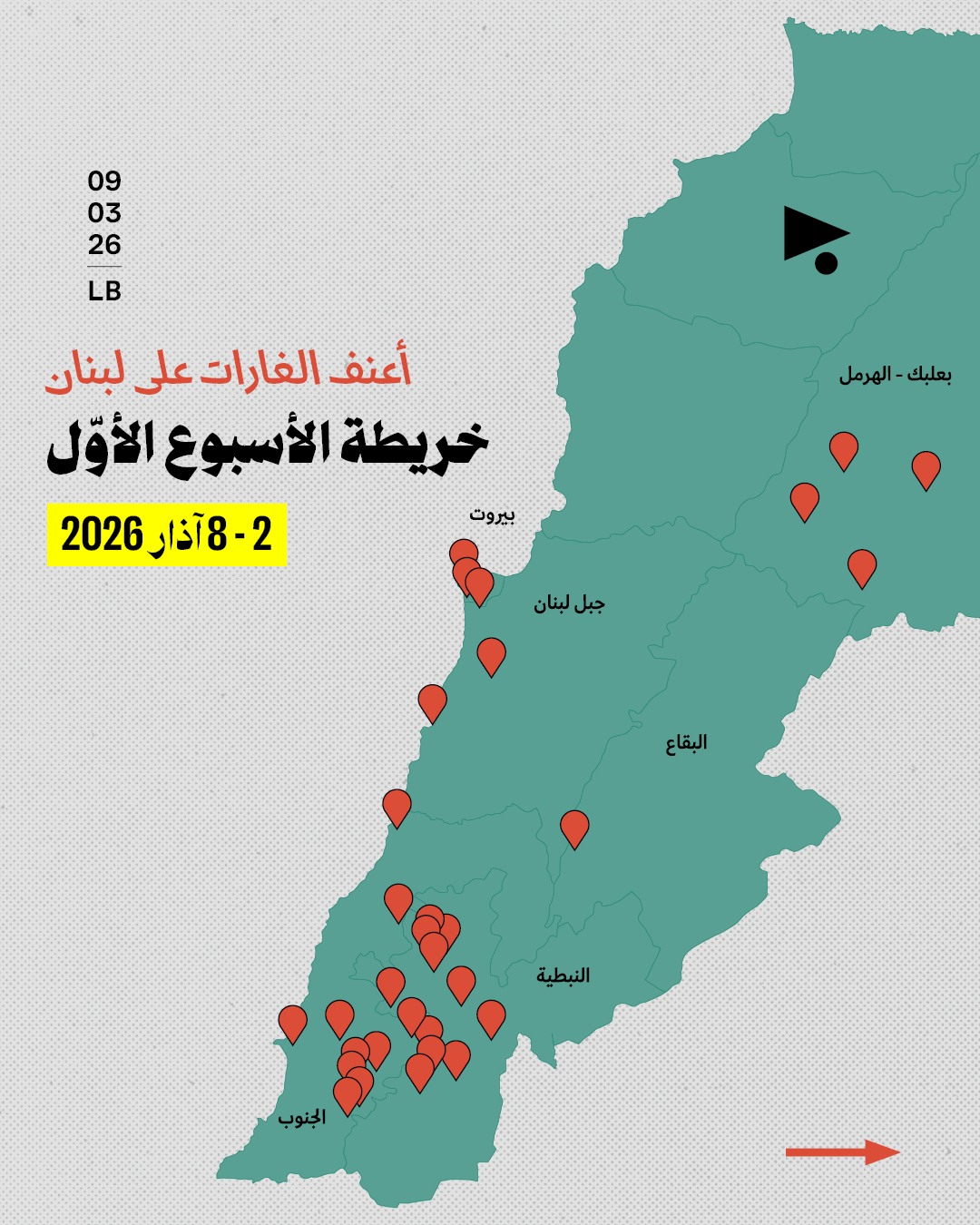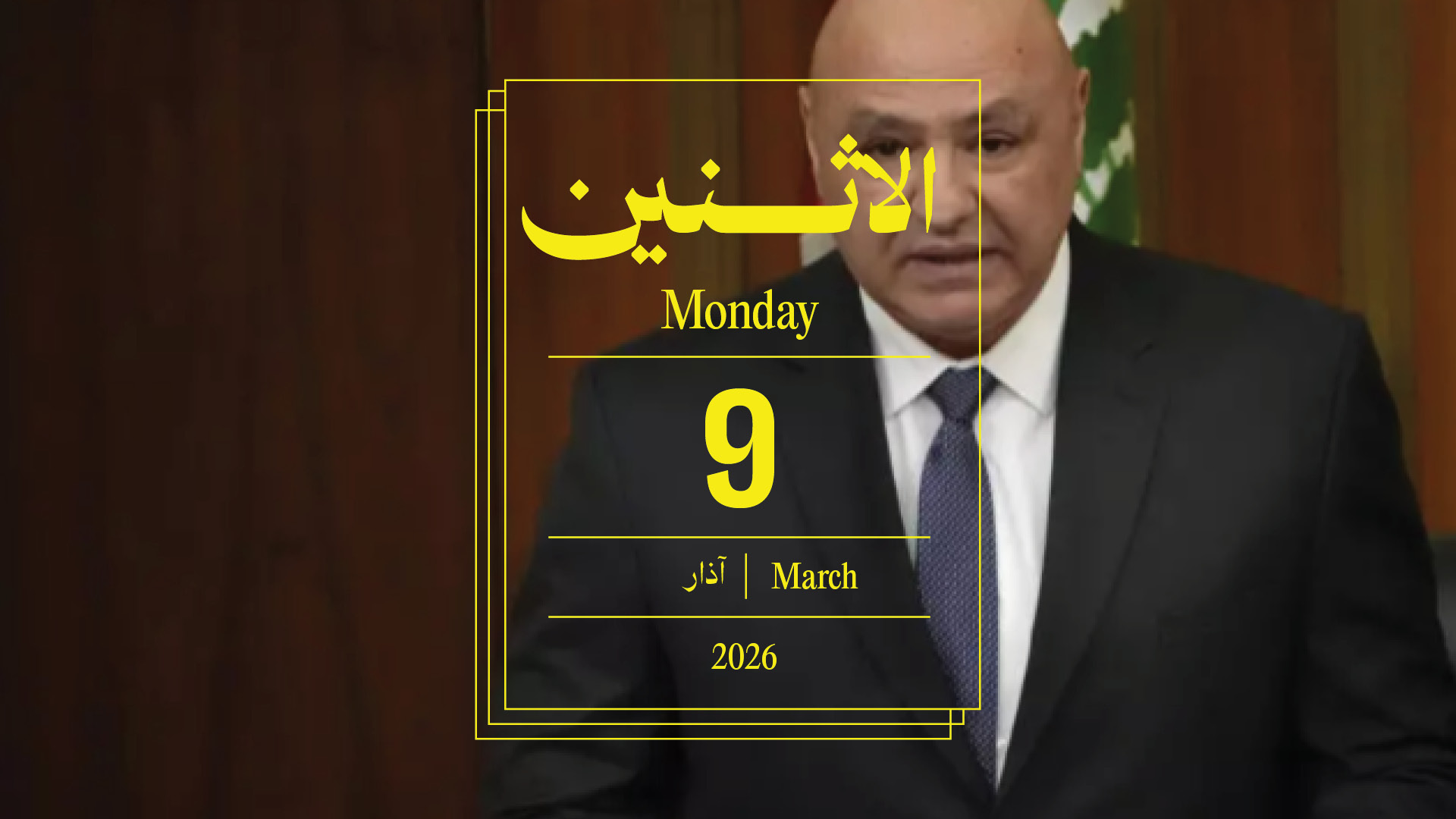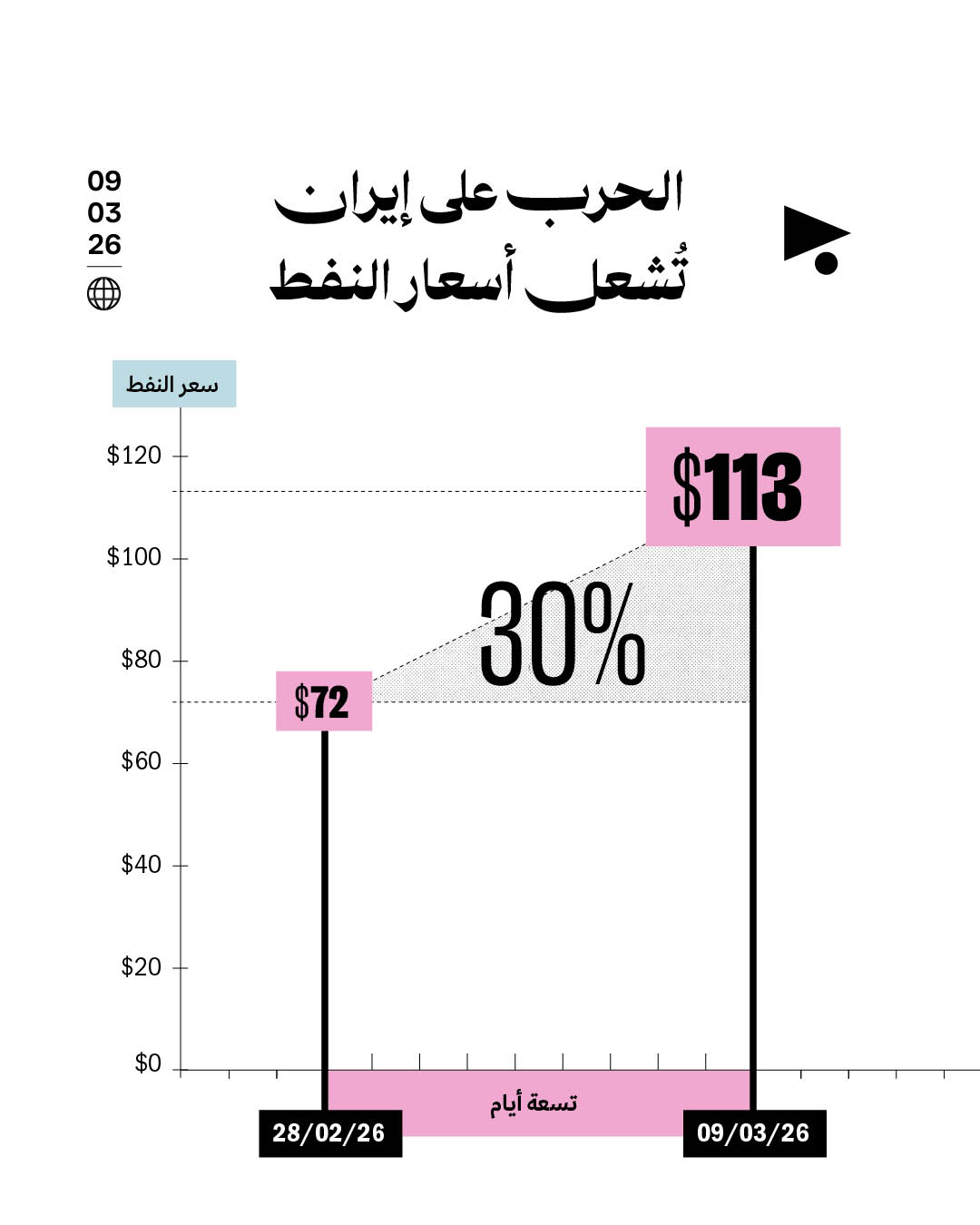صحيح أن الموسيقى لا تعترف بالدول والحدود وجوازات السفر، وهي بطبيعتها عابرة للانقسامات والثقافات والهويات، إلا أنّ النظر والتمعّن في تجربة زياد الرحباني بعيون سوريّة يكاد يكون كالمشي في حقول من الألغام السياسية والهوياتية التي يمكن أن تنفجر في الكاتب من حيث يدري ولا يدري. لا يعود ذلك فقط لغنى وتنوّع هذه التجربة، ولا لطبيعة العلاقات الشائكة والمتداخلة بين البلدين والشعبين، شديدي الاقتراب وشديدي التنافر في الآن نفسه. بل يعود لكون موسيقى الرحابنة وفيروز، ومن ثمّ تجربة زياد، أصبحت في لبنان ولدى الكثير من اللبنانيين، المنقسمين فيما بينهم على كل شيء تقريباً، بمثابة رمز للالتقاء وتوق إلى هوية وطنية جامعة عابرة للطوائف والانقسامات. فكيف ولماذا يريد بعض السوريّين، أو لنقُل الكثير من السوريين، أن ينازعوا اللبنانيين حبّهم للرحابنة وتماهيهم مع تجربتهم.
لا تريد هذه السطور أن تغامر في هذا الاتجاه، ولا أن تُقرأ في هذا السياق، ومع ذلك، ولأجل ذلك، الكتابة هنا محفوفة بالمخاطر، لعلّها تستحق المحاولة!
أوسع من لبنان
تنازع اللبنانيون تراث فيروز والمدرسة الرحابنة، وفقًا لانتماءاتهم السياسية والطائفية. لكن يمكن المجازفة والقول إنّهم حتى في أبشع لحظات الحرب الأهلية اللبنانية، بقوا ملتفّين حول رمزية هذه المدرسة ومحوريّتها في بناء الهوية اللبنانية، رغم اختلافهم على تعريف مضمون هذه الهوية وتشكيل رموزها التأسيسية، من الضيعة الخضراء إلى سويسرا الشرق، ومن «فخر الدين» إلى «جبال الصوان» ومن «موسم العز» الى «بحبك يا لبنان».
يمكننا في هذا السياق تحديدًا، أن نغبط اللبنانيين، لافتقادنا نحن السوريّين في حربنا الأهلية المتجدّدة لمثل هذه الرموز الثقافية والموسيقية التي يمكننا أن نلتقي من حولها ونتعرّف على أنفسنا من خلالها، كما يجتمع أغلب اللبنانيين، سلبًا أو إيجابًا، حول فيروز أو الأخوة الرحابنة، أو كما اجتمع الفلسطينيون، مثلًا، من حول محمود درويش. فلا دريد لحام أو محمد الماغوط، ولا صباح فخري أو الساروت، ولا حتى نزار قباني أو أدونيس، استطاعوا أن يلعبوا مثل هذه الأدوار الرمزية لدى أبناء شعبهم. وبقي نزار قباني، على سبيل المثال لا الحصر، أكثر التصاقًا بالهوية الدمشقية، منه بالهوية السوريّة. الطريف، والإشكالي هنا، أنّ الكثير من السوريّين، بمشاربهم المتعدّدة وأجيالهم المختلفة، يمكن أن يلتقوا بذائقتهم الفنية والجمالية حول فيروز أو زياد، أكثر بكثير من التقائهم حول رموز ثقافية أو موسيقية سورية، من دون أن يعني هذا بالتأكيد، ومرة أخرى، منازعة اللبنانيين سياسياً ووجدانياً حقهم في إشهار «لبنانية» فيروز وزياد.
في لبنان، وخلال الحرب الاهلية اللبنانية، لم يكن من السهل على العديد من الفرقاء اللبنانيين التماهي مع زياد وأعماله الفنية ومسرحياته وآرائه السياسية، وبقي بمثابة الابن الضال المأمول رجوعه. مع ذلك، فإن ظاهرة زياد الرحباني، بموسيقاه وأغنياته ومسرحياته وبرامجه الإذاعية وشغبه السياسي، سرعان ما تجاوزت الحدود بين الطوائف والمذاهب، ولبنان نفسه، ليمتدّ تأثيرها الفني والثقافي إلى المنطقة العربية عمومًا وإلى المشرق خصوصًا. عدا أن تأثيرها السوسيولوجي الملموس بقي مشتبكًا بالاجتماع اللبناني أساسًا، وانتهى إلى فرض نفسه بقوّة عليه.
صحيح أنّ المدرسة الرحبانية في الخمسينات والستينات شكّلت قطيعة راديكالية مع الموسيقى الشرقية السائدة. لكنّ ظاهرة زياد الرحباني تجاوزت تجديد وتثوير النوتة الموسيقية الشرقية على خطى والده وعمّه (وإن فعلته واستمرت فيه)، نحو ثورة ثقافية لأجيال لبنانية شابة في السياسة والفن والأخلاق ونمط العيش وصراع الأجيال ووضعية المرأة والعلاقة بين الجنسين. لقد كان في ثورة زياد الرحباني وجيله من اليسار اللبناني في السبعينات، شيء يشبه إلى حدّ بعيد ثورة 1968 الطلابية في أوروبا، ثورات خسرت سياسيًا، لكنّها ربحت ثقافيًا واجتماعيًا وفنيًا على المدى البعيد. وهذا ما ترك أثره إلى يومنا هذا في طرائق عيش الأجيال الشابة الجديدة وذائقتهم الفنية والثقافية في أغلب المناطق اللبنانية.
الأب والابن

يذهب الكثيرون إلى تفسير موهبة زياد المبكرة وغنى وتنوّع أعماله الإبداعية، بنسبها إلى عبقرية مفترضة ولدت معه وحملها في جيناته خارج أي زمان أو مكان، متناسين الدور الرئيسي للوسط العائلي والمؤثرات الموسيقية والثقافية والسياسية التي أحاطت به واحتكّ بها وتعلّم منها واشتبك معها وتمرّد عليها.
نشأ زياد الرحباني وترعرع منذ نعومة أظفاره في صفوف المدرسة الرحبانية، ووعي على الدنيا وهو يرى والده وعمّه مشغولين في البيت بتأليف مقطوعة ما. يحدّثنا زياد عن أجواء تلك المرحلة في مقابلة أجراها معه الموسيقي الراحل نزار مروة ونُشرت في كتاب بعنوان «في الموسيقى اللبنانية العربية والمسرح الغنائي الرحباني»، ويقول: بدأت أحبّ الموسيقى صغيراً، حيث كان عمري 4 سنوات، حينها- وكما يقول لي الوالد- كنت أعزف أشياء على البيانو، طبعاً بأصبعٍ واحدة.
يستوقفه مروّه ويذكره قائلاً: مثل أي طفل يعني!...
ويجيب زياد ويكمل: نعم! ولكني كنتُ أُعيد دائماً بعض الألحان التي ألّفتها من خيالي... فانتبه الوالد للأمر، وطلب مني إعادة عزفها أمامه ليدوّنها نوطة موسيقية، ولا أزال أحتفظ بنوطات لألحاني تلك بخطِّ يده، وهكذا أحسست بالتشجيع منه بأن أصير موسيقياً مثله.
لا شك أن هذا الاحتضان وهذا الاهتمام من عاصي سيضع الطفل زياد على مشارف الطريق نحو مشواره الفني الطويل، وسرعان ما سيتعلّم زياد العزف على البيانو على يد عازف فرقة الرحابنة بوغوص جلاليان، وسيرافق والده إلى تدريبات وتحضيرات الفرقة الموسيقية والمسرحيات الغنائية، وسيحتّك مع الموسيقيين والممثلين وسيتعرف على جوزيف صقر في دمشق في مهرجان «معرض دمشق الدولي»، وسيُسمَح له أحيانًا أن يحلّ محلّ بعض العازفين المتغيّبين، وصولاً إلى تأليفه لأغنيته الأولى لخالته هدى حداد، «ضلّك حبيني يا لوزية» في العام 1971.
تحضر هنا مقولة مؤرّخنا الأكبر ابن خلدون في أحوال الناس والمجتمعات حين يقول الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم. وزياد على خطى أبيه عاصي، لم يشبه أباه بل شابه عصره. وإن كان في هذا تحديدًا شابه أباه، وكان كحال أبيه، ابن زمانه ومكانه. ابن عاصي وفيروز. ابن المدرسة الرحبانية والمتمرّد عليها. إبن السبعينات واليسار اللبناني. إبن الحرب الأهلية ورأس بيروت.
أصيب عاصي بجلطة دماغية وانكفأ، وزياد لم يبلغ بعد سنّ الرشد. لم يكن سهلاً على الشاب زياد الرحباني أن يشقّ طريقه الفني الخاص ووالده اسمه عاصي الرحباني ووالدته اسمها فيروز. لكنّ الابن ارتقى إلى مستوى التحدي. تمرّد زياد على أبيه بقدر ما أحبّه، وقطع مع تراثه خصوصاً لجهة مضامين وكلمات الأغاني والمسرحيات، بقدر ما تواصل معه لجهة الجملة الموسيقية في خصوصيتها الشرقية وانفتاحها على موسيقى العالم، بوصلته في كل هذا أن يكون الوريث الجدير بالوراثة، لا الابن المدلّل الذي يقتات على ميراث الأهل.
لا شيء يعبّر عن حقيقة جدلية التواصل والانقطاع، القديم والجديد، الشرق والغرب، في أعمال ومسارات وخيارات عاصي وزياد الفنية والحياتية أكثر من الحوار الشهير بين أبو الزلف ومستر نور في مسرحية «شي فاشل»، حيث يوبّخ أبو الزلف مستر نور طالبًا منه أن يضع التراث والفلكلور والميجنا والشروال والدلعونا، جانباً، مذكِّراً إياه انه لا يريد أن يعيش بالضيعة والوادي ولا يريد إلباس الناس شراويل. فحتى فخر الدين والمير بشير باتوا يشترون جينزاتهم وتيشرتاتهم من عنده.
ويتساءل أبو الزلف وين هوي جرن الكبه؟ طلاع شوف كيف الملولينكس عم تفلح بالضيعة فلاحه. ويحتجّ أبو الزلف على كلمات الأغاني السائدة التي لا تعرف إلّا أن تكرّر كلمات من ليالي وعبالي ولحالي ودوالي، ولكنها لا تدخل كلمات من مثل «الملالي» مع أنّ الملالي العسكرية تملأ الشوارع! ويتساءل أبو الزلف شو هالمخلوقه يلي ما بتجي الا بأغنية «ناطرك تحت الشباك عم تسأليني شو باك؟». ويضيف محذرًا وهازئًا انتبه لتكون عم تضهر مع حدا غيرك ولاك؟ ما يكون شدوها المارينز لتروح تعمل لبنان الجديد؟ في أقمار صناعية عن تصور تخلفك من ع بكرا لعشيه. ويختم أبو الزلف هذه الحوارية شاتمًا: باسم التراث اللبناني بحب قول لك صفتك عرضك حريمك، طالبًا من المستر نور الحريص على استعادة التراث، أن يتفضل ويشلح عنه كل شي منو لبناني من ثيابه.
يبقى أنّ التحدي الأكبر الذي واجه زياد في حياته الفنية ونجح فيه على أكمل وجه، كان في أن يكمل مسيرة والده في جانبها الأدق والأكثر حساسية، وهو أن يلحّن لوالدته التي غدت مع الأخوين الرحباني أيقونة فنية مكرّسة. فإذا به هنا تحديداً يرتقي إلى مستوى التحدّي بأجمل صوره لينتزعها من أسر جيل قديم ويقدّمها بكل تألّقها وبهائها إلى الأجيال الشابة الجديدة، بمفردات معاشة من الحياة اليومية وجمل موسيقية رشيقة وروح جامحة إلى التجديد والتجريب. لم يكن لأحد غير زياد أن يتجرأ على المخاطرة واللعب مع ايقونة اسمها فيروز، لكنه فعلها ونجح في ذلك فنياً وإنسانياً. حال زياد مع فيروز بالنسبة لميراث عاصي، لا يقاربه إلا كلام الشاعر طلال حيدر حين يقول: زياد ما كَمّل جملة عاصي، لأنه ما بدو يكون صدى. بلّش بجملته الخاصة، الجملة اللي قلّبت مفاهيم الموسيقى والمسرح والحوار. أما زياد نفسه، فليس هناك أصدق ولا أبسط من الذي قاله للقناة الوطنية التونسية في العام 2019 في هذا السياق: أعتقد أنني أكملت شيئاً، ولو كان أبي على قيد الحياة، فكان سيذهب بهذا الاتجاه.
زياد رحباني هازئاً من سعيد عقل
حوار أبو الزلف ومستر نور في مسرحية «شي فاشل»، سيتكرّر في حياة زياد وفنه مرارًا. لكن لا شيء يمكنه أبدًا أن يعبّر عن مقدار التجديد والتغيير والقطيعة بقدر تهكّمه البديع والقاسي على سعيد عقل وشعره وخطابته. تمّ هذا جوابًا على اختيار سعيد عقل ليلقي كلمة الوداع في تأبين عاصي الرحباني في المنطقة الشرقية لبيروت في العام 1986، في ظلّ غياب زياد الرحباني الذي امتنع عن المشاركة والذهاب لانطلياس التي حرم من زيارتها منذ مغادرتها في العام 1976. من يستمع إلى كلمة سعيد عقل في الكنيسة، في حضرة فيروز ومنصور الرحباني، والتي رفعت عاصي إلى مرتبة الإله، ثمّ يستمع من بعدها لردّ زياد سواء في حلقته الإذاعية على صوت الشعب التي أنجزها تحيةً لذكرى والده بعد أربع سنوات على وفاته في العام 1990، أو في مقابلة زياد مع تلفزيون ال بي سي في العام 1993، سيكتشف على الفور ما معنى أن يذوي القديم ويتكلّس في اللغة المتخشبة والبطولات القومجية الزائفة والعظامية المرضية، ومعنى أن يولد الجديد ويزهر في الحياة كما في الفن والشعر والموسيقى.
يعترض زياد على تبجيل والده ووضعه بمنزلة الآلهة والأنبياء والملوك كأنه نبوخذ نصّر، ويذكّرنا بأنه كان أولاً وأخيراً مجرّد موسيقي، ولكن موسيقي مبدع. وعندما تسأله المذيعة ليليان اندراوس لماذا رفض المشاركة بالتأبين وإلقاء كلمة، يجيبها قائلاً: ماذا يمكن لك أن تحكي بعد سعيد عقل؟ وهل يبقى لديك عقل برأسك بعد سعيد عقل الذي ما أن يتكلم من الفوق ونازل حتى تبدأ الصخور بالنزول على التلفزيون! كيف بدك تحكي بعد واحد عامله إله! الزلمه كان موسيقي حساس بيلعب البيانو وبيألف بيد وحده وباصبعيه الاثنين، وبيلقطها ع الطاير وبيلحن وهو غافي. كيف بدك تحكي عنه بعد واحد قايم القيامه ويا لطيف ومنبر وشكلهم من خلفه مثل ستالين! هذا أبي في النهاية، بس لمّا سمعت سعيد عقل ما عرفت عن مين عم يحكوا.
بين الشعب السوري والنظام السوري
ما لا يعرفه العديد من أبناء الأجيال الشابة في سوريا ولبنان، والتي تذوّقت موسيقى زياد القديمة والجديدة ووعت عليه في خريف عمره الفني والبيولوجي، وتعرفت على مواقفه السياسية الملتبسة تجاه النظام السوري، هو أنّ هذا الفنان اللبناني بدأ مشواره السياسي والفني في قطيعة تامة مع نظام حافظ الأسد وتدخّله العسكري في لبنان في العام 1976 لضرب الحركة الوطنية اللبنانية.
تميّز زياد يومها بجرأة مواقفه السياسية عشية دخول قوات الردع السورية، والتي كان يسجلها مع صديقه جان شمعون عبر أثير إذاعة لبنان من خلال المسلسل الإذاعي «بعدنا طيبين قول الله» بين العامين 75 و76. كان زياد يتهكم أن من سوء حظ لبنان أنّ برجه طلع «برج الأسد»، ولم يتوانَ عن النيل مباشرة وبالاسم من حافظ الأسد وعبد الحليم خدام والشلة كلها، كما قام بتحريض الجنود السوريين ليفكروا قليلاً بجدوى انصياعهم للأوامر العسكرية طالبا منهم الانشقاق والتمرد: يا عسكر سوريا شو خبروكم وشو مخبرينكم تجيتوا وفتّوا؟ بأي حقد عبوكم لبلشتوا الحرب؟ او انتو جيش ما بتسألوا؟… ما حدا منكم رايح ع الجولان وشايف الجولان؟ ما حدا منكم فكر مين رايح تقاتل؟ ما حدا طلع مين في مقابله بالميله الثانية حامل سلاح؟ ما بيّن عليكم شي فلسطيني شي لبناني؟ شو خبروكم وشو فهموكم؟ أو لا خبروكم ولا فهموكم! قالوا لكم جايين تحمونا وتدافعوا عن فلسطين وعن القضية! وقالوا لكم في متآمرين على القضية في لبنان عم ينفذوا مؤامرة إسرائيلية امبريالية؟
ويضيف زياد مخاطباً عسكر سوريا في ذات الحلقة التي بُثَّت في لبنان، لكنها تسرّبت بكاسيتات مسجلة إلى داخل سوريا ذاتها: طيب ويللي عم يموتوا منكم شو هول؟ وليش عم يموتوا؟ عم يموتوا لأنهم مسكرين عليهم كل شي، ولا لهم حق يعرفوا ولا لهم حق يسألوا، بس الهم حق يموتوا! وين العروبة والقومية والحرية والوحدة والاشتراكية... كلهم هدول راحوا بقذيقة على بحمدون؟… طيب ما سألتوا يلي هربوا من بينكم والتحقوا بيلي عم تقاتلوهم، ليش هربوا؟ ليش تمردوا؟… انتو بتعرفوا قديش مكذبين عليكم حكامكم، يا ريت فيكم تعرفوا؟ اذا عارفين الأسد شو بدو، وعبد الحليم خدام شو بدو، والشلة كلها شو بدها من لبنان وبعدكم مكفايين! العمى بعيونكم! والمعركة لح تكفي ومش لح تخلص وهيدا بلدنا وقضية فلسطين قضيتنا وانتو جايين تحتلّوا ويللي بدو يحتل لبنان، اللبنانيين لح يقاتلوه ومالح يرضوا بالاحتلال ولو سقط لبنان كله وبقي لبناني واحد بدو يضهركم من لبنان.
اغتيل كمال جنبلاط ودخل جيش الأسد إلى بيروت وبقية المناطق اللبنانية واحتلت مكاتب كبريات الصحف اللبنانية في شارع الحمرا. أما زياد، فلم ينل أحد منه مباشرة، وربما شفع له في ذلك العلاقات الطيبة التي كانت تربط العائلة الرحبانية بالنظام السوري. لكنّ علاقته بقيت فاترة وحذرة مع النظام السوري خلال كل سنوات التواجد السوري في لبنان.
بعد وراثة بشار الأسد للحكم واغتيال الحريري وخروج الجيش السوري من لبنان، عاد زياد إلى زيارة سوريا من جديد في العام 2008 للمشاركة في احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية إلى جانب والدته السيدة فيروز. وقدّم كذلك بعض الحفلات المنفردة في قلعة دمشق، وأعاد التعارف مع جمهوره الشبابي ورقص معه، وقال عنه وله من على المسرح بصراحه وبصدق مش متوقع هيك شي ولا شايف هيك شي قبل… جايين كنّا لنسمعكم طلعنا عم نسمعلكم.
في تلك الفترة، كان الأسد الابن منتشياً بفك الحصار عن سوريا بعد حرب 2006، وموظّفاً الاحتفالية لكسر عزلته العربية. لكنه كان ماضياً قدماً بفرض قبضته الحديدية على المجتمع وخنق وسجن الأصوات المعارضة، ومنها تلك التي وقّعت بالاشتراك مع المثقفين اللبنانيين إعلان دمشق-بيروت من مثل الراحل ميشيل كيلو. أذكر يومها أننا وقعنا بياناً، وكان عددنا لا يزيد عن العشرين مثقفاً سورياً، ذكّرنا فيه زملاءنا العرب أنه ونحن، إذْ يثلج صدورنا أن تزوروا بلدنا فيلتقي بكم شعبنا المضياف، ويتعرّف على آدابكم وفنونكم وأفكاركم؛ فإننا نناشد المشاركين في أنشطة هذه الاحتفالية أن لا يعودوا من دمشق من دون إيماءة تضامن ملموسة وصريحة وشجاعة مع معتقلي الرأي، محبّي الحرّية والحقّ والجمال من أبناء سوريا الصابرة، أوّلاً؛ ثمّ مع دمشق الشام ذاتها، الأقدم في التاريخ، حيث الطريق إليها مستقيم حقّ لا ينبغي له أن يمرّ بالمعتقلات والسجون وأقبية التعذيب.
يومها لم يصدر عن فيروز أو زياد أي إيماءة بهذا الاتجاه. لكن، وللحقيقة والتاريخ، فإنهما كذلك لم يوجّها أي تحية ولم يؤدّيا أيّ أغنية في مديح الأسد الأب والابن. ويومها كتب الراحل الكبير الياس خوري في ملحق النهار بتاريخ 31 كانون الثاني 2008 مقالته «من أجل دمشق» ذكر فيها أسماء الموقعين واحداً واحداً، وأضاف التقط رفاقنا السوريون جوهر المسألة. الدفاع عن حرية الثقافة والرأي، ليس دفاعا عن المجتمع فقط، بل هو أيضًا دفاع عن المكان المهدّد بالاندثار. لم يطلبوا من المثقفين العرب الذين قرروا المشاركة في التظاهرة سوى ايماءة تضامن مع مثقفي المدينة المعتقلين. وختم الياس مقالته البليغة بالآتي في النهاية، اريد ان استأذن اصدقائي وصديقاتي المثقفين السوريين، واطلب منهم إضافة فقرة صغيرة على ندائهم، تدعو المثقفين العرب الذين سيشاركون في نشاطات العاصمة الثقافية، إلى الذهاب إلى صيدنايا وعدرا، كي يتعلموا من زملائهم السوريين معنى ثقافة الحرية التي تولد اليوم في السجون. هناك، خلف القضبان… هناك تقيم الثقافة العربية احتفال صمودها والتزامها الأخلاقي. حيث يكون المثقفون تكون الثقافة. السجن هو اليوم عاصمة الثقافة العربية.
للأسف لم يلتقط زياد الرحباني هذا الكلام، وأدار ظهره لثورات الربيع العربي بعد العام 2011، وشاخت مواقفه السياسية كما شاخت إبداعاته الفنية، وتورّط في بعض المواقف السياسية الممانعة التي قادته لتقديم المديح المجاني لبشار الأسد وجيشه ومخابراته في ذروة قمعهم لانتفاضة الشعب السوري. وفي 10 نيسان من العام 2013، استضافت قاعة بطحيش في الجامعة الأميركية في بيروت زياد الرحباني، إلى جانب الاقتصادي كمال حمدان، في حوار مفتوح مع الطلاب. وتعرّض يومها زياد الرحباني الى موقف «زيادي» بامتياز حيث خرج من صفوف الجمهور مجموعة من الطلاب السوريين واللبنانيين وانسحبت بصمت من القاعة حاملةً لافتات مستوحاة من أغاني ومسرحيات وعبارات زياد الرحباني، لتدين مواقف زياد من الثورة السورية، لافتات من مثل «عايشة الثورة بلاك وبلا تنظيرك... يا ولد» أو «زياد الرحباني مع الشعب الفقير وقاتله» أو «شي فاشي». يومها التزم زياد الصمت بوقار، ولم يعلّق إلا بعبارة واحدة «شو هذه مسرحيه!»، وهو لو تكلّم لوجد نفسه في موقع سعيد عقل يرمي الصخور من الأعلى. يومها أدرك زياد أنّ روح الفنان المبدع لا تموت بل تحيا في أعماله، وفي أعمال الورثة المشاغبين المستوحاة، تواصلاً أو انقطاعاً، مع أعماله.